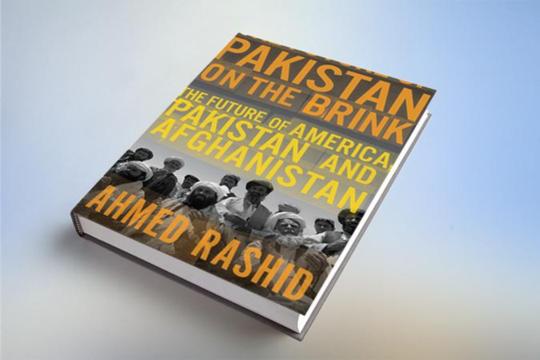
 |
أحمد راشد واحد من الصحفيين الباكستانيين اللامعين المطلعين على الضغوط والتعقيدات المختلفة في تلك المنطقة من العالم "جنوب غرب ووسط آسيا"، ما يؤهله لتوصيفها وتحليلها في ضوء ما يرتبط بالواقع الحقيقي، وليس من خلال أية تصورات انطباعية أو شخصية أخرى.
صعوبات الكتابة عن باكستان
تمثل الكتابة عن باكستان وأفغانستان والمنطقة المحيطة بهما حالة مشمولة بالانطباعي والأيديولوجي، وما هو مسيء للمنطقة ومُنتقص منها عن قصد وسوء نية مسبقين. كما أن الكتابة عنها لن ترضي كافة الأطراف؛ فالكتابة التي تؤيد الغرب سوف تنتقد باكستان وأفغانستان، كما أن الكتابة التي تجامل الأخيرتين سوف تنتقص من الغرب وتوجهاته نحو المنطقة والإسلام والقيم التي يدعو لها. لا يعني ذلك أن نقد الطرفين يحقق الكتابة الشاملة والموضوعية، رغم إمكان ذلك وتحققه من خلال كثير من الحالات.
ويمثل الكتاب الراهن حالة فريدة يقف فيها الكاتب الصحفي أحمد راشد، ابن المنطقة الملم بالدور الغربي فيها، على مسافة واحدة من كافة الأطراف من أجل تقديم صورة وصفية تحليلية لما يحدث في هذه المنطقة الشائكة من العالم. والكتاب حلقة في ثلاثية بدأها راشد بكتابه الأول عن حركة طالبان وأدوارها في المنطقة عام 2000، ثم كتابه الثاني عما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وأثرها على المنطقة عام 2008، وأخيرًا كتابه الحالي عن وضع باكستان الراهن، وما يتوقعه لها من مستقبل.
ولا يمكن الحديث عن باكستان، بدون توضيح العلاقات التي تربطها بجاراتها، وبشكل خاص أفغانستان التي تربطها بها علاقات قبلية وحدودية بالغة التشابك والتعقيد. كما أن الحديث عن باكستان يرتبط أيضًا بتعاظم الدور الأميركي في المنطقة، وبشكل خاص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وتنامي الوجود العسكري في أفغانستان. إن صعوبات الكتابة عن باكستان تبرز من كونها لا تتشكل فقط من الصراعات الداخلية التي تنطوي عليها حدود هذا البلد ولكن أيضًا من ارتباط تلك الصراعات بالقوى المجاورة والوافدة للمنطقة من جهة أخرى.
مأزق الخروج الأميركي من أفغانستان
يكشف الكتاب عن المأزق أو الوضع المعقد الذي تواجهه الولايات المتحدة الآن وهي على وشك الانسحاب من أفغانستان. ولعل هذا الوضع هو السبب الذي جعل اسم أميركا يظهر على غلاف الكتاب بجانب دولتين تنتميان إلى آسيا، وتعانيان كافة أشكال الاضطرابات، ولا يمثلان شيئًا بجانب الدولة الأولى في العالم. فالوجود الأميركي في أفغانستان، وما يحمله من مخاطر هائلة بالنسبة للقوات الأميركية، والأوضاع المتردية في المنطقة، يرتبط أيضًا بالمخاوف الناجمة عن الكيفية التي سوف تنسحب بها هذه القوات، وكيفية البحث عن حكومة أفغانية قادرة على تحمل مسؤولياتها أمام مجتمع بالغ التركيب والتعقيد إثنيًا وقبليًا.
إن الخروج الأميركي، حتى وإن تم بشكل آمن، سوف يترك وضعًا خطيرًا إذا لم يتحقق الاستقرار في المنطقة، وسوف يكون مثالاً آخر، بعد العراق، على ما يتمخض عنه تدخل الدول الكبرى في مناطق التوتر حول العالم من فوضى وصراعات ومجاعات. وفي ضوء ذلك، فقد كشف تقرير خاص بجامعة براون الأميركية حول تكاليف الحرب على الإرهاب أن تلك التكاليف بلغت منذ عام 2001 في الحروب في أفغانستان والعراق وباكستان 225000 قتيل، وما يقارب 8.7 مليون لاجئ، و4 تريليونات دولار.
وهنا بالضبط ما يُظهر الدور المتوقع من باكستان في قدرتها كدولة مؤثرة في المنطقة على إشاعة أجواء الأمن، سواء ضمن حدودها أو ضمن حدود أفغانستان التي تمثل امتدادًا طبيعيًا لها. فالرهان الأميركي القائم على العمل من خلال إستراتيجية تتضمن استخدام القوة العسكرية والتعاون مع الحكومة الأفغانية والدعم الباكستاني والحرب على طالبان لم يؤتِ أكله، وهو أمر يؤكد على أن الولايات المتحدة تحتاج لشيء جديد أبعد من التوجهات العسكرية الرسمية مع حكومات المنطقة، يتمثل في أهمية التركيز على الشعوب والتعقيدات العرقية المرتبطة بها، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعايشها.
إن مشكلة الخروج من أفغانستان التي حددتها الإدارة الأميركية على نحو مبدئي بعام 2104، تكمن في المأزق العام الذي يواجهه العديد من الدول ذات الارتباط بهذه الدولة، مثل: إيران والصين والهند، والأهم من كل هؤلاء باكستان صاحبة الحدود الممتدة والمشتركة مع أفغانستان. وخطورة هذا الانسحاب تكمن على وجه الخصوص في غياب أية تطمينات أو تأكيدات أو يقين حول ما سيعقبه. فحتى الآن لا يبدو في الأفق أي محاولات للتفاهم بين الأطراف المتصارعة، وعلى رأسها الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، والدور الذي سوف تلعبه الحكومة الباكستانية، المتخمة بالحركات المسلحة، في تحقيق هذا الاستقرار. كما أن الخروج الأميركي من أفغانستان مرتبط أيضًا بمشاعر الخيانة التي يشعر الأميركيون أنهم تعرضوا لها، إما من خلال أفغانستان ممثلة في شخص رئيسها حامد كرزاي الذي هرول إلى حركة طالبان من أجل التواصل معها بعد علمه بنية الأميركيين مغادرة أفغانستان، أو من خلال الخوف من باكستان التي وفرت مساحة واسعة من أراضيها لحركة طالبان بعد فرارها من أفغانستان.
وعلى ما يبدو فإن أميركا لم يعد يهمها المنطقة، بل يمكن القول بأنها، بخروجها هذا، سوف تترك للمنطقة إعادة ترتيب أوضاعها بالمنطق المتعارف عليه، ألا وهو العنف و"الإرهاب" وحمامات الدم. فما حدث خلال السنوات الماضية من عمر الوجود الأميركي رغم ما خلّفه من دمار هائل، لم يكن بعد كل هذه السنوات إلا فترة استراحة سوف تعود المنطقة بعدها لمساراتها الدموية المتعارف عليها. وكأن كل الحروب الماضية، وكل الشعارات المرتبطة "بالحرب على الإرهاب" لم تحقق شيئًا، ولم تترك وراءها سوى هذا الخراب والانهيارات والمخدرات والقتلى واللاجئين، وصورة مستقبل أكثر دموية مما سبق.
باكستان بين الجيش وطالبان
تواجه باكستان مشكلات سياسية كثيرة وعميقة تؤثر عليها كما تؤثر على وضع المنطقة من جانب آخر. ويرجع ذلك إلى أن طبيعة تلك المشكلات لا تؤثر على شريحة اجتماعية باكستانية معينة بقدر ما تؤثر على وضعية الدولة الباكستانية ككل وشكل التفاعلات الخاصة بها مع دول الجوار. ويتحدد الإطار السياسي الباكستاني من خلال هيمنة الجيش على الدولة وتوجهاتها العامة؛ فالحكومة الباكستانية تتسم بالضعف بشكل عام، كما أنها تعاني من الفساد المزمن الذي ينتقل من حكومة لأخرى، بدون أية بادرة أمل في أن تقود البلاد حكومة قوية تواجه هذا الفساد بقوة وحسم. وباستثناء حزب الشعب الباكستاني فإن باقي الأحزاب السياسية الأخرى كرتونية ليس لها من الثقل السياسي ما يكفل لها قيادة البلاد. وفي الوقت نفسه فإن الصفوة الباكستانية فشلت في إيجاد هوية وطنية يمكن أن توحد الأمة الباكستانية، في الوقت الذي نجح فيه الجيش، عبر نموذج العداء للهند، في صياغة هوية باكستانية وحّدت الباكستانيين في هدف كلي واحد، يثير المشاعر الوطنية ويضمن تبعيتها له.
ويضمن الجيش الباكستاني نتيجة لذلك 30% من ميزانية الدولة في حوزته، كما يضمن ما يعادل 70% من كافة أنواع المساعدات، إضافة إلى ذلك فإن الجيش لديه إمبراطورية صناعية معفاة من الضرائب وتسهيلات عقارية هائلة، ناهيك عن ممارسته للقوة السياسية وتدخله في السياسات الخارجية للدولة وتحديد الأطر الخاصة بها. يحدث ذلك في الوقت الذي تواجه فيه باكستان مشكلات اقتصادية هائلة حيث تبتلع خدمة الدّيْن ما نسبته 30% أخرى من ميزانية الدولة، بما يجعلها تقترب من حالة "الدولة الفاشلة"، مع الوضع في الاعتبار خطورة التقديرات الأخرى حيث تصل نسبة الأمية إلى ما يقارب 52%، ونسبة البطالة إلى 50%، في ظل وجود مساحة كبيرة من أراضي الدولة تقع تحت سيطرة طالبان.
ولا يقف دور الجيش فقط على القرارات السيادية المتعلقة بالداخل أو بالخارج، لكنه يرتبط أيضًا بقدرته على فرض سيادته على القوى المتنفذة في باكستان مثل القبائل "والجهاديين"، بشكل يساعد على استتباب الاستقرار في ضوء المصالح التي يراها قادة هذا الجيش. ويستخدم الجيش "الجهاديين" في كشمير من أجل توجيه ضربات مؤلمة للجيش الهندي، كما أنه يستفيد من التواصل مع طالبان أفغانستان. ولكن ضمان السيطرة التامة على هذه الجماعات أمر غير مضمون على طول الخط، ويظهر ذلك من خلال وجود ما يقرب من 40000 طالباني باكستاني يشكّلون تهديدًا للأمن الباكستاني الآن، ويمكن أن يلعبوا دورًا كبيرًا في تهديد الدولة وإسقاطها في العقود القادمة.
وتلعب باكستان دورًا كبيرًا في أفغانستان من ناحية تأييدها للبشتون الأكبر عددًا على حساب الطاجيك والأوزبك الذين يتلقون المساعدات من قبل الهند. من هنا تتحول أفغانستان لساحة صراع جديدة بين باكستان والهند، وفي هذا السياق فإن الإستراتيجية الباكستانية تعتمد سياسات موجهة نحو أفغانستان تضعها على المسافة الفاصلة بين الضعف والقوة؛ فمن ناحية لا تريد باكستان أن تتحول أفغانستان لدولة ضعيفة تصبح مغنمًا للقوى غير المرغوب فيها، ومن ناحية أخرى فإنها لا تريدها دولة قوية تمثل مشكلة بالنسبة لها من ناحية مطالبتها بالسيادة على مناطق البشتون الحدودية فيما بينهما.
وتمثل طالبان باكستان الآن قوة ضاغطة على الحكومة الباكستانية بسبب اتساعها وتنامي قدراتها العسكرية، وهو أمر يضع باكستان كدولة على حافة الهاوية كما يشير عنوان الكتاب؛ فطالبان باكستان تتسع وتمتد ليس فقط في الأجزاء الشمالية الغربية، لكن أيضًا في عموم باكستان؛ حيث ينضم لها المزيد من "الحركات الجهادية"، لتشكّل في النهاية وحدة بالغة العنف والتطرف في المجتمع الباكستاني والمنطقة، بما يعوق أية إمكانية لتحقيق نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي حقيقي.
وتنبع خطورة حركة طالبان من تقطيعها لأواصر الدولة الباكستانية بين سيطرتها على بعض المدن في الشمال الغربي مثل وادي سوات ودير وشانغلا وبانر حيث تبعد هذه المناطق مسافة تتراوح بين الستين والمائة ميل عن العاصمة إسلام أباد، إضافة لحضورها في مناطق الجنوب. وهو أمر يؤكد على تزايد تأثيرها وبسطها المزيد من النفوذ على عموم الأراضي الباكستانية مستقبلاً، كما يخيف القوى العظمي بسبب ما يحمله من مخاطر سقوط الأسلحة النووية في أيدي أفراد الحركة في أعقاب انهيار الدولة الباكستانية، رغم نفي قيادات الجيش لإمكانية تحقيق ذلك.
ولا يركز الكتاب فقط على الجانب الخاص بطالبان باكستان، بوصفه أحد عناصر وضع الدولة الباكستانية على شفا الانهيار، لكنه يتناول عناصر أخرى تتضافر مع العنصر السابق وتمنحه تأثيرًا أشد على مفاصل الدولة الباكستانية. فهو يتناول الأزمات الاقتصادية الحادة التي تُخضع باكستان لشروط البنك الدولي القاسية ما يزيد العبء على المواطنين الفقراء ويجعلهم في متناول التجنيد الدائم من قبل طالبان؛ الأمر الذي يُصعّب من مواجهة موجات "الإرهاب" المتواصلة في هذه الدولة. يحدث ذلك في ظل انتشار هائل للفساد الذي يمثل بنية هرمية شاملة في المجتمع الباكستاني من قمة جهاز الدولة حتى قاعدتها العريضة.
والمشكلة الرئيسية في باكستان -وكما قال المؤلف- أنه "لعقود طويلة فإن الجيش والأحزاب السياسية قد تجاهلا المهمة الأساسية المنوطة بهما، والتي تتعلق بتقديم حياة أفضل للباكستانيين"؛ فقد انشغل كلاهما بمصالحهما الضيقة وتصوراتهما المتعالية على مصالح الشعب الباكستاني، وهو أمر انتهى بباكستان بما عليه الحال اليوم، بعد عقود طويلة من الانفصال عن الهند عام 1947. ويرتبط بذلك مشكلة أخرى أكثر تعقيدًا تتعلق بعدم وجود رؤية إستراتيجية باكستانية واضحة ومحددة للتعامل مع الأوضاع في المنطقة، فقد كان من المبرر أن تتعامل باكستان بعد عام 2003 مع حركة طالبان، بسبب وجود حكومة مناوئة لها في كابول، وبسبب التدخل الهندي في أفعانستان في ذلك الوقت، أما الآن، فمن غير المبرر استمرار التعامل مع حركة يعاديها العالم الحر.
من هنا فإن غياب الرؤية الإستراتيجية من قبل الحكومة الباكستانية يؤخر من إمكانية التوصل لحل سلمي بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان من جانب، وبين الأخيرة والإدارة الأميركية من جانب آخر. ويأتي عدم التبرير هنا، من تلك الرغبة اليائسة التي طالبت من خلالها الحكومة الأفغانية مرارًا وتكرارًا جارتها الباكستانية المساعدة في إجراء الحوار مع حركة طالبان، خصوصًا مع بدء التجهيزات للانسحاب الأميركي من المنطقة، والصعوبات التي تتوقعها الحكومة الأفغانية من خلال الفراغ الأمني الناجم عن ذلك، والوضع في الاعتبار أن بعض المحادثات التي بدأت بين حركة طالبان والولايات المتحدة تمت عبر باكستان. فلماذا إذن لا تقوم الأخيرة بالوساطة نفسها بين الحركة والحكومة الأفغانية؟ واللافت للنظر هنا أن الحركة ذاتها طلبت فيما بعد أن تتم اللقاءات مع الأميركيين عبر وسطاء آخرين بعيدًا عن الحكومة الباكستانية، وهو ما لعبت فيه الحكومتان الألمانية والقطرية دورًا كبيرًا في جلوس الطرفين معًا وجهًا لوجه بعيدًا عن الهيمنة الباكستانية؛ حيث بدأت الحركة تحرص على إظهار عدم تبعيتها وخضوعها لباكستان، والتأكيد على انتمائها لأفغانستان.
ويطرح المؤلف مسألة على قدر كبير من الأهمية تُبرز أهمية باكستان في جنوب غرب ووسط آسيا تتعلق بالتأثيرات التي تسببها هذه الدولة على المنطقة وعلى الغرب ذاته؛ فما يحدث في أفغانستان لا يتعدى حدودها غالبًا، بينما ما يحدث في باكستان يتجاوز حدودها ليؤثر على جيرانها كما يؤثر على الغرب نفسه. فما زالت باكستان هي موطن "الإرهاب" بالنسبة للغرب، كما أنها الراعية الأساسية له. من هنا فإن أي تحول في باكستان لابد أن يبدأ من حيث تتم مواجهة "الإرهاب"، والتخلص من "الجماعات الجهادية" التي تجد في باكستان موطنًا لها حتى الآن. فالتطور والتنمية في باكستان لا يعنيان مجرد رفاهية للشعب الفقير، بقدر ما يعنيان المزيد من الاستقرار لدول المنطقة التي تشمل الهند والصين وربما أيضًا الشرق الأوسط.
ويقدم الكاتب تفسيرًا مهمًا لما آلت إليه حال باكستان منذ عام 1947 وحتى الآن، يتعلق بشكل أساسي بنهاية الحرب الباردة، وصعوبة الاستفادة من الانقسام الذي كان عليه العالم بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي؛ حيث يقترح بديلاً عن ذلك إما العمل على تنمية الاقتصاد المحلي، أو الاستفادة من شبكة العلاقات مع الجيران المحيطين، وهو ما لم تحقق فيه باكستان أي تقدم يُذكر؛ فعلى المستوى الاقتصادي لم تحقق باكستان شيئًا مهمًا، وعلى مستوى العلاقات في المنطقة فإنها لم تحقق سوى العداء والصراعات المتتالية والمتكررة.
القيادات الباكستانية ووضعية الإنكار
تبدو أزمة باكستان العميقة في طبيعة القادة الذين يتناوبون حكمها؛ فالمأزق الباكستاني يبدو عميقًا وكارثيًا من خلال عدم وجود قائد قومي يخلق حالة من الإجماع الوطني، وبشكل خاص بعد رحيل بنازير بوتو ومجيء زوجها آصف علي زرداري الذي يعيش في معزل بعيدًا عن شعبه خشية أن يلقى مصير زوجته الراحلة. وهي عزلة أضافت المزيد من تراجع شعبيته وضعف قدراته على الحسم واتخاذ قرارات رادعة وناجعة سياسيًا.
ولا يقف الأمر عند ضعف القيادات فقط، لكنه يرتبط أيضًا بتناحرهم وصراعهم الشخصي ونيلهم من بعضهم البعض، وهو أمر لا يجعلهم قادرين على مواجهة الأوضاع الباكستانية بشفافية وصدق بقدر تناولها من خلال إلقاء التهم على من سبقهم. وربما يمنحنا ما قاله زرداري في هذا السياق عن سلفه برفيز مشرف ما يكشف عن طبيعة القيادات في هذا البلد المتخم بالاضطرابات والكوارث. يقول زرداري مُنكرًا فشل الدولة الباكستانية: نحن لا نمثل دولة فاشلة حتى الآن، ربما يمكن أن نكون كذلك خلال السنوات القادمة إذا لم نتلق الدعم الدولي المناسب لمواجهة تهديدات طالبان. ويضيف قائلاً: إن باكستان تلقت خلال حكم مشرف مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية بلغت 11 بليون دولار أميركي بينما تلقت تحت إدارتي ما يتراوح بين 10-15 مليون دولار.
إن هذا التناحر السياسي بين القادة يجعلهم غير قادرين على طرح إستراتيجيات فاعلة لمواجهة الأوضاع المتردية في باكستان، ومن ثم يخلق شكلاً من أشكال الإنكار لكافة المشكلات التي تواجههم، مفضلين توجيه التهم لمن سبقهم، أو التحايل على تحديد طبيعة المشكلات ودرجة التحديات التي تفرضها على الدولة. فالنظام السياسي الراهن سواء من خلال الجيش أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يرفض الاعتراف بالمخاطر الهائلة التي سببتها حركة طالبان للدولة، والقدرات التي يمكن أن تنطوي عليها تلك الحركة وغيرها من "الحركات الجهادية" في إمكانية إسقاطها وتأكيد فشلها.
واللافت للنظر هنا أن تلك الصراعات السياسية هي ما تساعد طالبان باكستان وغيرها من الحركات الدينية الأخرى على الاستشراء وكسب المزيد من النفوذ على مستوى الأرض والسياسة وعقول الباكستانيين. وهو أمر ينذر بالمزيد من المخاطر خصوص إذا ما وضعنا في الاعتبار التوسع الإقليمي المتوقع لتلك الحركات في الهند وغيرها من دول الجوار الأخرى.
أوباما وتصاعد الأحداث في المنطقة
إذا كانت معظم الكتابات تُلقي باللائمة على الرئيس السابق بوش بسبب ما شهدته المنطقة من أحداث دموية تحت شعار الحرب على الإرهاب، فإن الكاتب يلقي باللائمة أكثر على أوباما الذي شهدت المنطقة على يديه تدهورًا هائلاً رغم ما تدعيه إدارته من هدوء نسبي بها. فمنذ البداية أعلن أوباما عن عزمه سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول عام 2014، وهو ما وفر حماية معنوية لحركة طالبان وتنظيم القاعدة للعودة مرة أخرى للعمل في المنطقة واستعادة نفوذهما بشكل شبه علني. ورغم محاولات إدارة أوباما أن تخلق تحالفًا جديدًا عبر الحلول الدبلوماسية القائمة على جمع الأطراف المتنازعة والدول المتجاورة المرتبطة بجنوب غرب ووسط آسيا من أجل إيجاد قاعدة إقليمية تضمن استقرار ما بعد الانسحاب، ورغم محاولة تركيا لأن تمثل وسيطًا ومرفئًا آمنًا ومستقلاً من أجل تجميع كافة الأطراف، فإن هذه المحاولات لم تثمر حتى الآن ما يضمن نجاح الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وسيادة الهدوء والأمن.
وفي ضوء ذلك، يرى الكاتب أن العلاقات الأميركية مع إيران في أسوأ أحوالها، كما أنها شبه متوقفة مع باكستان، إضافة إلى ذلك فإن إدارة أوباما لا تُلقي بالاً للوضع الاقتصادي فيما بعد الانسحاب. فالقوات الأميركية -التي تراجع عددها من 100,000 جندي حتى وصل إلى 66000 جندي الآن- يعمل في خدمتها عشرات الآلاف من الأفغان الذين سوف يجدون أنفسهم في عداد البطالة بسبب عدم وجود اقتصاد أفغاني حقيقي يستوعبهم، وهو ما يعني المزيد من العاطلين عن العمل، مع التوقعات المرتبطة بذلك من انضمامهم للجماعات "الجهادية" بما في ذلك طالبان أو تنظيم القاعدة. وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تخدم افغانستان وتحقق السلام لشعبها، فإنها يجب أن تنهي هذه الحرب قبل مغادرتها لأفغانستان، وليس بعدها، وذلك عبر الحوار مع طالبان، وضخ المزيد من الأموال من أجل استعادة قدر ما من التنمية المتمثلة في الزراعة وتدعيم الصناعات الأفغانية التقليدية القادرة على تقليص نسب البطالة المرتفعة. فالتوجه العسكري فقط نحو طالبان لن يحل المشكلة ولن يوجد سلامًا في هذه المنطقة. فطالبان تنتمي إثنيًا لقبائل البشتون، وهو ما يعني أن قتل أعداد كثيرة من أفرادها، لن يعني نهايتها، بقدر ما يعني انتماء الكثيرين من البشتون، الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة، إليها، وتعويض خسائرها البشرية، وهو أمر يضمن لها الحفاظ على استمراريتها وصعوبة التخلص منها، وفقًا للنهج العسكري فقط.
وبخصوص توقيع معاهدة التعاون مع الإدارة الأميركية لما بعد الانسحاب، فإن أفغانستان تواجه الكثير من المعضلات يأتي على رأسها مسألة بقاء بعض القوات الأميركية، وما يرتبط بذلك من مطالبات قانونية تسمح بعدم محاكمة الجنود الأميركيين أمام محاكم أفغانية، وتحويل الرقابة على السجون من القوات الأميركية إلى الإدراة الأفغانية. كما أن هذه المعاهدة تواجه مشكلات إقليمية تتعلق بدول الجوار التي تشمل إيران وباكستان وروسيا وجمهوريات آسيا الوسطى؛ فهذه الدول، فيما عدا الهند التي تدعم هذا الاتفاق مع الإدراة الأميركية، لا تترك لأفغانستان فرصة الاختيار، فإما أن تتركها لتوقيع الشراكة مع أميركا لتصبح حليفتها أو عميلتها في المنطقة، وإما أن تطلب منها عدم التوقيع لتجد نفسها في حضن هذه الدول، وتحت مظلة تبعيتها المباشرة لها. وهو موقف سياسي لا يوفر لأفغانستان مرونة الاختيار ولا يساعدها في تقوية موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة من أجل الوصول لمعاهدة شراكة تضمن الأمن السياسي والاقتصادي في الوقت نفسه. وهو ما أدى في النهاية لإقناع كرزاي الشعب الأفغاني بأهمية توقيع الاتفاقية تجنبًا لأية تدخلات قد تقوم بها الدول المجاورة في الشأن الأفغاني.
وخطورة هذه الاتفاقية أنها تثير دول الجوار، حيث من غير المتصور ترحيب إيران أو الصين بوجود القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية لمدة خمسة عشر عامًا قادمة، وهو الشعور نفسه المتصور من قبل باكستان. وعند هذه النقطة يجب أن تتخلى باكستان عن دعمها لحركة طالبان وغيرها من "الحركات الجهادية" الأخرى، وتتصرف كدولة تدعم الشرعية بما يجعل الأطراف الأخرى تقبل بها كراع حقيقي للسلام في المنطقة، ولكن يظل هذا التوجه رهنًا بطبيعة التغيرات السياسية فيها، ورهنًا بجيل جديد من الشباب يبغي التغيير ويسعى له.
معلومات الكتاب
عنوان الكتاب: باكستان على وشك السقوط: مستقبل أميركا وباكستان وأفغانستان - Pakistan on the Brink: The Future of America, Pakistan, and Afghanistan
المؤلف: أحمد راشد - Ahmed Rashed
عرض: صالح سليمان عبدالعظيم - باحث وأكاديمي
الناشر: دار فايكنغ للنشر، نيويورك، 2012 - Viking Adult Publisher, New York, 2012
عدد الصفحات: 256
____________________________________
صالح سليمان عبد العظيم - باحث وأكاديمي