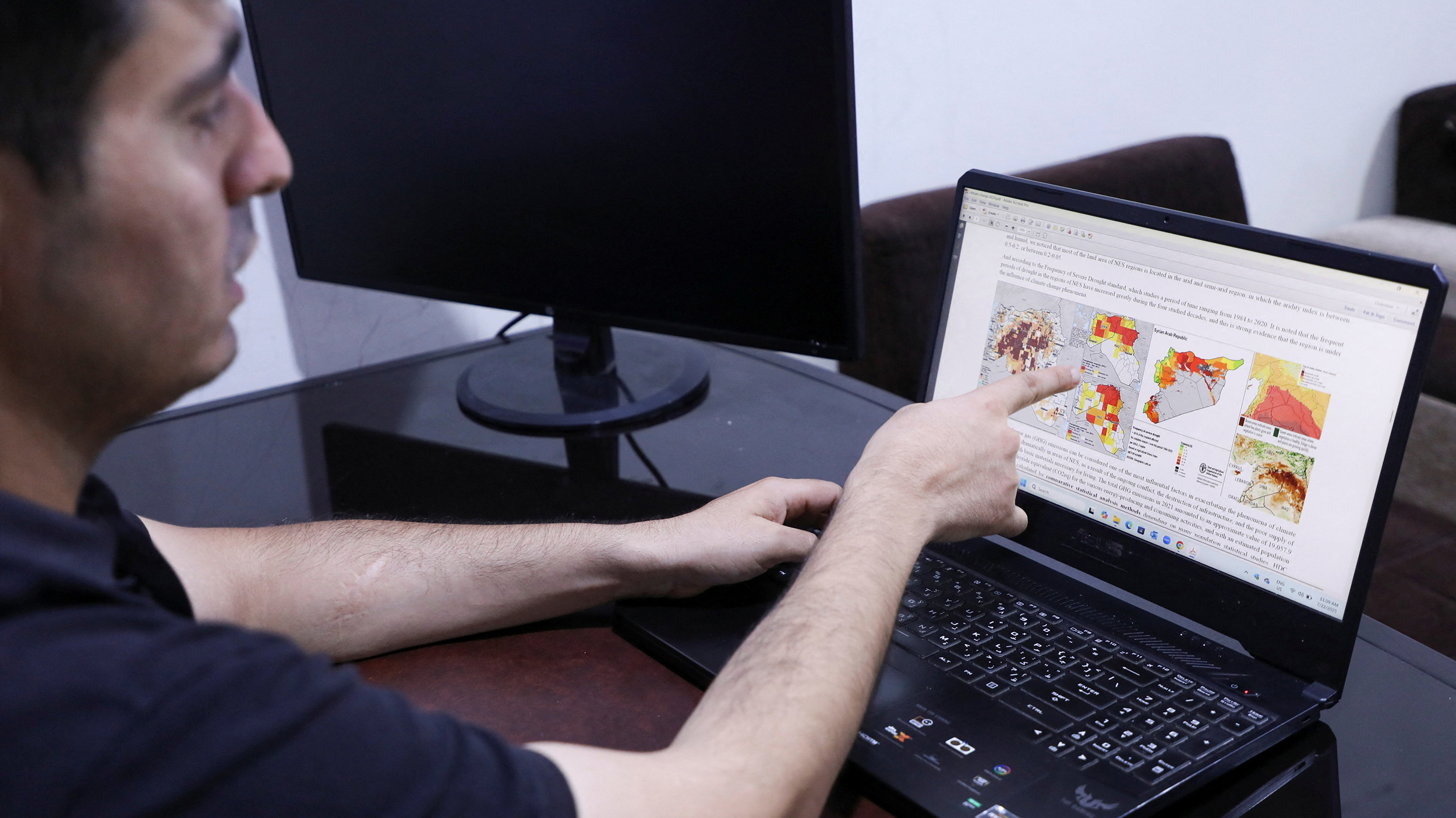
مقدمة
لا يلتقي الأكاديميون وأهل الصحافة والإعلام حول مفهوم واحد للصحافة الاستقصائية، والتي لا يزال غير مُتَّفَق على تعريفها وتحديد هويتها. فيعتبرها بعضهم مجرد شكل من أشكال الصحافة التقليدية الجيدة والحسنة التنفيذ ويتم إنجازها بالأساليب القديمة نفسها، ولكن بطريقة أكثر تمحيصًا. وكانوا يُطْلِقون عليها، في أربعينات القرن الماضي، تسمية صحافة "الكشف" أو "التحديد"، بينما صنَّفها فريق من الباحثين الغربيين، وفي مرحلة مبكرة من الستينات، نمطًا من أنماط التغطية الصحفية الذي يُمثِّل امتدادًا لما اصْطُلِح على تسميته، في الدراسات الإعلامية، بـ"تيار الصحافة التفسيرية المتعمقة". وفي حين تتعدَّد تعريفات الصحافة الاستقصائية (صحافة "العمق" أو "الابتكار" أو "المشاريع")، يرى فيها البعض أسلوبًا مختلفًا في العمل الصحفي؛ يتجاوز حدود التغطيات والمعالجات المتعمقة للقضايا، أو الكشف عن الحقائق المخفية وفضحها أو البرهنة عليها أو استكمالها، إلى لعب دور في التصدي لشتى أوجه الانتهاكات والانحرافات والقصور في أداء مؤسسات المجتمع وهيئاته، والأهم خروج العاملين فيها من دائرة الانتفاع من الحكومات والشركات على حساب الصالح العام(1).
لكن دور الصحافة الاستقصائية والوجهة التي خطَّتها لنفسها الأُطُر والشبكات، التي تأسست ما بعد العام 2005، يطرحان التساؤلات حول حدود دور هذه الصحافة، والوظيفة التي تقوم بها في ظل التغيرات والصراعات التي يشهدها العالم عامة، والمنطقة العربية خاصة. وعندما نتكلم، في وقتنا الحاضر، عن "صحافة الاستقصاء والتحري" نعني بها، بحسب بعض الصحافيين الاستقصائيين، صحافة تُمثِّل أعلى مراتب المهنية الإعلامية وأصعبها، وتتحدَّد معها، بدرجة كبيرة، قوة وسائل الإعلام ومكانتها ومهامها كـ"سلطة رابعة" في المجتمعات(2). وليس من قبيل الصدفة أو التوصيف السطحي، إذن، أن تُنْعَت الصحافة الاستقصائية بـ"رمز نُبْل المهنة"(3)، وتتجسد فيها رسالة الصحافة في تحقيق النفع العام وحماية حقوق الناس وحراسة مصالحهم. ومن المهم الإشارة هنا -في مطلع الألفية الثالثة وارتباطًا بالحديث عن الفساد واستخدامه في العُدَّة المفاهيمية الجديدة التي روَّجت لها النيوليبرالية- إلى تعاظم الحاجة للعمل الصحفي الاستقصائي بهدف خدمة التغيرات الهيكلية التي طرأت على بنية المجتمع.
واستدعت هذه الحاجةَ حالةُ الفوضى غير المسبوقة التي رافقت (وتُرافق) التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاتصالية (الرقمية) في المنظومات الإعلامية، هذا فضلًا عن اهتزاز أخلاقيات المهنة التي أضحت محكومةً بتنافس محموم لاستمالة الرأي العام، بأي ثمن. فقد راج في معظم الأوساط الصحفية، لابد من الإقرار، "أسلوب جديد" في الكتابة، يُكرَّس نمطًا فرضه ما يمكن تسميته بـ"ديكتاتورية العاجل"(4) أو "القلق الجماعي المشترك"، والذي بات العنوان لمرحلة صارت فيها السرعة المحدد الرئيسي (وأحيانًا الوحيد) لأجندة غرف الأخبار والدورة الإنتاجية. وطغت على المشهدية الإعلامية صورةُ مَنْ يمكن تسميتهم بـ"الصحافيين الاستهلاكيين" الجانحين، بقوة، إلى ركوب موجة العصر، وبات همُّهم الأول وهاجسهم الأكبر كيفية إرضاء الأجيال الطالعة المبهورة "بمعجزة" الرقمي. وعليه، صاروا، بمعظمهم، يُغلِّبون ما هو سهل وبسيط على ما هو صعب وعميق، ومن دون تكبُّد أدنى عناء للتنقيب عن المعلومة ومصادرها المختلفة، أو التركيز على البحث الدقيق في طرح الأحداث والمواضيع والقضايا، أو التحليل في طريقة السرد، من مختلف الزوايا، لإشباع رغبة الجمهور وتقديم الحقيقة كاملة له.
ويتوجب التمييز هنا بين العمل الصحفي التقليدي والعمل الصحفي الاستقصائي؛ إذ لا تخضع صحافة الاستقصاء، كالصحافة العادية، لمعيار السرعة في البث والنشر، ولا لـ"جاذبية" السبق الصحفي وحصرية تقديم الخبر والمعلومة، بل تُعتبر عملًا صحفيًّا يقوم على جهد بشري مكثف (غالبًا مستقل) يطمح ويجهد لتقديم المعلومات الموثقة، والتي يصبح التأكد من حقيقتها ودقتها ومصداقيتها أهم من المعلومة نفسها(5). لذا، تَبرُز أهمية صحافة الاستقصاء، ليس لكونها تكشف، فقط، عن الحقائق الغائبة أو المستترة أو المحجوبة (بفعل فاعل غالبًا)، بل صحافة ترتقي إلى مستوى الحرفة، وتعتمد على معايير الصحافة المتأنية التي يقيس فيها الصحافيون تغطيتهم بالأشهر والسنوات وليس بالأيام، تمامًا كما يفعل الباحثون العلميون. "فالمعايير المعتمَدة لاختيار أي موضوع استقصائي لابد أن يسبقها تأكد من جانب الصحافي حول إمكانيته في الوصول إلى المصادر المعنية بموضوعه، وأن يكون لديه القدرة على الحصول على الأدلة التي توثق الضرر الناتج عن المشكلة التي هو بصدد معالجتها من أجل مواجهتها"(6).
فلا يمكن أن يُجري الصحافي استقصاء بمجرد حصوله على المعلومات من مصادرها المختلفة، بل "يتوجب عليه التفكير بشكل منطقي وعلمي في مقاربة موضوعه (الأسلوب الذي يتنافى عضويًّا مع أساس العمل الصحفي التقليدي)، فيطرح مثلًا فرضية، كنقطة بداية للانطلاق إلى مزيد من التقصي، أو يقوم بتفسير مبدئي مبني على دليل أو أدلة محدودة"(7). ونشير إلى أن الصحافيين العاملين في مجال الصحافة الاستقصائية باتوا يستخدمون، عقب تأسيس "الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية" (GIJN) (2003)، منهجًا يتماهى مع أسلوب البحث العلمي. ونعني بالمنهج الطريقَ أو الأسلوب الذي يختاره الصحافي الاستقصائي من بين عدة طرق وأساليب علمية (المناهج)، بما يتناسب مع الموضوع الذي يتقصَّى فيه، وذلك وفق خطوات محددة كي يصل إلى حلول له أو إلى بعض النتائج بشأنـه. وعليه، أضحت التحقيقات الاستقصائية قريبة، إلى حدٍّ كبير، إلى البحوث الأكاديمية، بالنظر إلى توسُّلها عملية بحث دقيق وتوثيق بمراجع ومصادر موثوقة واستخدامٍ لأدوات بحثية ومنطلقاتٍ منهجية للعمل، أبرزها، على الإطلاق، الفرضيات التي تُساعد في تأطير البحث والاسترشاد به أثناء عملية الاستقصاء(8).
1. اعتبارات منهجية
تبحث الدراسة في مدى ارتباط الاستقصاء الصحفي بالبحث العلمي، وتحاول الوقوف على حجم وكيفية تعامل الصحافيين الممارسين للصحافة الاستقصائية مع تقنياته ومناهجه، من دون التعمق في الوظيفة التي تؤديها أو تخدمها التحقيقات الاستقصائية في المجتمع؛ إذ يتطلب هذا المستوى من الدراسة البحثَ في مجموعة من التحقيقات الصحفية الاستقصائية، وتحليل استخداماتها في المجتمع وفي العملية السياسية أيضًا (وهذا الأمر لا يندرج ضمن نطاق بحثنا الحالي). ستحاول الدراسة الإجابة على إشكالية يُلخِّصها السؤال المركب الآتي: إلى أي مدى يستلهم الصحافي الاستقصائي أسلوب الأبحاث العلمية لإعداد موضوعه الصحفي؟ وأي دورٍ لهذا الأسلوب في تعزيز قواعد الصحافة الاستقصائية وخلق تمايزها؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة البحثية التالية:
- ما الخصائص التي تميز العمل الصحفي الاستقصائي عن سائر الأعمال الصحفية؟
- على ماذا تعتمد عملية إنتاج عمل صحفي استقصائي؟
- ما الدوافع التي تُفضي إلى استخدام أسلوب البحث العلمي في التحقيقات الاستقصائية؟
- ما الذي توفره الأدوات البحثية العلمية للعمل الاستقصائي؟
تُقارِب الدراسة الموضوع مقاربة وظيفية ترى أن لكل عنصر من العناصر التي تدرسها الباحثة وظيفة لها دورها المحدد والخاص، وذلك بالاعتماد على المنهجين، الوصفي والمقارن. وعليه، سنتعرف على أبرز الفروقات الموجودة بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية، من جهة، وبين العمل الصحفي الاستقصائي والبحث العلمي، من جهة ثانية. وبما أن الدراسة بحث نوعي يرمي، بشكل خاص، إلى تحديد دور البحث العلمي ومكانته في العمل الصحفي الاستقصائي، كانت أداة "المقابلة" هي الأكثر ملاءمة لموضوعنا؛ إذ يمكنها أن تُعرِّفنا أكثر، ومن خلال محاورة المبحوثين المعنيين، على الإضافة التي تُقدِّمها مناهج وتقنيات وأدوات البحث العلمي للعمل الصحفي الاستقصائي، وما إذا كان ذلك يمكن أن يؤثر في إنتاج مادة صحفية مختلفة وذات جودة(9).
لقد أجرت الباحثة عشرين مقابلة (وزعتها مناصفةً) مع صحافيين يعملون في مجال الصحافة الاستقصائية العربية(10)، وأساتذة في كليات الإعلام والاتصال يُدَرِّسون هذا النوع الصحفي، أو خضعوا لتدريب للقيام بهذه المهمة(11). وطرحت على الصحافيين مجموعة أسئلة تمحورت حول: مفهومهم للعمل الاستقصائي، والفروقات التي تُميِّزه عن العمل الصحفي الميداني العادي، فضلًا عن المعايير التي يعتمدونها لاختيار مواضيعهم وإعداد خططها، وما إذا كان هناك مواضيع تحتاج، أكثر من غيرها، لمناهج البحث العلمي وأدواته. أما الأكاديميون، فتركزت المقابلات معهم حول: رأيهم فيما يخص واقع تدريس الصحافة الاستقصائية في الجامعات والمعاهد العربية والمواد والمقررات التي تُخصِّصها لهذه الغاية، وما إذا كان هناك من حاجة فعلية لتدريس الصحافة الاستقصائية نمطًا مستقلًّا، والفروقات التي يعتقدون بوجودها في طرق تدريسها ما بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز التدريب الصحفية المتخصصة. هذا فضلًا عن رأيهم في أوجه الشَّبَه بين التحقيق الصحفي الاستقصائي والبحث العلمي، وما إذا كانت هناك مواضيع استقصائية تحتاج، أكثر من غيرها، إلى أسلوب ومنهجية البحث العلمي.
لقد أجرت الباحثة المقابلات، وبمساعدة كبيرة من شبكة "أريج" ذات الباع الطويل في مجال الصحافة الاستقصائية، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، عبر "زووم" (Zoom) أو "الواتساب" (WhatsApp) أو البريد الإلكتروني. وحرصت، قدر المستطاع، أن تتوزع المقابلات على صحافيين وأساتذة في أكثر من دولة عربية، ولكنها لم تتمكن من تحقيق ما تصبو إليه، بالكامل، بالنظر إلى صعوبة التحكم في تجاوب المبحوثين، وكذلك قدرة الوصول إليهم وإنجاز المقابلات ضمن المهلة المحددة لإعداد هذه الدراسة.
2. ماهية الاختلاف بين الصحافتين: التقليدية والاستقصائية
يخلط الكثير من الصحافيين (وغير الصحافيين) بين مفهومي الصحافة الميدانية الجريئة، والصحافة الاستقصائية التي تُمثِّل، لابد من التذكير، فلسفةً خاصة في العمل الإعلامي. ولهذا الخلط أسبابه التي أفضت إلى تداخل مهنة صحافة الاستقصاء والتحري وتنفيذها، مع أنواع الصحافة التقليدية الأخرى المعروفة؛ قد يكون أبرزها انتفاء وجود تعريف دقيق لماهية الصحافة الاستقصائية، في عالمنا الحديث، يتقاطع مع ما تراه النظريات الإعلامية المتنوعة. من هنا، بات يشوب فكرة التمايز أو الاختلاف بين الصحافي الاستقصائي والصحافي الميداني التقليدي الكثير من سوء الفهم(12)؛ ما يدفع ببعض الصحافيين وأساتذة الإعلام لاعتبار أن كل صحافة هي استقصاء. وفي ذلك بعض الحقيقة، في الواقع؛ إذ يستخدم المراسلون في الميدان أساليب تقصٍّ، بدرجات مختلفة، سواء أكان ذلك في تغطيتهم للأخبار أو في عملهم على قصص صحفية معمقة.
لكن، يستخدم البعض صفة "صحافي استقصائي" بمجرد عمله على أخبار وتقارير تتناول الجريمة أو الفساد، أو كذلك، إذا تضمنت بعض مقالات الرأي التي ينشرها أو التحليلات التي يقوم بها نَفَسًا نقديًّا. وصار كل صحافي يُعِدُّ مادةً تحتوي على معلومات أو تسجيلات أو وثائق مسربة أو تتوسَّل السرية والتخفي، يُنْعَت (أو يَنْعَت نفسه) بالصحافي الاستقصائي، في ظاهرة توحي أن هناك "صحافيين مفتونين بلقب صحافي استقصائي"(13). ويمكن للصحافي أن يكون مهنيًّا جيدًا، بمعنى أن يسعى إلى معرفة حقيقة الأحداث والشخصيات والمجتمع من دون أن يكون محققًا صحفيًّا؛ فكُتَّاب الأعمدة ومقالات الرأي والقائمون على إجراء الحوارات، والمراسلون الذين ينقلون مآسي الحروب والكوارث، هم نماذج لهؤلاء الصحافيين الأكفاء الذين ليسوا بالضرورة صحافيين استقصائيين.
إذن، بماذا تختلف صحافة الاستقصاء عن الصحافة التقليدية؟
بطبيعة الحال، تتشابه معايير الصحافة الاستقصائية مع المعايير العامة للصحافة، لكنها تختلف عنها من حيث مقتضيات طبيعة عملها الذي يقوم على قواعد أشد تعقيدًا بشأن انتقاء الموضوع ومدى أهميته بالنسبة للجمهور، وكذلك من حيث قدرة الصحافي على الإلمام بكل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع(14). وعندما نُقارن بين الصحافتيْن، الاستقصائية والتقليدية، نقارن، في الحقيقة، بين نهجيْن من العمل الصحفي مختلفين جذريًّا؛ إذ يُسابِق الصحافي الميداني ظِلَّه ويركض خلف الأحداث (التي قد تكون المعرفة بها متاحةً للعامة)، ويكتفي بنقل الأخبار والوقائع والبيانات والتصريحات والمواقف ونشرها ضمن قوالب صحفية معينة. بينما يتأنَّى الصحافي الاستقصائي، ويغوص في محيطات القضايا ودهاليزها، ويُحلِّل جذورها، ويبتكر زاويةَ رؤيةٍ لموضوعاته "بهدف نبش معلومات غير مرئية، يُحرِّك من خلالها الساكن ويكشف الجديد الذي يخلق أثرًا إيجابيًّا من شأنه تغيير حياة الناس وقد يقود، أحيانًا، إلى تقديم الجناة إلى المساءلة"(15).
إذن، يمكن القول: إن الصحافة الاستقصائية لا تكتفي كالصحافة التقليدية بنقل الواقع، مثلما هو، من خلال الإجابة على الأسئلة الخمسة المعروفة بالـ"5Ws" (ماذا؟ من؟ متى؟ أين؟ لماذا؟)، بل تسعى إلى الإجابة على السؤال: كيف؟ (لذا تُسمَّى، عادةً، صحافة الـ"كيف؟")، بغية كشف الأسباب الكامنة وراء تَمَظْهُر الواقع بهذه الحالة أو تلك، وتغييره وإيجاد الحلول. لذلك، تُعَدُّ الصحافة الاستقصائية -بحسب المديرة التنفيذية السابقة، رنا الصباغ، لـ"إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية" (أريج)- "أفضل طريقة للوصول إلى قلب الحقيقة والخروج من دائرة التأثير المُبَرْمَج الذي يتم ضمن حلقات صناعة الإعلام وتمرير المعلومات"(16). ويرى بعض الصحافيين أن صحافة الاستقصاء والتحري "تلعب دورًا أساسيًّا في العلاقة التعاقدية فيما بين الناس والسلطة التي ينتخبها هؤلاء لإدارة شؤون الدولة؛ إذ يقع على عاتق الصحافي الاستقصائي البحث عن الخبايا والتدقيق فيها للتأكد من انتظام عقد التعاقد هذا"(17).
ويعتبر صحافيون آخرون أن "الاستقصائيات هي امتداد للتجربة الصحفية التقليدية في إعداد التحقيقات التي تطورت، عامًا بعد عام، وأصبحت مواد معمقة سُمِّيَت استقصائيات، لكن الفارق الأساسي هو أن هذا العمقَ يتطلب الغوصُ فيه تنفيذَ عمليةٍ مُحكَمةٍ بضوابط، وتتوسَّل أدواتٍ (للاستقصاء) ونماذج محددة لإثبات الحقائق والتحقق من المعلومات، وتستقصي الفاعل والمفعول به والأثر وحجم المشكلة"(18). وفيما يلي، ثلاثة جداول تُبيِّن أبرز الفروقات بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية على أكثر من صعيد(19). ويعرض الجدول الأول طريقة البحث والتغطية في كل من الصحافتين؛ إذ يستطيع القارئ ملاحظة الاختلاف، سواء أكان ذلك في طبيعة المواضيع المختارة، أو في متطلبات تغطيتها، أو المدة الزمنية التي تحتاجها للإعداد والنشر.
جدول (1): الفروقات بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية في طريقة البحث والتغطية
|
الصحافة التقليدية |
الصحافة الاستقصائية |
|
- المواضيع التي يعمل عليها الصحافي هي مواضيع الحياة اليومية والأحداث الروتينية والظواهر التي يُفرِزها المجتمع. |
- تُعَد المواضيع في غاية التعقيد والصعوبة، وقد تُعَرِّض الصحافي أحيانًا للخطر. |
|
- غالبًا ما يفترض العمل تغطية حدث محدد أو موضوع معين. |
- يفترض نهج العمل الاستقصائي التعامل مع ملف كامل متكامل وليس فقط مع تغطية آنية. |
|
- تُجْمَع المعلومات وتُرْسَل وفق إيقاع ثابت (يومي، أسبوعي، شهري). |
- عدم إمكانية الإبلاغ عن المعلومات أو نشرها إلا في حال التأكد من ترابطها واكتمالها. |
|
- يكتمل العمل الصحفي بسرعة، ولا يتم القيام بأي بحث آخر إلا بعد أن تكتمل القصة الصحفية. |
- يستمر البحث إلى أن يتم التثبت من القصة، وقد يستمر هذا البحث حتى بعد نشرها. |
|
- تقوم القصة الصحفية على الحد الأدنى الضروري من المعلومات، ويمكن أن تكون قصيرة جدًّا ومختصرة. |
- تقوم القصة الصحفية على الحد الأقصى من المعلومات التي يتم الحصول عليها، ويمكن أن تكون طويلة وموسعة. |
|
- يمكن لتصريحات المصادر أن تَحُلَّ محلَّ التوثيق. |
- يتطلب التحقيق الصحفي توثيقًا لدعم تصريحات المصادر أو إنكارها. |
لا صحافة من دون مصادر للمعلومات. وهذه القاعدة يعرفها كل عامل في وسائل الإعلام التي ترتكز، في كل ما تتناقله، إلى أنواع متعددة من المصادر الصحفية. لكن "الصحافة الاستقصائية" تُعتبر أكثر المجالات الصحفية حاجةً وقابليةً لتوظيف المصادر على اختلافها. وفيما يلي، جدول رقم (2) يُبيِّن أبرز الفروقات بين "الصحافة التقليدية" و"الصحافة الاستقصائية" بشأن العلاقة مع المصادر.
جدول (2): الفروقات بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية في العلاقة مع المصادر
|
الصحافة التقليدية |
الصحافة الاستقصائية |
|
- الثقة بالمصدر مفترضة، وغالبًا لا يتم التحقق منه.
|
- لا يمكن افتراض الثقة بالمصدر، ولا يمكن استخدام أي معلومات مأخوذة منه، من دون التحقق منها. |
|
- عادةً، تُقدِّم المصادر الرسمية المعلومات للصحافي مجانًا لقاء شروط تفرضها (تعزيز دورها والترويج لأهدافها مثلًا). |
- تُحْجَب المعلومات الرسمية عن الصحافي؛ لأن كشفها قد يُعرِّض مصالح السلطات أو المؤسسات للخطر. |
|
- لا مجال أمام الصحافي سوى قبول الرواية الرسمية للقصة التي يعمل عليها (على الرغم من قدرته على معارضتها ودحضها أحيانًا بتعليقات أو بيانات من مصادر أخرى). |
- يتحدى الصحافي، صراحةً، الرواية الرسمية للقصة، أو يُنكرها بناء على معلومات يستقيها من مصادر مستقلة. |
|
- يتصرَّف الصحافي بالمعلومات أقل مما تتصرَّف بها معظم مصادره أو كلها. |
- يجمع الصحافي المعلومات ويتصرَّف بها أكثر مما يتصرَّف بها معظم مصادره أو جميعها. |
|
- المصادر تكون غالبًا معلومة، ولا تُسْتَخْدَم المصادر المُجَهَّلَة إلا نادرًا. |
- لا يمكن تعريف غالبية المصادر، ويقوم الصحافي بحجب هويتها عن الجمهور لضمان سلامتها وأمنها. |
أما الجدول الثالث (رقم 3)، فيعرض أبرز الفروقات الأساسية بين "الصحافة التقليدية" و"الصحافة الاستقصائية" فيما يتصل بطبيعة المُنْتَج الذي تُقدِّمه كلٌّ من الصحافتين. ويمكن أن نلاحظ بسهولة أن النوعية المطلوبة في إعداد التقارير والتحقيقات الاستقصائية تقتضي من مُعدِّيها طريقة تحضيرٍ مختلفة عن تلك التي ينتهجها زملاؤهم من الصحافيين العاديين.
جدول (3): الفروقات بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية في طبيعة المنتج الصحفي
|
الصحافة التقليدية |
الصحافة الاستقصائية |
|
- يُنْظَر إلى التحقيق الصحفي انعكاسًا للواقع ويتم، على هذا الأساس، قبوله كما هو، ولا يأمل الصحافي الوصول عبره إلى نتائج أبعد من مجرد إِخْبَار الجمهور بموضوعه. |
- يرفض الصحافي قبول الواقع كما هو؛ إذ إن هدف القصة الصحفية هو اختراق وضع معين أو تعريته، كي يتم إصلاحه أو إدانته أو في حالات معينة تقديم مثال لطريق أفضل. |
|
- غالبًا ما لا يتطلب التحقيق الصحفي العادي انخراطًا وحماسًا شخصييْن من جانب الصحافي. |
- لا تكتمل القصة الصحفية، أبدًا، من دون انخراط شخصي وحماس من جانب الصحافي. |
|
- يسعى الصحافي، قدر المستطاع، إلى أن يكون موضوعيًّا وألا يتحيَّز لأي طرف في القصة أو أن يُصدِر حكمًا عليها.
|
- يسعى الصحافي لأن يكون عادلًا ومدققًا في حقائق القصة، وبناءً على ذلك قد يُحدِّد ضحاياها وأبطالها ومسؤوليات المشاركين فيها ويُقدِّم حكمًا على القصة أو يتخذ (أو يُصدِر) قرارًا بشأنها. |
|
- أغلب الأشكال الصحفية تعتمد على الفورية وتُبْنى على شكل قالب الهرم المقلوب (أي تُرتَّب المعلومات في جسم الخبر بحسب الأهمية المتناقصة). |
- تأخذ التحقيقات الاستقصائية، عادةً، أشكالًا تحريرية أخرى، وتكون متسلسلة في السرد بصورة منطقية بهدف الإقناع. |
|
- بنية القصة الدرامية ضرورية ولها تأثير؛ إذ تقود إلى استنتاجات يُقدِّمها الصحافي أو المصدر. |
- لا تهم البنية الدرامية كثيرًا في التحقيق الصحفي، وليس للقصة نهاية لكون الأخبار مستمرة. |
|
- قد يرتكب الصحافي أخطاء، ولكنها لا تكون، في العادة، "مميتة". |
- تُعَرِّض الأخطاءُ الصحافي لجزاءات رسمية أو غير رسمية، كما يمكن أن تُحطِّم مصداقيته ومصداقية الوسيلة الإعلامية التي يعمل لصالحها، والأسوأ أنها قد تعرضه للأخطار. |
يتفق جميع أفراد عينة الدراسة الذين قابلتهم الباحثة، من صحافيين وأكاديميين، على تفرد الصحافة الاستقصائية بمعايير خاصة قد لا يجد الصحافيون غير الاستقصائيين ضرورةً لاستخدامها. وهذا ما يدفع بهؤلاء، وأثناء تنقيبهم عن مُخبرين ومصادر لمعلوماتهم في "حقل ألغام"، إلى اتباع منهج مدروس ومخطط له وفق قواعد وأصول علمية محددة (كذاك المُتَّبَع في البحث العلمي)، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة الخالصة، وأينما كانت هذه الحقيقة(20). ولا نعني بهذا المنهج النشاطَ المتخصص الذي يمارسه العلماء، والذي يقتصر على مجال علمي معين ضمن تخصص معين، بل نتحدث، في هذا الصدد، عن محاولة أو طريقة أو أسلوب يمكن أن يُوجِّه الصحافي الاستقصائي لحلِّ مشاكل وقضايا يواجهها الجمهور في مجالات متعددة (سياسية، اقتصادية، صحية، علمية..إلخ)، خاصة أن الوظيفة الأساسية للصحافة الاستقصائية تتمثَّل في حراسة مصالح المجتمع(21).
3. علاقة صحافة الاستقصاء بالبحث العلمي
لم يكن يُشار قبل العام 2000 إلى أي رابط بين الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي، أو إلى حاجة الصحافي لاستخدام أدوات بحثية في تغطيته ومعالجته لمواده، إنما كُنَّا، عندما نُدَرِّس طلابنا في كليات الإعلام وفنون الاتصال، نحرص على إقامة الفرق بين ما هو "صحفي" وما هو "بحثي"، وتاليًا بين "الكتابة الصحفية" و"الكتابة العلمية". وكنا نُقَدِّم لهم الأمثلة والنماذج التي توضح أولوية أن تَحْكُم "الكتابةَ الصحفية" القيمُ الخبرية، والتي نُسمِّيها في عالم الصحافة والإعلام "معايير النشر"، مثل: الآنية، والحداثة، والضخامة، والقرب، والغرابة..إلخ. ونؤكد لهم، بالمقابل، ضرورة أن ينصبَّ الاهتمام في "الكتابة العلمية" على الاستنباط والتحليل والنقد وقراءة ما بين السطور وتجريد الأفكار والأحكام والالتزام بتسلسل معين لفقرات المنهجية العلمية التي يضعها الباحث لموضوعه..إلخ(22). ولكن، ماذا يعني اتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة الصحفية؟
بدايةً، لابد من توضيح لما يعنيه مصطلح "منهجية البحث العلمي" والذي قد يلتبس معناه على المتلقي، أحيانًا، مع معنى مصطلح "منهج البحث العلمي" (الذي أشرنا إليه آنفًا). فالمنهجية في البحث العلمي، تهتم بكل أجزاء هذا البحث وأقسامه من خلال تبيان عناصره وشروطه والقواعد التي تَحْكُمُه، فضلًا عن المسائل المتعلقة بالشكل، مثل: كيفية الاقتباس والتوثيق في الهوامش، وكيفية إدراج قائمة المراجع، وكيفية الترقيم، ووجوب وضع ملاحق أم لا..إلخ. ونعني بالمنهجية في العمل الصحفي الاستقصائي الخطط والقرارات التي يتَّبِعُها القائم بالاستقصاء، والتي تبدأ من المشكلة (البحثية) والمنطلقات العامة، مرورًا باختيار الصحافي لإجراءات الاستقصاء الذي يُنفِّذُه (المنهج وتصميم هيكل القصة/البحث وإستراتيجياته)، وصولًا إلى الطرق التفصيلية لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها(23).
صحيح أن اصطلاح "البحث العلمي" هو، في الحقيقة، اصطلاح كبير لا يُسْتَخْدَم إلا على المستويات العلمية العالية التخصص والعميقة التجربة، لكنه، في الواقع، أبسط من ذلك بكثير. فالمشاكل التي تصادفنا في حياتنا اليومية نحاول، قدر المستطاع، مجابهتها من خلال الوصول إلى حلول سليمة لها، بطريقة أو بأخرى. من هنا، كان تعريف البحث باعتباره عملية مستمرة لا تنتهي للتنقيب عن المعلومات والمعرفة والكشف عن الظواهر والحقائق، والعلاقات فيما بينها، وأهدافها، والسياقات الاجتماعية التي تتفاعل معها من أجل تحقيق هذه الأهداف ووصف تلك الحقائق وتفسيرها، وتوقع اتجاهات الحركة فيها(24). وفي إثارة موضوع العلاقة بين الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي، يتوجب التمييز بين التفكير العلمي والآليات التي تُسْتَخْدَم لتطبيقه في الدراسات الأكاديمية والبحثية، وبين استخدام تقنيات البحث العلمي في طريقة الاستقصاء والتحري في المواضيع الصحفية- قيد الإعداد.
وإذا قارنَّا بين تعريفيْ "التحقيق الصحفي الاستقصائي" و"البحث العلمي"، ومن ثم قارنَّا بين الطرق والأساليب والخطوات المطلوبة لإعداد كل منهما، يتبيَّن لنا مدى التشابه بين المجالين، بينما تقتصر اختلافاتهما على أمور شكلية أو شكلانية، تتركز، غالبًا، على تقرير العمل (البحثي والاستقصائي)، لكنها لا تمس الإجراءات المبذولة في تحقيق النتائج(25). وعندما ندخل أكثر في التفاصيل، نجد أن التشابه الكبير يعود، بشكل أساسي، إلى حاجة المجالين إلى استخدام بعض التقنيات، وأن الاختلافات تكمن، بوضوح، في منهجية العمل والأهداف النهائية لكليهما؛ إذ إن "الصحافة الاستقصائية تركز على كشف المعلومات التي تؤثر على الجمهور، بينما تركيز البحث العلمي يهدف إلى تطوير المعرفة والفهم في مجالات محددة"(26). وفي حين يرفض بعض الأكاديميين، رفضًا قاطعًا، "تشبيه أسلوب عمل الصحافة الاستقصائية بذاك المُتَّبَع في البحث العلمي"(27)، يعتبر بعضهم الآخر "أن الاستقصاء الصحفي ليس سوى ضرب من ضروب البحث العلمي، لأنه، في جوهره، فن استخدام العلم"(28).
وينصح أكاديميون بأنه "وعلى الرغم من اعتماد التحقيقات الاستقصائية على تقنيات البحث العلمي ومنهجياته، لكن يجب عدم المبالغة في توصيف حجم التماهي بينهما؛ لأن التحقيق الاستقصائي ليس بحثًا علميًّا، بل هو منتوج يستجيب لمقتضيات العمل الصحفي في النهاية"(29). ويعتبر آخرون "أن كلا المجالين يهدفان إلى كشف الحقائق، غير أن أسلوب المعالجة يختلف كليًّا؛ إذ من الممكن ألا تعطي خلاصة البحث العلمي جوابًا قاطعًا على الإشكالية المطروحة، بينما يمكن أن تُفجِّر نتائج التحقيق الاستقصائي "قنبلة" إذا كشف حقائق غير متوقعة"(30). ويُفصِّل بعض أساتذة الإعلام، ممن قابلتهم الباحثة، نقاط التقاطع بين البحث العلمي والتحقيق الصحفي الاستقصائي، على الشكل التالي: "يوازي السؤال الرئيسي (الإشكالي) لدى الباحث، التحديدَ الواضح للقضية التي يعمل عليها الصحافي. أما البحث في أرشيف القضية، فهو بمنزلة الأدبيات التي يجمعها الباحث حول عمل غيره من الباحثين في الموضوع الذي اختاره لدراسته. في حين يمكن تشبيه الدقة العلمية المطلوبة من الباحث بالأمانة المطلوبة من الصحافي في نقله للمعلومات والمعطيات والأخبار. ويبقى أخيرًا، التماثل الكبير للمنهجية العلمية مع منهجية العمل الصحفي، في حال احتاج الصحافي إلى التعمق في دراسات وملفات أو مقابلة عدد من الأشخاص"(31).
بماذا يُشبِه العملُ الاستقصائي البحثَ العلمي، وبماذا يختلف عنه؟
أوجه التشابه بين الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي
- يُعتبر البحث العلمي مشروعًا شخصيًّا للباحث؛ يُقرِّر الخوض فيه لميول لديه تجاه موضوع معين أو بهدف اكتشاف جديد في هذا الموضوع وإحراز تقدم فيه. والأمر ذاته ينطبق على الصحافي الاستقصائي الذي يُحرِّكه، غالبًا، دافع ذاتي غير موضوعي يتمثَّل في الرغبة في إصلاح العالم. ولهذا السبب تُسمَّى الصحافة الاستقصائية، عادةً، "صحافة المشروع الذاتي" (Enterprise Reporting)(32).
- تحسُّس، كلٍّ من الصحافي والباحث، للمشكلات والقضايا التي تصلح لأن تكون موضوعات لأبحاث علمية أكاديمية أو محاور لقصص استقصائية، وتطرح التساؤلات والتعجب والدهشة وإشارات الريبة.
- يتطلب كل من الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي التحقيق الدقيق، وجمع المعلومات والأدلة والشهادات وتحليلها بدقة لكشف الحقائق وتقديم خلاصات للنتائج التي تم التوصل إليها.
- في كل من المجالين، يُعَد التشكيك في المعلومات والبيانات والمصادر ومن ثم التحقق منها، جزءًا أساسيًّا من عملية إعداد المادة الصحفية أو البحثية.
- يتطلب كل من الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل لضمان دقة النتائج والمعلومات المقدمة.
- يهدف كل من المجالين إلى تقديم نتائج دقيقة وموثوقة والإفصاح عنها لجمهوره؛ فالصحافة الاستقصائية تسعى لكشف الحقائق للناس، بينما يهدف البحث العلمي إلى تقديم مساهمات جديدة (في الموضوع المدروس) إلى المجتمع الأكاديمي والعلمي.
- في الأبحاث العلمية والاستقصاءات الصحفية، يجب أن تكون القضية واضحة ومحددة وقابلة للتقييم أو التقدير، سواء من قِبَل المرجعيات الأكاديمية في الأبحاث العلمية (المشرف الأكاديمي أو المجلس العلمي)، أو من قِبَل المسؤولين الإعلاميين أو رؤساء التحرير في وسائل الإعلام أو المؤسسات القائمة على إنجاز الاستقصاء.
- ينطلق البحث العلمي وكذلك التحقيق الاستقصائي من وضع فرضيات حتى الوصول إلى نفيها أو الدفاع عنها، وذلك لا يحدث إلا بعد التأكد وعرض كل الأدلة والمستندات والحقائق وتحليلها.
- يواجه الباحث، ومثله الصحافي الاستقصائي، خلال وبعد القيام بجمع البيانات والمعلومات اللازمة للإجابة على الأسئلة والفرضيات، مهمة التحديد الدقيق للمصطلحات والتوصيفات والمفاهيم التي يتعاملان معها.
أوجه الاختلاف بين الصحافة الاستقصائية والبحث العلمي
- يُعَد النزول إلى الميدان مسألة حتمية في العمل الاستقصائي، بينما يتم الاكتفاء، في بعض الأبحاث، بالمصادر المكتبية أو الوثائقية.
- يتستَّر الصحافي، أحيانًا، على الوسائل أو المصادر التي أوصلته إلى الحقائق والمعلومات، بينما يُعطِي البحث العلمي الأهمية الكبرى للأساليب والأدوات التي استخدمها كي يتم تقييم مدى صدقيتها، وما إذا كان بالإمكان إعادة استخدامها، إذا لزم الأمر.
- يركز العمل الاستقصائي على كشف المعلومات والحقائق التي تؤثر على الجمهور (والسلطات)، بينما يركز البحث العلمي على تطوير المعرفة والفهم في المجالات التي يخوضها.
- يجب أن يعتمد الاستقصاء الصحفي على قصة ذات حبكة مترابطة ومبنية على الحقائق والأشخاص والوقائع، ويعتمد في "روايتها"، لجمهور عريض، على بعض الفنون والأساليب والتقنيات الأدبية. في حين يظل البحث العلمي (والأكاديمي) محكومًا بصرامة الخطوات المنهجية ولغة عرضها للجمهور الذي يبقى، في الغالب، محدودًا ومقتصرًا على الطلاب والباحثين.
- يستخدم الاستقصاء لغة مُختزَلة ومكثفة؛ لأن نتائج الجهد الاستقصائي ستُنْشَر في وسائل الإعلام ذات الحيز المحدد، مساحةً وزمنًا، ولأن المتلقي لا تهمه التفاصيل الكثيرة. بينما العكس صحيح في البحث العلمي؛ فالمُطَّلِع بحاجة لمعرفة التفاصيل، وليس هناك حاجة للاقتصاد والترشيد في المساحة أو المدة الزمنية، وبالإمكان الاطلاع على البحث في أي وقت وكيفما كان.
- لا يوجد في التحقيقات الاستقصائية، عادةً، منطلقات ومقاربات نظرية ولا إشكاليات بحثية مرتبطة بالموضوع المعالج، بينما تُعتبر هذه المنطلقات والمقاربات والإشكاليات جوهر البحث العلمي وعموده الفقري.
- في البحث العلمي نختبر الفرضيات (أي نُجري استدلالات حول خصائص المجتمع المدروس من خلال بيانات العينة)، ولكن لا نغيِّرها خلال البحث. بينما يمكن، في العمل الاستقصائي، أن نغيِّر الفرضية (أو ننسفها بالكامل) بناء على ما يستجد من معطيات، كما قد لا نكتفي بالإشارة إلى تَحَقُّق الفرضية (كما في البحث العلمي)، بل نستند إليها لكي نُكمِل "سرديةً ما" في العمل الصحفي.
- غالبًا ما يُتاح للباحث التفكير والتخطيط الهادئ لاختيار مفردات عيِّنته، وتقدير التقنيات المثلى لجمع البيانات والمعلومات من مصادرها، وتصميم أدواته وتعديلها وتطويرها كي تُناسب أغراضه. لكن هذه الفرص غير متاحة، أبدًا، للصحافي الاستقصائي الذي يُطارِد المعلومات فيما هو مطارَد من أكثر من عامل (مثل التشويش المتعمد أو الإخفاء المتعمد وغير المتعمد أو غياب الأدلة والشهود أو العامل الزمني أو الوسيلة الإعلامية التي يُعَدُّ الاستقصاء لصالحها...إلخ).
وفي ختام هذه المقارنة، لابد من الإشارة إلى أن تحديد الأدوات المناسبة لجمع البيانات والمعلومات يخضع لتقدير الصحافي الاستقصائي، وغالبًا ما يعتمد على اتصالاته الشخصية مع مصادر معلوماته، سواء أكانت تلك المصادر أولية أو ثانوية. وفي أحيان كثيرة، يسعى الصحافي المتقصي إلى تحسين الأداء وإتقان المهارات، مثل مهارات الحوار والاستماع والتوثيق، ولكن من دون الإخلال بالمضمون أو التوصيفات ذات الأبعاد القانونية أو الأخلاقية أو الأمنية(33).
4. الأدوات البحثية في خدمة الكتابة الاستقصائية
يُجمِع الصحافيون الاستقصائيون على أن الميزة الأساسية للصحافة الاستقصائية لا تعود إلى كونها مهنة وقوة اجتماعية قادرة على التغيير، فحسب، بل لأنها منهج واضح ومتكامل قائم بذاته. والأهم أن التجربة والممارسة الصحفية الاستقصائية قد أثبتتا مدى ارتباط هذا النوع الصحفي المتخصص بالبحث العلمي المرتكز إلى المنطق العقلي وإلى التفكير العلمي وأدواته وإجراءاته(34). وهذا يعني أن التحقيقات الاستقصائية لا تُخْتزَل باعتبارها نوعًا من "السبق الصحفي" الذي يستطيع الصحافي، من خلاله، الوصول إلى الهدف المنشود عبر تسليط الضوء على الآفات الاجتماعية وكشف الفساد، أو تحقيق طموح في الشهرة، وإنما هناك حاجة لدى الصحافي الاستقصائي إلى استلهام نطاقات محددة من آليات العمل البحثي (مثل الجدة والموضوعية والدقة والتبويب)، و"استعارة" بعض تقنياته ومنهجياته (مثل وضع فرضيات واختبارها وطرح التساؤلات واختيار المنهج..إلخ)، وتوظيفها من خلال السعي إلى ربط مضمون هذا العمل برابط منهجي معين، وأسلوب يُمكِّنه من القياس والتقييم على أساسه (مثل القدرة على التحليل، ووضع الأحداث والمواضيع والقضايا في سياقها، واستعمال أدوات تحليلية معينة..إلخ). ومن هذا المنطلق، يتشارك الصحافي مع الباحث الخطوات التالية في عمله(35):
- التشكيك: ويعني أن الصحافي يُخْضِع أي شيء للملاحظة للتأكد منه.
- المطابقة: إذ يُوثِّق الصحافي، بالمعلومات والوثائق، بحثه عن الحقيقة.
- غريزة التفعيل: وتعني نظرة الصحافي إلى الأشياء باعتبارها حالة للدراسة يمكن ملاحظتها والتحقيق فيها.
- التحقق: أي إمكانية التأكد من تحقق هذا الحكم أو الظاهرة على موضوع الدراسة وإمكانية الوصول إلى أرقام نسبية.
- البساطة: وتعني اختيار الصحافي لأبسط الطرق وأيسرها للوصول إلى الحقائق والحلول للمشاكل والظواهر التي يقوم بمناقشتها.
يتخذ العمل الصحفي الاستقصائي من البحث العلمي منهاجًا في التفكير، ويسير وفق طرق صحفية في التعبير. ويمكن تلخيص الاستفادة الصحفية من مناهج البحث العلمي عبر تقسيمها إلى مستويين:
- المستوى الأول: الاستفادة من الخطوات المنهجية للبحث العلمي في التصدي لموضوع معين، من خلال مجموعة من المراحل التي تتميَّز بالتسلسل والتتابع، من ناحية، وبالتداخل والترابط، من ناحية أخرى. وتتضمن هذه المراحل: الإحساس بالمشكلة، ووضع مجموعة من التساؤلات، وطرح الفرضيات، وتحديد طرق جمع البيانات وتصميمها، وجمع البيانات تبعًا للطرق التي تم تصميمها لهذه العملية، والمعالجة الإحصائية للبيانات التي تم جمعها، واستخدام النتائج المحددة التي انتهت إليها الدراسة، والتعميم، والتنبؤ.
- المستوى الثاني: الاستفادة من أهم سمات البحث العلمي في جمع المادة أو البيانات الصحفية، وتصنيفها وتحليلها والوصول إلى خلاصات من أهمها: التكميم والقياس، والثبات والصدق في القياس، ووضع الفرضيات واختبارها، والاستنتاج السببي(36).
هناك قناعة شائعة في أدبيات مهنة الصحافة، ومعظم المراجع التدريبية ذات الصلة بصحافة الاستقصاء وتعليم إعداد موادها، بأن الإعلامي سيكون قادرًا على كتابة قصة صحفية حيوية بمجرد عثوره على المعلومات التي يحتاجها في الموضوع الذي يتحرَّى عنه. ولكن ممارسة العمل الاستقصائي أثبتت أن الصحافي يتوجب عليه، لإعداد تحقيق استقصائي ناجح، أن يتتبَّع آلية معينة منضبطة ومنهجية في البحث للوصول إلى غايته وأهدافه، ويتمثَّل أبرز هذه الخطوات في: تحديد الموضوع الرئيسي الذي سيتم التركيز عليه، وتصور الهدف منه، ومن ثم وضع فرضيات معينة والانطلاق منها في عملية التنقيب عن مصادر المعلومات، مع ضرورة وجود رؤية مهنية حاكمة، ومعرفة القيم الأساسية التي ينبغي على الصحافي الالتزام بها في العمل(37).
بطبيعة الحال، ليست كل طرق البحث العلمي صالحة للتطبيق في التحقيقات الصحفية الاستقصائية، ولكن تتم الاستعانة بالعديد من الأدوات البحثية عندما يكون العمل على موضوع استقصائي معمق. ويشير بعض الأكاديميين في سياق تحسيس طلابهم بأهمية الوعي بطرق البحث العلمي إلى أن "هذه الأدوات تساعد على أن يكون الصحافي أمهر وأصدق؛ إذ تتعزَّز مصداقية الصحافي بمجرد تفكيره باستخدام أداة علمية للوصول إلى معلومة. وعندما يتمكَّن من فهم كيفية استخدام تلك الأداة يكون قادرًا، عمليًّا، على الوصول إلى منتوج صحفي أهم وأدق وأعمق. وهذا الأمر ينسحب، أيضًا، على ضرورة تعلم النظريات العلمية (الإعلامية)، لكونها كفيلة بمساعدة الصحافي على فهم الواقع والموضوع الذي يعمل عليه"(38).
من المهم الإشارة، في هذا السياق، خاصة بعد سنة 2000، إلى نشوء "مدارس صحفية" تأسست على ما يمكن وصفه بـ"الابتكار المنهجي للقصة الصحفية" (مثار التقصي)، والتي تقوم على قاعدة أساسية تقول: إن المهمة المركزية في العمل الاستقصائي تكمن في رواية قصة تكون مكتملة الأركان، وتظل في إطار فرضية يتم تطويرها إلى أن يتم إثباتها أو دحضها، بعد جمع معلومات حولها، وتتحوَّل، في المحصلة، إلى حقائق ساطعة لا لُبْس فيها. وتُسمَّى هذه التقنية "التحقيق القائم على فرضية"(39)، والذي يعني أن يضع الصحافي فرضية لقصته ويختبرها ويعمل على إثباتها أو نفيها لكونها معلومات غير مؤكدة. تلتقي أجوبة الصحافيين، الذين قابلتهم الباحثة، على أن أفضل التحقيقات هي تلك التي تستند إلى فرضية جيدة، معتبرين أن هذه الفرضية أهم وسيلة ذهنية وتنظيمية بالنسبة للصحافي، وتُعد بمنزلة "دستور التحقيق الاستقصائي وجوهره".
وتُمثِّل أيضًا هدف الإنتاج الصحفي الاستقصائي، ولها الدور الأساسي في قيادة عملية سرد قصة واحدة مكتملة الأجزاء، أو سرد مجموعة قصص متشابهة، أو على الأقل تقديم معلومات متماسكة حول موضوع التحقيق(40). في هذا الوقت، وعلى خلفية التشابه بين التحقيق الاستقصائي والبحث العلمي في مفهومه وأدواته، يستصعب العديد من الصحافيين، بمَنْ فيهم صحافيون ذوو خبرة، صياغة فرضية لتحقيقهم. من هنا، تتولَّد الحاجة الماسَّة لدى الصحافي الاستقصائي لتعلمه كيفية تطبيق منهجية التحقيق القائم على فرضية، والتأكد من أن قصته مبنية على وقائع ومصادر موثوقة تُمكِّنه من بناء قاعدة بيانات وفق احتياجات تحقيقه. وعليه، يؤكد المنظِّرون للصحافة الاستقصائية أن فرضية التحقيق هي مقترَح يُشخِّص مشكلة أو قضية مطروحة للتقصي والبحث والتوثيق بهدف الوصول إلى حقيقة ما حصل، وذلك عبر خلق علاقات بين الحقائق (والتي نُسمِّيها أركان الفرضية أو محددات الاستقصاء الأساسية).
ويُعد طرحُ الفرضية خطوة أساسية، حتى لو لم تكن تلك الحقائق مؤكدة تمامًا؛ إذ تجيب، بشكل مؤقت، على الروابط فيما بين: الفعل (القضية أو الحدث) والفاعل (المسؤول أو المتسبب) والمفعول به (الضحايا أو المتضررون)، وحجم المشكلة وتأثيرها. وكما في البحث العلمي كذلك في التحقيق الاستقصائي، قد تسقط الفرضية أو تتغيَّر، لذا كانت هناك ضرورة للالتزام ببضع القواعد لوضع الفرضية واختبارها(41)، لكي لا تخرج عن هدفها وتضيع الغاية الأساسية من التحقيق الاستقصائي. ومن هذه القواعد، على سبيل المثال: عدم استسهال كتابة الفرضية، وعدم وضعها بطريقة عشوائية، والابتعاد عن الطروحات الفضفاضة، وتحديد زاوية معينة وواضحة لها، ووجوب أن تكون قصيرة (نحو سطرين أو ثلاثة أسطر كحد أقصى)، وفصل مصطلحات الفرضية، والوصول إلى الأسئلة التي يُولِّدها كل مصطلح(42).
لا ينتهي استخدام الصحافي الاستقصائي لأدوات البحث العلمي عند طرحه الفرضية، بل يحتاج إلى التفكير المنهجي عبر توليد عدد من الأسئلة البحثية، ومن ثم تحديد وحشد مصادر المعلومات التي تُتيح له الوصول إلى إجابات على هذه الأسئلة قبل الشروع في العمل الاستقصائي ومعرفة المخاطر المتوقعة (قبل وأثناء وبعد الإعداد والنشر). "تقع الأسئلة المطروحة، إزاء الحقائق والمصادر والآراء والتحليلات والخلفية والعقبات المحتملة، ضمن ثلاثة نطاقات هي: 1- ما يريد الصحافي أن يعرفه (من التقصي في هذا الموضوع أو ذاك). 2- ما يحتاج أن يعرفه. 3- ما يجب أن يعرفه(43). ومن المفترض أن يحصل الصحافي على إجابات لهذه الأسئلة من شبكة واسعة من المصادر البشرية والمادية والرقمية، والتي يُنْظَر إليها كـ"عصب التحقيق الاستقصائي"؛ لأنها البوابة التي يَعْبُر منها الصحافي إلى الحقائق والخلفية والسياق. ماذا عن هذه المصادر؟
تختلف مصادر الصحافة الاستقصائية، بعض الشيء، عن المصادر التقليدية المعروفة، المُعلَن منها أو السري، ويُقسِّمها أصحاب الاختصاص تبعًا لـ: نوعها، وعلاقتها بالموضوع الصحفي الاستقصائي، وإمكانية الوصول إليها والحصول منها على المعلومات، وطبيعة المعلومات المراد الحصول عليها من جانب الصحافي، وإمكانية التحقق من مصداقيتها، ونورد أهمها -كما يظهر في الجدول رقم (4)- عن مصادر الصحافة الاستقصائية(44).
جدول (4): مصادر الصحافة الاستقصائية
|
نوع المصدر |
أنماط المصدر |
|
المصادر الرئيسية والثانوية |
- أبطال القصة الفعليون، المشاركون في الأحداث، المصادر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، الوثائق، سجلات المحاكم..إلخ. |
|
المصادر الشفوية والمكتوبة والمرئية والمسموعة |
- الضحايا، الشهود العيان، الخبراء... البيانات، الكتب، الصحف، السجلات الرسمية، تقارير الشرطة، الوثائق التجارية، العقود، المعاملات المصرفية... الصور، مقاطع الفيديو، التسجيلات الصوتية، كل ما له علاقة بالنشر الرقمي..إلخ. |
|
المصادر ذات التجربة والمصالح والخبرة |
- وهي المصادر التي تكون، عادةً، على اطلاع مباشر على الموضوع الذي يتم التحري عنه، أو تلك التي تمتلك مصلحة مباشرة فيه، أو يمكن لها أن تتحدث عن مشاعرها وتجربتها الشخصية وتُقدِّم الجانب الإنساني في الموضوع (مثار التقصي)..إلخ. |
|
المصادر المُجَهَّلَة
|
- تُعتبر حاجة أساسية في العمل الصحفي الاستقصائي، فهي تشبه العين السرية التي ترى ما وراء الأشياء وتُقدِّم للصحافي تفسيرًا مختلفًا ومعلومات يُشكِّل الكشف عنها خطرًا على صاحبها. |
|
المصادر المفتوحة |
- تُمثِّل مصادر المعلومات المتاحة للعموم (وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع الذكاء الاصطناعي، المنصات التي تعود لمصادر أو جهات معروفة وموثوقة، الكتب والدراسات والمدونات المتخصصة..إلخ)(45). |
وهناك تقنيات تُسْتَخدَم في البحث العلمي ويلجأ إليها الصحافي الاستقصائي في تحقيقاته، أبرزها كما يوضح الجدول رقم (5).
جدول (5): الأدوات البحثية الاستقصائية
|
الأداة |
وظيفتها |
|
التوثيق |
- وتعني قيام الصحافي بالسعي للحصول على الوثائق، ولاسيما تلك المحجوبة والمحاطة بالسرية. |
|
الملاحظة |
- تعني مراقبة الصحافي عن بُعد لسلوك عينة التحقيق من خلال تصرفاتهم، وقيامه بتسجيل ملاحظاته على أساس نتائج هذه المراقبة وجمع المعلومات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لموضوعه. |
|
المقابلة |
- حوار يجريه الصحافي مع عينة التحقيق بهدف التوصل إلى النتائج المرغوبة، وقد تكون الإجابات مفتوحة أو مقيدة أو مختلطة (أي يجيب المبحوث على الأسئلة بحرية، مع إمكانية مقاطعة الباحث له عند حصوله على الإجابة التي يبحث عنها). |
|
الاستبيان |
- طريقة رخيصة وسريعة، نسبيًّا، للحصول على كميات كبيرة من المعلومات من عينة واسعة من الأشخاص، ولقياس سلوك هؤلاء ومواقفهم وتفضيلاتهم وآرائهم ونواياهم، ويمكن إجراء الاستبيان وجهًا لوجه أو عبر الهاتف أو الكمبيوتر أو البريد. |
|
مجموعات التركيز |
- أداة بحث تجمع مجموعة صغيرة من الأشخاص، بناء على سمات ديمغرافية محددة مسبقًا، للإجابة على الأسئلة في بيئة خاضعة للإشراف وتقديم ملاحظات أكثر دقة من المقابلات الفردية. |
|
الاختبارات (تُسْتَخدَم خاصة في التحقيقات العلمية) |
- هي مجموعة من الأسئلة التي تُعَدُّ مسبقًا من قِبَل الصحافي لتُطرَح على مستجوَبين محددين لاختبارهم من خلالها (قد تكون الاختبارات شفهية، أو كتابية، أو رسومات وصور، أو أي مادة أخرى تساعد في الوصول إلى المعلومات أو البيانات المطلوبة). |
5. البحث العلمي وتعزيز قواعد الصحافة الاستقصائية
مع دخول دُفعات من الباحثين إلى الأوساط الصحفية حصل تداخل في الوظائف والأشكال والمضامين بين ما هو "صحفي" وما هو "بحثي". وأثار هذا الأمر، في آنٍ معًا، الالتباس لدى الجمهور المتلقي ورواد الصحافة والبحث العلمي. التباسٌ بين ما يُعَد قيمًا صحفية يجب توظيفها في كتابة التقارير والتحقيقات، وما يُسمَّى إجراءات منهجية يتحتم اعتمادها في كتابة الأوراق والنشرات الأكاديمية البحثية. ولابد من توضيح مسألة مركزية، على هذا الصعيد، وهي أن كل طرق ممارسة الاستقصاء في الصحافة إنما تنبع من المسار التقليدي لكتابة التقارير الإخبارية، ولكن مع وجود فروق أساسية تظهر في:
أ- البحث: من حيث الاتجاه عمقًا وعرضًا في جمع المعلومات؛ ما يُحتِّم على الصحافي درجة عالية من التنظيم والإدارة لكمية المادة التي بحوزته (وهذه إحدى أهم المهارات المطلوبة لدى الصحافيين الاستقصائيين).
ب- العلاقات مع المصادر: إذ لا يمكن للصحافي أن يقبل بما يُزوِّده به "مصدر ما" من معلومات (وأيًّا كان هذا المصدر) باعتبارها حقيقة مطلقة؛ لأن أهمية المصدر، بالنسبة للصحافي الاستقصائي، تقوم على أساس صلاحية المعلومات التي يحصل عليها.
ج- النتائج: إن غاية التحقيق الاستقصائي الوصول إلى قاعدة تقول: إن "شيئًا ما" قد حدث، ولم يكن ينبغي له أن يحدث، ولذلك يجب ألا يتكرر مرة ثانية، أو العكس، أي إن "شيئًا ما" يستحق أن يقع، أو إنه أُوقِف عن الحدوث بشكل تعسفي(46).
تعالج أفكار التحقيقات الاستقصائية، لابد من التذكير، زاوية محددة وواضحة وقابلة للإثبات أو النفي، بعد بحث معمق وتوثيق دقيق يقوم به الصحافي مع فريقه. ويتم التوصل لتلك الأفكار، عادةً، من خلال طرق عدة، أهمها: الحدس، والملاحظة الشخصية، والمصادر الشخصية، ووسائل الإعلام والاتصال على أنواعها، والمصادر الحكومية المفتوحة، وتقارير مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، والتسريبات(47). وهناك دائمًا قصص متنوعة متاحة للتحقيق فيها (أكثر مما يمكن إنجازه)، لذا يقع على عاتق الصحافي تقدير أهمية القصة، ومدى استحقاقها للعناء، وما إذا كانت سهلة أو صعبة التنفيذ. هل تحتاج كل القصص الاستقصائية إلى المنهجية العلمية وتقنيات البحث العلمي، وبالقدر نفسه؟
لقد طرحت الباحثة هذا السؤال على الصحافيين والأكاديميين، الذين يُمثِّلون عينة الدراسة، فالتقت أجوبتهم على أن معظم التحقيقات الاستقصائية التي تُنَفَّذ (ولاسيما بعد احتجاجات "الربيع العربي")، صارت تتخطى، في غالبيتها، المواضيع التي نشأت الصحافة الاستقصائية، على أساسها، أي تلك التي تركز على مسائل اجتماعية واقتصادية، مثل البيئة والتعليم والفساد. وبات اهتمام الصحافيين ينصبُّ على القصص المثيرة للجدل، والتي تُنَقِّب في الفضائح وقضايا الفساد السياسي والأمن القومي والجرائم المنظمة. و"تفرض طبيعة هذه المواضيع، خلال عملية الإثبات، اعتماد المنهجية العلمية الدقيقة، ولاسيما في التحقيقات التي تحتوي على درجة خطورة عالية"(48).
وكذلك، فإن القضايا التي "تتطلَّب دقة وتحليلًا معقدًا فهي تحتاج، أكثر من غيرها، إلى منهجية البحث العلمي، مثل التحقيقات التي تقتضي دراسات علمية وتحليل بيانات طبية (عن انتشار الأمراض أو فاعلية اللقاحات) أو بيئية (تأثير التغير المناخي أو التلوث على المجتمعات) أو مالية (الكشف عن أنماط الفساد أو سوء الإدارة)، فضلًا عن تلك التي تستلزم إحصائيات علمية واقتصادية"(49). ويمكن القول، أيضًا: "إن التحقيقات التي تتسم بالجدة ولم يسبق تناولها وتبحث عن العلاقة السببية بين متغيريْن، فهي تحتاج، بشكل أكبر، إلى منهجية بحثية (مثلًا تحقيق يستقصي في علاقة ارتفاع معدل الوفيات بالنوبات القلبية في أوساط الشباب اليمني، باستخدام المنشطات الجنسية، أو يبحث في علاقة نفوق الأسماك على سواحل عدن بعملية تنظيف السفن العملاقة عند الجرف القاري على خليج هذه المدينة)"(50). هل تساعد الأدوات البحثية في تمايز العمل الاستقصائي عن سائر الأعمال الصحفية؟
على الرغم من تعدد التعريفات التي أُعطِيَت للصحافة الاستقصائية غير أن مَنْ يمارسونها يتفقون على بضعة عناصر تختص بها هذه الصحافة، وهي أنها عملٌ مهني عميق، يوظف طُرُقَ بحثٍ منهجية متينة، ويعتمد نظامًا مُحْكَمًا للتحقق، ويستخدم بكثافة السجلات العامة والبيانات، ويركز على العدالة الاجتماعية والمساءلة، وغالبًا ما يفضح أسرارًا. لكن ما يميز الصحافة الاستقصائية، بالتحديد، هو دورها المركزي في ابتكار أساليب عملٍ جديدة تتطابق، إلى حدٍّ بعيد، مع سمات "الصحافة المتخصصة". وتتلخص هذه الأساليب في: التعمق في تغطية جوانب المجال المبحوث فيه، والعناية بجودة المعلومات التي تُقدِّمها ونوعيتها (أكثر من كميتها)، والتركيز على الأُسُس العلمية في كتابتها للمعلومات، واعتمادها على البحث والتحليل المعمقيْن لتفسير مختلف جوانب الموضوع الذي تتم تغطيته(51).
ومعلوم أن "الصحافة المتخصصة" تُشْعِر العاملين فيها بالحاجة إلى امتلاك خلفية نظرية ومعرفية في المواضيع التي يعملون عليها، وإلى اكتساب مهارات لا تتأتى لهم، غالبًا، إلا من خلال الدراسة الأكاديمية؛ إذ يتعلم طالب الصحافة منهجية تصبح جزءًا من تفكيره، ولا يمكنه تطبيقها في المواد الاستقصائية التي يدرسها، فحسب، بل ينسحب الأمر، كذلك، على مواد أخرى يتعلمها (مثلًا في مجالات المقال، النقد، التحليل..إلخ). من هنا، يمكن استنتاج أن الخيارات المنهجية والنظرية وإمكانية استلهامها في العمل الصحفي الاستقصائي ترتبط، إلى حدٍّ بعيد، بمستوى التكوين العلمي للصحافي الاستقصائي، وخبرته الشخصية في التعامل مع مصادر المعرفة.
6. تعليم الصحافة الاستقصائية في العالم العربي
لابد من الإشارة هنا إلى أن الوعي بخطوات البحث العلمي ومناهجه يزيد القصة الصحفية عمقًا بحثيًّا يساعد الصحافي الاستقصائي في تقديم قصته من منظورات مختلفة، سواء أكان ذلك من خلال البحث والتقصي في جذور قصته، أو في تتبُّع أسبابها، أو وصف متغيراتها، أو دراسة ومقارنة علاقاتها الارتباطية بهذه المتغيرات. في عالمنا العربي، تُدَرَّس الصحافة الاستقصائية في كليات الإعلام ومعاهد الصحافة في بعض الدول (في مقدمها العراق ومصر وتونس والإمارات واليمن ولبنان..إلخ)؛ فضلًا عن بعض المعاهد المتخصصة بتقديم دورات تدريبية للإعلاميين، وأخرى للأكاديميين، لتعليمهم أصول هذا النوع الصحفي وقواعده وأخلاقياته، وتزويدهم بكفايات ومهارات يحتاجها مَنْ يمارس العمل الاستقصائي. "هناك 79 جامعة عربية تُدَرِّس الصحافة الاستقصائية ضمن مناهجها وبرامجها الأكاديمية، لكن بعضها لا يُدَرِّسها كاختصاصٍ قائمٍ بذاته، بل كجزءٍ من مساق (الكتابة الصحفية مثلًا أو التحقيق الصحفي أو الفيلم الوثائقي)، وبعضها الآخر يُدَرِّسها كمساقٍ مستقل ضمن اختصاص الصحافة، وتُقدَّم عمومًا مقررًا ضمن المقررات الاختيارية وليس الإلزامية"(52).
تُعتبر الصحافة الاستقصائية "نوعًا صحفيًّا مهمًّا بالنسبة لمجتمعاتنا العربية التي تعاني (أكثر من غيرها من المجتمعات) من ظواهر الفساد وتفاقمها. وبلا شك، تقع مسؤولية العملية التعليمية لهذا النوع الصحفي، بالدرجة الأولى، على عاتق الأساتذة من أصحاب التجربة في هذا المجال"(53)، و"لمراكز التدريب المتخصصة دور كبير في إشاعة مفهوم الصحافة الاستقصائية. لكن، ومهما قدَّمت هذه المراكز من دورات تدريب وملتقيات وندوات في هذا الخصوص، إلا أن جهودها تبقى محدودة. لذا، فإن المسؤولية الأكبر، في تدريس هذا النوع الصحفي، يجب أن تتولاها الجامعات (بمساندة تلك المراكز)، وذلك بهدف إشاعة مفاهيم الصحافة الاستقصائية، وجعلها الخيار الأمثل للصحافة المستقبلية، خاصة بعد الانتشار الهائل للمعلومات المُضَلِّلَة (عبر المنصات الرقمية) وما ينتج عنها من تشويهٍ للحقائق والأحداث"(54).
هناك إشكاليات في تدريس مساق الصحافة الاستقصائية في الدول العربية، ولابد من التوقف عند هذه المعضلة؛ إذ "لا يتجرَّأ معظم الطلبة على إعداد تقارير تتناول مسائل حساسة ذات صلة بالحكومة أو بذوي النفوذ والمصالح وتحمُّل تبعاتها (الاجتماعية والسياسية والقانونية وحتى المالية). لكن يبقى من المهم تدريس هذا النوع الصحفي البالغ الأهمية، ولو من باب العلم بالشيء، لكي لا يندثر من عالم الصحافة والإعلام، وعلى أمل أن يُترجَم، مستقبلًا، إلى واقع يستطيع أن يخدم المجتمع ويحميه"(55).
ويعاني تعليم الصحافة الاستقصائية في العالم العربي من تحديات عدة تتشابه، إلى حدٍّ كبير، مع تلك الموجودة في مختلف البلدان "وتتمثَّل في عدم إمكانية تطبيق ما يتعلمه الطلاب في الميدان (لأسباب عديدة). ولابد من التنويه هنا أن مراكز التدريب المتخصصة ساهمت، بقوة، في تحفيز كليات ومعاهد الإعلام على تغيير وتطوير مناهجها التعليمية وتدريب الأكاديميين (العرب) على كيفية إدخال منهاج الاستقصاء الصحفي في الجامعات العربية"(56).
وفي هذا الإطار، تحاول مراكز التدريب سَدَّ نقاط الضعف، إذا جاز التعبير، في عملية تدريس الصحافة الاستقصائية، من خلال تنظيم دورات تدريبية للأساتذة الذين تنتدبهم جامعاتهم، أحيانًا، ليخضعوا إلى تلك التدريبات. وثمة محاولات لتكوين منصات وشبكات للصحافة الاستقصائية في العالم العربي. وقد كانت البداية في نهاية العام 2005 مع سعي صحافيين عرب لإرساء صحافة استقصائية عربية، فشكَّلوا من أجل ذلك شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)"(57). وتُشير مؤسسة "مهارات" إلى أن تفاعل الصحافيين العرب ووعيهم بأهمية دور الصحافة الاستقصائية في بلدانهم دفع بالعديد منهم إلى إطلاق عدة شبكات استقصائية، منها: شبكة "نيريج" في العراق، و"سراج" في سوريا، و"يمان" في اليمن، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية "ليفيج". أما في لبنان، فقامت مجموعة من الصحافيين بإنشاء موقع "درج"، الذي يُقدِّم، في جزءٍ منه، تحقيقات استقصائية لبنانية وعربية(58). وأخيرًا، يبقى السؤال الإشكالي الذي تصعب الإجابة عليه: هل تأسيس هذه الشبكات يرمي إلى تشجيع عمل صحفي استقصائي في المنطقة العربية، أم أن أهدافه ترتبط بدعم هذا النمط من الصحافة وتمويلها، خدمةً لمشروع الشرق الأوسط الجديد؟
خاتمة واستنتاجات
"الصحافة هي أن تنشر ما لا يُريد أحدهم أن يراه منشورًا، وفيما عدا ذلك، فهي مجرد علاقات عامة". تُشير هذه الجملة المختصرة للصحافي والروائي والناقد البريطاني، جورج أورويل (George Orwell)، إلى جوهر العمل الصحفي الاستقصائي الذي يُنَقِّب فيما وراء الأحداث والوقائع والمواقف التي لا تتكشَّف، غالبًا، للصحافي العادي، ولا يُراد لها أن تظهر للرأي العام. فالصحافة الاستقصائية تُمثِّل فلسفة خاصة في العمل الإعلامي؛ إذ لا تخضع للمعايير التي تقوم على أساسها الصحافة التقليدية، بل وفق أسلوب عمل يستحث، في العاملين فيها، مَلَكَة البحث والتفكير والتحقق والاحتكام إلى المنطق السليم.
ويؤكد الصحافيون الاستقصائيون -أفراد عينة هذه الدراسة- أنهم يقومون بإعداد موادهم بطريقة تختلف، جذريًّا، عن تلك التي ينتهجها الصحافيون العاديون، سواء في طريقة بحثهم وتغطيتهم، أو في شكل العلاقة التي يتعاطون بها مع المصادر، أو في طبيعة القصة الصحفية التي يُنتِجونها، ويُشبِّهونها بـ"الإسمنت" الذي تلتصق به كل خطوة من خطوات العملية الاستقصائية. لذا، يحتاج الصحافي الاستقصائي في إعداد "قصته"، إلى رسم خطة عملٍ واضحة وبناءٍ منهجي يتضمن عددًا من الإجراءات التي يتطلبها، عادةً، عمل الباحثين العلميين؛ إذ يمكن القول: إن الصحافي الاستقصائي يعتمد في عمله، وإلى حدٍّ كبير، على العُدَّة المنهجية التي تُوفِّرها مناهج البحث العلمي للتقصي في المشكلة البحثية لقصته وفي أبعادها من خلال خطوات منظمة ومنسقة تُمكِّنه من الوصول إلى النتائج المتوخاة. وهذه الخطوات تُلَخَّص في: وضع الخطة البحثية، ومعرفة المكان الذي يجب التقصي فيه، وخريطة المصادر المؤكدة والمحتملــة، وتحديـد دقيق للمنهج الذي يُحَلِّل ويُفَسِّر الترابطات بين مختلف الأطراف المتدخلة في القضية مدار البحث، والجدول الزمني لإنجاز المادة، فضلًا عن الميزانية المتوقعة للعمل. ونورد، فيما يلي، أبرز ما خلصت إليه الدراسة من استنتاجات:
- هناك خلط ملحوظ بين مفهوم الصحافة الميدانية الجريئة ومفهوم الصحافة الاستقصائية، والتي تتشابه معايير العمل فيها مع المعايير العامة للصحافة، لكن ممارستها تختلف، على كل المستويات، عن تلك المُتَّبَعة في سائر الأنواع الصحفية.
- أبرز ما يميز العمل الصحفي الاستقصائي هو "حاجته العضوية" لاستخدام أدواتٍ بحثية ومنطلقاتٍ منهجية للعمل، أهمها، على الإطلاق، الفرضيات التي تُساعد في تأطير البحث والاسترشاد به أثناء الاستقصاء.
- لا يُقصَد بالبحث العلمي المُعْتَمَد في التحقيقات الاستقصائية النشاط المتخصص الذي يُمارسه العلماء في مجالٍ علمي معين ضمن تخصصٍ معين، بل، نعني به الأسلوب الذي يستطيع أن يُوجِّه الصحافي لحلِّ مشاكل وقضايا يواجهها الجمهور في مجالاتٍ متعددة.
- ليست كل مناهج البحث العلمي صالحة للتطبيق في التحقيقات الاستقصائية.
- هناك مواضيع تحتاج أكثر من غيرها إلى المنهج العلمي، ولاسيما تلك التي تمتد على فترة زمنية وتستدعي عملية بحث طويل، أو المواضيع التي تتضمن الكثير من المعلومات والجداول وتتطلب تفكيكًا وتحليلًا، أو التي يتداخل فيها أكثر من اختصاص (بيئي + صحي + اقتصادي..إلخ).
صحيح أن التشابه كبير جدًّا بين التحقيق الاستقصائي والبحث العلمي، لكن لا تجوز المبالغة والذهاب بعيدًا في تقدير التماهي الحاصل بين المجالين. فالتحقيق الاستقصائي هو، في النهاية، "منتوج" يستجيب لمقتضيات العمل الصحفي، وليس بحثًا علميًّا صرفًا، لكنه يمتاز، عن سائر الأعمال الصحفية، بقدرته على ابتكار أساليب عمل جديدة تتطابق، إلى حدٍّ بعيد، مع أساليب عمل "الصحافة المتخصصة". ونعني بها تلك الصحافة التي تدفع بالعاملين فيها إلى تحسُّس الحاجة إلى امتلاك خلفية نظرية ومعرفية في المواضيع التي يشتغلون عليها، إضافة إلى كفايات ومهارات ترفع من قيمة وجودة العمل الصحفي، خاصة، ومن مكانة ومصداقية المهنة، عامة.
نُشِرت هذه الدراسة في العدد السادس من مجلة الجزيرة لدراسات الاتصال والإعلام، للاطلاع على العدد كاملًا (اضغط هنا)
(1) مجموعة مؤلفين، التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد، تحرير صالح مشارقة (رام الله- فلسطين، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ومركز تطوير الإعلام، جامعة بيرزيت، 2021)، ص 12.
(2) منال قدواح، "استخدام مناهج البحث العلمي في الصحافة الاستقصائية"، مجلة دراسات (جامعة صالح بوبنيدر- قسنطينة 3، الجزائر، المجلد 11، العدد 1، 2022)، ص 830.
(3) Daniel Cornu, Journalisme et vérité, (Genève: Labor et Fides, 2009), 84.
(4) في كتابه المعنون بـ"ديكتاتورية العاجل"، يعرض الباحث والسياسي الفرنسي جيل فينشيلستاين (Gilles Finchelstein) لما يصفه بعبادة السرعة واللحظة التي تطغى على جميع جوانب حياتنا الشخصية والعامة (صحتنا وطعامنا وأنشطتنا الترفيهية وحياتنا المهنية... إلخ). ويرى الكاتب أن من أبرز انعكاسات التطور التكنولوجي والاتصالي المتسارع على العمل الإعلامي التقليدي الفتك بالزمن الإعلامي ونفي الأزمنة وتسلسلها، فضلًا عن تكريس الزمن اللحظوي المنغلق في المباشر. وقد تأثرت وسائل الإعلام ووسائطه المختلفة بالعلاقة الجديدة مع الزمن وغدا انعكاسًا لتسريع نمط مجتمعاتنا وبات وكأنه معلَّق بين عدميْن: المستقبل المقلق غير المُفَكَّر فيه، والماضي المُحْتَقَر غير المعترف فيه. للاستزادة، انظر:
- Gilles Finchelstein, La dictature de l’urgence, (Paris : Librairie Arthème Fayard, 2011).
(5) Jean-Marie Charon, "Le journalisme d'investigation et la recherche d'une nouvelle légitimité," Hermès, La Revue, No. 35, (2003/1): 138.
(6) مقابلة أجرتها الباحثة مع محمد المامي، صحافي استقصائي مستقل (يعمل مع أكثر من مؤسسة إعلامية)، موريتانيا، 18 سبتمبر/أيلول 2024.
(7) مقابلة أجرتها الباحثة مع ليال بو موسى، صحافية استقصائية في تليفزيون "الجديد"، لبنان، 12 سبتمبر/أيلول 2024.
(8) Gilles Labarthe, "Des journalistes d’investigation face au 5e pouvoir," Sur le journalisme, Vol. 7, No. 2, (2018): 111.
(9) Alex Mucchielli, Étude des communications : Nouvelles approches, 3e éd. (Paris: Armand Colin, 2006), 38.
(10) الصحافيون هم: محمد المامي، صحافي استقصائي مستقل (يعمل مع أكثر من مؤسسة إعلامية)، موريتانيا. وليال بو موسى، صحافية استقصائية في تليفزيون "الجديد"، لبنان. وحيدر عبد الكريم، صحافي استقصائي مستقل، السودان. ورياض قبيسي، رئيس وحدة الصحافة الاستقصائية في تليفزيون "الجديد"، لبنان. وسمية اليعقوبي، باحثة وصحافية استقصائية مستقلة، عُمان. وصفاء الرمحي، صحافية استقصائية في "أريج"، الأردن. وبهيجة بلمبروك، صحافية استقصائية ورئيسة تحرير في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تونس. وعبد الله أبو ضيف، صحافي استقصائي في جريدة "المصري اليوم"، مصر. وجمال حيدرة، صحافي استقصائي ورئيس منصة "الفانوس" الإعلامية (المستقلة)، اليمن. وفرح جلاد، صحافية استقصائية في شبكة "أريج"، الأردن.
(11) الأساتذة هم: سليمان البصومعي، أستاذ في قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وماريا بو زيد، عميدة كلية الإنسانيات في جامعة سيدة اللويزة، لبنان. ومحمود خلوف، أستاذ الإعلام الرقمي وعلوم الاتصال في الجامعة العربية الأميركية في جنين، فلسطين. وحنان زبيس، أستاذة الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في منوبة، تونس. ودنيا جريج، أستاذة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، لبنان. ومهى زراقط، أستاذة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، لبنان. وزاهرة حرب، أستاذة الإعلام في جامعة سيتي، بريطانيا. وسعيد شاهين، رئيس قسم الإعلام في جامعة الخليل، الضفة الغربية- فلسطين. وسحر خليفة سالم، أستاذة في قسم الصحافة في كلية الإعلام في الجامعة العراقية، العراق. وفريد أبو ظهير، أستاذ في قسم الاتصال والإعلام الرقمي في جامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين.
(12) عبد الحليم حمود، الصحافة الاستقصائية: الفضيحة الكاملة) بيروت، مركز الدراسات والترجمة، 2010)، ص 129.
(13) تعبير للصحافي الاستقصائي وعضو مجلس إدارة "أريج"، يسري فودة، في تقديمه لدليل: على درب الحقيقة: دليل "أريج" للصحافة الاستقصائية العربية، تحرير: مارك هنتر وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، ط 3 )باريس، اليونسكو، 2017)، ص 8.
(14) مصطفى ثابت، "الصحافة الاستقصائية وتحدياتها في العالم العربي"، مجلة الإعلام والمجتمع (جامعة قاصدي مرباح ورقلة- الجزائر، المجلد 6، العدد 1، 2022)، ص 137.
(15) مقابلة أجرتها الباحثة مع حيدر عبد الكريم، صحافي استقصائي مستقل، السودان، 19 سبتمبر/أيلول 2024.
(16) نقلًا عن علياء علي، "الصحافة الاستقصائية أفضل وسيلة للوصول إلى قلب الحقيقة"، الوسط، 8 مارس/آذار 2010، (تاريخ الدخول: 1 فبراير/شباط 2025)، https://tinyurl.com/2w282v3n.
(17) مقابلة أجرتها الباحثة مع رياض قبيسي، رئيس وحدة الصحافة الاستقصائية في تليفزيون "الجديد"، لبنان، 20 سبتمبر/أيلول 2024.
(18) مقابلة أجرتها الباحثة مع سمية اليعقوبي، باحثة وصحافية استقصائية مستقلة، عُمان، 21 سبتمبر/أيلول 2024.
(19) هنتر وآخرون، على درب الحقيقة: دليل "أريج" للصحافة الاستقصائية العربية، مرجع سابق، ص 19.
(20) حسين علي إبراهيم الفلاحي، صحافة التحري والاستقصاء: التحقيقات الصحفية الاستقصائية (الإمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 2017)، ص 123.
(21) مجموعة مؤلفين، الصحافة الاستقصائية: الواقع والتحديات (عمان، ألفا للوثائق، 2021)، ص 243.
(22) Alain Laramée, Bernard Vallée, La recherche en communication: Éléments de méthodologie, (Québec: Presses de l'Université du Québec, 2014), 77.
(23) محمد سرحان علي المحمودي، مناهج البحث العلمي، ط 3 (صنعاء، دار الكتب، 2019)، ص 35-50.
(24) عادل جربوعة، "خطوات البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال"، مجلة الإعلام والمجتمع (جامعة قسنطينة 3- الجزائر، العدد 2، 2017)، ص 84.
(25) حسن زين الدين، منهجية البحث العلمي للإعلاميين (بيروت، مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي، 2015)، ص 64-65.
(26) مقابلة أجرتها الباحثة مع سليمان البصومعي، أستاذ في قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 سبتمبر/أيلول 2024.
(27) مقابلة أجرتها الباحثة مع ماريا بو زيد، عميدة كلية الإنسانيات في جامعة سيدة اللويزة، لبنان، 11 سبتمبر/أيلول 2024.
(28) مقابلة أجرتها الباحثة مع محمود خلوف، أستاذ الإعلام الرقمي وعلوم الاتصال بالجامعة العربية الأميركية في جنين، فلسطين، 15 سبتمبر/أيلول 2024.
(29) مقابلة أجرتها الباحثة مع حنان زبيس، أستاذة الإعلام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في منوبة، تونس، 16 سبتمبر/أيلول 2024.
(30) مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتورة دنيا جريج، أستاذة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، لبنان، 20 سبتمبر/ أيلول 2024.
(31) مقابلة أجرتها الباحثة مع مهى زراقط، أستاذة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، لبنان، 9 سبتمبر/أيلول 2024.
(32) لقد كان لافتًا، أثناء تكوين عينة الدراسة، أن معظم الصحافيين الذين قابلتهم الباحثة حرصوا على التأكيد أنهم يُعِدُّون تحقيقاتهم الاستقصائية بصفتهم "صحافيين مستقلين". وهنا لابد من الإشارة إلى أن المؤسسات الإعلامية العربية لا تشجع كثيرًا العمل الاستقصائي، ولا تخصص، بالتالي، قسمًا للعاملين في صحافة الاستقصاء، بل جل ما يُنَفَّذ إنما يتم بمبادرات فردية.
(33) عزام أبو الحمام، المنهج العلمي في الصحافة الاستقصائية (عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2014)، ص 95.
(34) Manuel de guide pratique sur le journalisme d’investigation, (Paris: ISFJ, 2024), 5-7.
(35) Philip Meyer, Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods, 4 th ed. (Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 2022), 11-12.
(36) محمود علم الدين وآخرون، ضوابط التحقيقات الصحفية الأمنية: التحقيق الصحفي كشكل من أشكال التغطية الصحفية التفسيرية والاستقصائية، ط1 (الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2010)، ص 74-79.
(37) إيناس أبو يوسف وآخرون، دليل صحافة استقصائية من أجل التنمية (مصر، مؤسسة فريدريش إيبرت- مكتب القاهرة، 2016)، ص 47.
(38) مقابلة أجرتها الباحثة مع زاهرة حرب، أستاذة الإعلام في جامعة سيتي، بريطانيا، 14 سبتمبر/أيلول 2024.
(39) هنتر وآخرون، على درب الحقيقة: دليل "أريج" للصحافة الاستقصائية العربية، مرجع سابق، ص 11-12.
(40) إياد الداود، فن التقصي: الفيلم الوثائقي التحقيقي (الدوحة، معهد الجزيرة للإعلام، 2019)، ص 19.
(41) هناك عشرة طرق لإثبات الفرضية، أبرزها: تقاطع المصادر والشهادات ذات الصلة بموضوع الاستقصاء، وبناء قواعد البيانات وتحليلها مع التأكد من صحتها، والمسوحات الميدانية التي توفر أدوات القياس، والتجربة الشخصية للصحافي، والتحليل المخبري (في حال كان الموضوع يتطلب الدفع بعينات إلى مخابر متخصصة ومرخصة وموثوقة)، والخبرة الفنية التي تُسْتَخدَم في فحص الوثائق أو مضاهاة التوقيع، والتخفي وعدم كشف الهوية الصحفية، وحشد المصادر وجمع البيانات من خلال الاستعانة بالجمهور عبر توجيه سؤال مباشر له عبر موقع إلكتروني أو مواقع التواصل. للاستزادة، انظر: أحمد شوقي العطار، "10 طرق لإثبات فرضية التحقيق الاستقصائي"، شبكة الصحفيين الدوليين، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، (تاريخ الدخول: 1 فبراير/شباط 2025)، https://tinyurl.com/3jrh485p.
(42) دخلت في الفترة الأخيرة منهجية جديدة إلى عالم الابتكار، لا تتناولها الدراسات الأكاديمية الحديثة، تُعرَف بطريقة الـ"هاكثون" (Hackathon)، وتُعد وسيلة تشاركية تُسْتَخدَم في المشاريع التي تتطلب تعاونًا مكثفًا وإنتاجًا سريعًا؛ وذلك بهدف تشجيع حلِّ المشكلات وتقديم ابتكارات لتسريع الاختبار والتجربة والنماذج الأولية، كل ذلك مقابل جائزة مجزية وبحضور لجنة تحكيم. هناك محاولات لإدخال منهجية الهاكثون على خط إنتاج التحقيقات الاستقصائية، وتقوم الصحافية الاستقصائية الأردنية، صفاء الرمحي، بإجراء بحث حول تقييم مدى فعالية طريقة الهاكثون في التغلب على تحديات هذا النوع من التحقيقات، وكيفية انعكاسه على سرعة إنجاز القصة الاستقصائية وطريقة عرضها بعيدًا عن أي هفوة تخصصية. ويأتي هذا البحث، في إطار رسالة ماجستير تُعِدُّها الرمحي في "جامعة الشرق الأوسط" في الأردن، وهي بعنوان "استخدام منهجية الهاكثون في إنتاج التحقيقات الاستقصائية: دراسة تأصيلية" (مقابلة أجرتها الباحثة مع صفاء الرمحي، الصحافية الاستقصائية في "أريج"، الأردن، 6 سبتمبر/ أيلول 2024).
(43) مقابلة مع قبيسي، مرجع سابق.
(44) وفاء أبو شقرا، عندما تتكلم المصادر: الصحافيون ومصادر معلوماتهم (بيروت، دار الفارابي، 2018)، ص 36-40.
(45) خلال السنوات القليلة الماضية، نشأ مفهوم "التحقيقات المفتوحة المصادر" (Open Sources Intelligence)أو ما يُسمى "أوسينت" (OSINT)؛ إذ يلجأ الصحافي أو فريق من الصحافيين إلى تحليل بيانات وخرائط وفيديوهات وربطها وتحليلها، ودعمها لاحقًا بشهادات الشهود وما يمكن الحصول عليه من وثائق ومرفقات تؤكد فرضية التحقيقات وصحة المعلومات التي يجري البحث فيها.
(46) مارك هنتر ولوك سينجيرز، الصحافة الاستقصائية الحديثة، (الأردن، أريج ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، 2015)، ص 17-18.
(47) "دليل الصحافة الاستقصائية"، (الدوحة، معهد الجزيرة للإعلام، 2020)، ص 12-15.
(48) مقابلة أجرتها الباحثة مع بهيجة بلمبروك، صحافية استقصائية ورئيسة تحرير في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تونس، 30 سبتمبر/أيلول 2024.
(49) مقابلة أجرتها الباحثة مع عبد الله أبو ضيف، صحافي استقصائي في جريدة "المصري اليوم"، مصر، 22 سبتمبر/أيلول 2024.
(50) مقابلة أجرتها الباحثة مع جمال حيدرة، صحافي استقصائي ورئيس منصة "الفانوس" الإعلامية (المستقلة)، اليمن، 25 سبتمبر/أيلول 2024.
(51) Henri Assogba (sous la direction de), Journalismes spécialisés à l’ère numérique, (Laval- France: Presses de l'Université Laval, 2020), 13-14.
(52) مقابلة أجرتها الباحثة مع فرح جلاد، صحافية استقصائية في شبكة "أريج"، الأردن، 7 سبتمبر/أيلول 2024.
(53) مقابلة أجرتها الباحثة مع سعيد شاهين، رئيس قسم الإعلام في جامعة الخليل بالضفة الغربية- فلسطين، 14 سبتمبر/أيلول 2024.
(54) مقابلة أجرتها الباحثة مع سحر خليفة سالم، أستاذة بقسم الصحافة في كلية الإعلام بالجامعة العراقية، العراق، 21 سبتمبر/أيلول 2024.
(55) مقابلة أجرتها الباحثة مع فريد أبو ظهير، أستاذ في قسم الاتصال والإعلام الرقمي بجامعة النجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، 26 سبتمبر/أيلول 2024.
(56) مقابلة مع جريج، مرجع سابق.
(57) دربت شبكة "أريج" 15860 شخصًا في ورش عمل حضورية أو عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة بين عام 2021 وشهر أغسطس/آب من عام 2024، وأنتجت 177 تحقيقًا استقصائيًّا بثت ونشرت عددًا كبيرًا منها على فضائيات محلية وعربية ودولية، كما أسهمت في تأسيس وحدات استقصاء في وسائل إعلام عربية عديدة.
(58) "شبكات الصحافة الاستقصائية في العالم العربي.. وحدة التحديات"، مهارات ماغازين، 16 سبتمبر/أيلول 2020، (تاريخ الدخول: 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، https://n9.cl/7bkw7.
