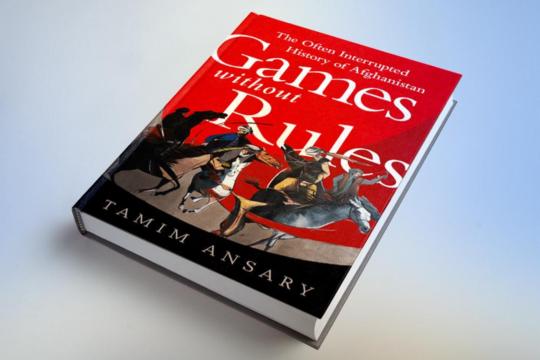
 |
رغم أن نسيج هذا الكتاب - العاب بدون قواعد: التاريخ غير المتواصل لأفغانستان- يُحاك بدرجة أو بأخرى من خلال السرد التاريخي إلا أن الهدف الرئيسي له يتجاوز عبء التاريخ بحثًا عن الأسباب التي أدت إلى فشل أفغانستان في الخروج من حالة التخلف الجاثمة عليها منذ قرون طويلة من الزمن والارتقاء بها إلى مصاف الدول الحديثة المتقدمة. وتدور فكرة الكتاب حول الوضعية التي تواجه الدول الإسلامية بعامة والدول العربية بخاصة والتي تتعلق بالصراع التاريخي بين ما يُطلق عليه الأصالة والمعاصرة؛ التقليد والتحديث.
كيف تستطيع الدول الإسلامية والعربية الخروج من حالة التخلف الجاثمة عليها والجمع بين متطلبات التحديث الكونية وتجذّر القيم والأعراف المحلية؟ وهو السؤال نفسه الذي ينطبق على الحالة الأفغانية بامتياز، ويمثل جوهر هذا الكتاب المؤلّف بواسطة أميركي من أصل أفغاني ما زال يحمل ذكريات العيش في بلده البسيط الذي غادره بعد مرحلة الدراسة الثانوية.
الوطنية الأفغانية
يقدم الكتاب قصة كاملة لأفغانستان منذ ظهور أحمد شاه بابا عام 1747 بوصفه أول من حاول البدء في إيجاد صيغة توحيدية لهذا البلد. وبهذا المعنى فإن الكتاب يختلف عن غيره من الكتب التي تمثل مدخلاً لجانب معين من أفغانستان دون غيره، مثل ما يقوم به المراسلون الصحفيون المصاحبون لحملات دولهم على أفغانستان في أعقاب الحرب على الإرهاب، ككتاب المراسل الكندي موري بروستر، الحرب الهمجية: المعارك غير المروية في أفغانستان(1)، ومثلما بيّن الدبلوماسي الكندي كريس ألكسندر في كتابه، الطريق الطويل الخلفي: حاجة أفغانستان للسلام(2)، والدور الباكستاني في منطقة القبائل المرتبط بدعم العمليات الانتحارية التي تتم في أفغانستان بما يساعد على تصاعد تهديدات الأمن الأفغاني، وزيادة حدة الاضطرابات في هذه الدولة.
وفي ضوء ذلك يقدم كتاب أنصاري تحليلاً تاريخيًا سياسيًا وثقافيًا عميقًا لأفغانستان حيث يتميز بأنه مكتوب بواسطة شخص نصفه أفغاني، أو لنقل: كله أفغاني، لكنه مفعم بالحضارة الغربية ومقيم بين جنباتها وملم بطرائقها التحليلية والموضوعية. وهو ما يجعله يقدم كتابًا لا يقف فقط عند كليشيهات السياسة وأحداثها الغامرة بقدر ما يربط تلك الأحداث والتبعات المرتبطة بها ببنية المجتمع الأفغاني الثقافية والتحولات المختلفة المرتبطة بها عبر مسيرات طويلة من القطع الاستعماري. وكأن الكتاب يحدد منذ البداية بوصلته القائلة: "لا تقفوا عند السياسة فقط، وانظروا بعمق لثقافة شعب يريد أن يؤسس ماهيته واستمراريته بدون قطع خارجي وبدون توجيه من أحد". وهنا ينجح الكتاب بدرجة كبيرة في تعريفنا بهذا المجتمع الصغير والغامض في الوقت نفسه، والذي لا نعرف عنه سوى ارتباطه بحركة طالبان وتنظيم القاعدة، ومن ثم الدعاية الغربية حول "الإرهاب الإسلامي المعاصر".
يبدأ الكتاب سرده التاريخي من خلال التأكيد على الدور الذي لعبه مؤسس أفغانستان الحديثة أحمد شاه بابا، والذي يُطلق عليه والد أفغانستان، عام 1747، وهو التاريخ نفسه تقريبًا الخاص بنشأة الولايات المتحدة الأميركية، مع بُعد المسافة فيما بينهما على مستوى التحديث والتقدم. ويتعانق هذا السرد مع تواريخ الدول المحيطة بأفغانستان والملاصقة لها، مثل الهند وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى بما يؤكد أن عمليات القطع المتواصلة لا تنفصل عن تواريخ هذه البلدان المحيطة بأفغانستان الجغرافيا وبأفغانستان التاريخ. فمن مفارقات القدر بالنسبة لأفغانستان أنها دائمًا دولة منسية عبر التاريخ، لكن موقعها الجغرافي الخطير غالبًا ما يجعلها موقعًا للأحداث وتلاقي الصراعات الدولية المختلفة من فترة لأخرى، ولقد ظهر ذلك بشكل جلي وواضح أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وما أعقبها من سياسات بوش المتمثلة في الحرب على الإرهاب وما تبعه من غزو أفغانستان.
لقد بدأت القبائل البشتونية المختلفة، وهي التي تمثل النسبة الأكبر من سكان أفغانستان، الوعي بضرورة التوحد تحت مظلة الدولة الحديثة منتصف القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه، فقد ظل هناك نوع من الخوف والقلق تجاه الأوروبيين، وبشكل خاص البريطانيين والروس منهم. وهو قلق مشروع ظهرت توابعه من خلال التدخل البريطاني في أفغانستان وما تلاه من تدخل سوفيتي فيما بعد.
ومن المفارقات الغريبة في هذه الدولة أنها لم تكتسب ذلك الشعور الوطني الخاص بماهية الدولة وإدراكها لحدودها الجغرافية والوطنية إلا من خلال حالات القطع الاستعماري المختلفة التي كانت تسرّع من وتيرة الشعور الوطني. ولا يعني ذلك أن الأفغان كانوا فاقدين وطنيتهم وشعورهم بأراضيهم وطبيعة الانتماءات الخاصة بهم، بقدر ما يعني أنهم كانوا يُحيون بشكل طبيعي مثل هذه التوجهات والمشاعر، التي لعبت القوى الدولية الاستعمارية دورًا كبيرًا في العمل على بلورتها بشكل يتناسب مع أطر العصور الحديثة. فالغزو الخارجي جعل الأفغان يعون ما لهم من أرض وحدود وجغرافيا وما يحيون من انتماءات وعادات وتقاليد وأعراف؛ وكأن ما كان يتم بضرورات ومستلزمات الفعل، أصبح يتم الآن بتأثيرات ونتائج القوة.
وهنا تكمن مفارقة الأفغان في أنهم لم يكونوا في حاجة لمثل هذه المفاهيم العصرية المرتبطة بأطر الدولة الحديثة، فوطنهم هو محل إقامتهم وأرضهم هي حدود قبيلتهم بغض النظر عن الشعارات والمتطلبات الحداثية التي فرضت تسميات وشعارات جديدة، لكن التدخلات والعنف الخارجي هو من فرض عليهم تحديد أطرهم الجغرافية والحديث الصاخب عن ماهيتهم وشجاعتهم وقدراتهم المختلفة على مواجهة أي قوى وأي محتل كائنًا ما كان. والواضح أن عمليات القطع الاستعماري المتواصلة أدت بدرجة أو بأخرى لتوحد الأفغان عبر حكوماتهم المتعاقبة، بغض النظر عن مستوى الأداء، والتركيز على مسألة حدود الدولة التي تكون في الأحوال العادية مسألة بعيدة عن التفكير، بما في ذلك العاصمة كابول. ويرتبط بذلك العمل على توحيد القبائل المتعددة غير المقيدة بأي قيود مجتمعية أو حكومية؛ الأمر الذي يساعد على هيمنة الدولة بدرجة أو بأخرى، ومواجهة عمليات القطع الاستعماري المتواصل عبر التاريخ الأفغاني. وهنا يؤكد المؤلّف أن أفغانستان تصنع قصتها الخاصة بها بغض النظر عن التدخلات الدولية التي تتم فيها؛ حيث تبدو هذه التدخلات مجرد قطع في مسيرة هذه الدولة التي تنسج تاريخها وفقًا لما تريده هي، بغضّ النظر عن مدى مطابقته أو انسجامه مع المحيط العالمي.
ويتنامى هذا الإحساس الوطني من خلال ما قام به القطع الاستعماري من قطع آخر للأراضي الأفغانية تمثّل في فصل مدينة بيشاور ذات الأغلبية البشتونية عن التراب الأفغاني وضمّها لصالح باكستان ضمن إعادة الترسيم الاستعماري عبر خط ديوراند الذي رسمته بريطانيا عام 1893؛ وهو أمر يمثل شوكة في حلق الأفغان حتى اليوم. وهو ما ينذر باشتعال حروب إقليمية قادمة بخصوص إعادة ترسيم جديدة للحدود، خصوصًا في ظل تنامي التدخل الباكستاني في الأراضي الأفغانية، وما تقوم به من تمويل لعمليات انتحارية ضمن هذا الإقليم ذي الأغلبية البشتونية.
بين عالمي التحديث والتقليد
تعرضت أفغانستان إلى خمس مرات من الهجوم والغزو والاحتلال خلال القرنين الماضيين، واللافت للنظر هنا أن أي من القوى المهاجمة أو الغازية أو المحتلة لم تتعلم من درس القوى التي سبقتها، سواء من خلال ما تعرضت له، أو من خلال الكيفية التي يمكن التعامل بها مع الشعب الأفغاني، والقضايا المرتبطة به؛ فالإنكليز غزوا أفغانستان عام 1839 حيث أُبيد الجيش الإنكليزي برمته، ثم أعادوا المحاولة مرة أخرى عام 1879 مكرّرين تقريبًا الأخطاء السابقة نفسها، ليُعيدوا الأخطاء نفسها أيضًا بعد ما يقرب من عقود أربعة عام 1919، وأخيرًا جاء الغزو السوفيتي عام 1979، ومن بعده الأميركي عام 2001. وعبر كل هذه الحروب فإن عمليات القطع المتواصلة لم تُفِدِ الغزاة كما لم تُفد الأفغان، بقدر ما قطعت تواصل تاريخهم كما يريدونه هم، وليس أي قوى غيرهم.
وفي ضوء مفاجآت مواجهات القطع المتواصلة للتاريخ الأفغاني يركّز المؤلّف بشكل خاص على عملية التحديث التي بدأها أمان الله في أفغانستان في عشرينيات القرن الماضي متجنبًا تطبيق الشريعة بشكلها الصارم والمقيد للممارسات المجتمعية المختلفة بما في ذلك تدعيم أدوار المرأة ومساواتها بالرجل، وبما يحقق قدرًا كبيرًا من التسامح المجتمعي العام. وهو ما استمر حتى الحرب الباردة قبل أن تعود أفغانستان مرة أخرى لعمليات القطع الدولي ويتم وضعها مرة أخرى على خارطة الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي. وهو الأمر الذي تتابع فيما بعد حيث ظهرت مرة أخرى مثيرات الانفلات الأفغاني من خلال حركة طالبان، والقاعدة، واللاجئين، والمخدرات، والفساد الإداري واسع النطاق، نهاية بالاكتشافات المعدنية الهائلة التي لم تستفد منها أفغانستان حتى الآن.
وإذا كان الجزء الأول من الكتاب يركز على التاريخ ويؤسس له بما يكشف عن عمليات القطع المتواصلة التي تعرض لها ذلك البلد القابع في أحضان الجبال والطبيعة المتوحشة؛ فإن الأجزاء التالية من الكتاب تكشف عن طبيعة أفغانستان التي تمثل دولة واحدة بينما هي تحيا بين عالمين: عالم التحديث وعالم التقليد. فتاريخ أفغانستان المعاصر هو تاريخ الصراع بين الرغبة في الانطلاق نحو الخارج والغرب عمومًا وبين الحفاظ على التقاليد والأعراف المتجذرة ضمن مجتمع قبلي يرتكز على المفاهيم الدينية التقليدية وتصور محافظ جدًا لدور المرأة ووضعيتها في المجتمع. وهو أمر عانى منه أمان الله بشكل كبير رغم الأدوار الهائلة التي قام بها من أجل تحديث أفغانستان ونقلها لمصاف الدول المتقدمة. فالمعادلة التي تواجه أفغانستان في الماضي والحاضر والمستقبل تتمثل في الكيفية التي يستطيع بها أي حاكم الجمع والتوفيق بين القيم الغربية الحديثة وبين القيم المحلية المحافظة؛ أو كما يقول المؤلف: "بلد يجمع بين قيم القرنين الحادي والعشرين والثاني عشر".
هذا الصراع الهائل هو الذي يفرض نفسه بقوة على أي حاكم لأفغانستان، وهو أمر ربما ما زالت الولايات المتحدة الأميركية لا تفهمه في تعاملها مع حامد كرزاي حينما تراه يهلل للعلاقات مع أميركا، وفي الوقت نفسه يحرص على العلاقات مع قادة القبائل ويشتري ودّهم بما في ذلك زعماء حركة طالبان. وفي الوقت الذي لا ترى فيه الولايات المتحدة في حركة طالبان إلا ما يتعلق بالإرهاب فإن كرزاي يرى فيها تلك القيم الداخلية التي لابد من الارتباط بها وعدم الانفصال عنها من أجل الحفاظ على معادلة الخارج والداخل سليمة غير مزعزعة بما يضمن له الاستمرار في الحكم والتعاطي مع قواعد اللعبة الأفغانية التي قد تبدو للمراقب الخارجي أنها لعبة بدون قواعد مثل لعبة البوزكاشي Buzkashi الأفغانية الشهيرة.
في تلك اللعبة العنيفة تبدو المسألة بدون أي قواعد؛ فكل فرد يسعى لمجده الشخصي الفردي، ولا يهمه أي شيء آخر حتى فريقه، المهم أن يحرز هدفًا بما يجعله فخرًا لقبيلته التي ينتمي إليها. وهو أمر يظهر واضحًا أيضًا، من خلال توصيف المؤلّف لحالة المرور المعاصرة في أفغانستان، التي تبدو للمراقب الخارجي مسألة فوضوية تمامًا تسير بدون أية قواعد وبدون أية التزامات. هنا يرى المؤلف أن ما قد يبدو للمراقب الخارجي لعبة أو مرورًا بدون قواعد يمثل بالنسبة للأفغان قدرًا من الضبط والالتزام الذي يوفر قواعد معينة يفهمها ويعيها الأفغان ولا يهمهم في المقابل أن يفهمها أو يعيها غيرهم. وهنا تكمن مأساة المجتمع الأفغاني؛ أنه يتم التعامل معه من الخارج بدون فهم حقيقي لقيمه وثقافته وحقيقة انتماءاته الداخلية التي ما زالت تدور بدرجة أو بأخرى ضمن قواعد مجتمع قبلي ديني، القبيلة فيه والقيم الدينية المرتبطة بها أهم لدى الفرد مما يتعلق بالمفهوم الحديث الذي نطلق عليه اسم الدولة. هذه الصيغ القبلية لم تكن متصارعة، بقدر ما كانت متعايشة ومتجاورة تبحث عن صيغ تجمعها بطرق مختلفة وعديدة.
لكن عمليات القطع الخارجية تسببت في إحداث آثار سلبية عديدة على بنية المجتمع الأفغاني المعاصر؛ آثار من السلبية بمكان أنها طالت بنية الفرد الأفغاني بما سبّبته له من قطع عن بنية قبيلته والاحتماء المرتبط بها. فالملايين من الأفغان اُجتُثّوا من العيش الآمن بين قبائلهم ليجدوا أنفسهم يشبّون ضمن حياة العيش غير الآمنة في معسكرات على الحدود الباكستانية، وضمن مناطق أخرى لم يتعودوا عليها، وهو أمر أدى لتنشئة أجيال عديدة بعيدًا عن المهاد الطبيعي لها، بما أدى لحروب دموية أدمت أفغانستان ومن ثم الفرد تركيبة الأفغاني الطبيعي. فما لا ينتبه إليه الغرب، والدول المحيطة بأفغانستان، أن الحروب المتتالية منذ الغزو السوفيتي مرورًا بالغزو الأميركي قد خلقت جيلاً أفغانيًا جديدًا لم يمارس حياته بشكل طبيعي، بقدر ما مارسها في أحضان مناطق موحشة لم ينتمِ إليها وفي أحضان السلاح والموت اليومي.
وللأسف، ورغم كل هذه النتائج السيئة، فإن كافة الغزاة كثيرًا ما كانوا يرددون أنهم يبحثون عن تحديث أفغانستان وخروجها من طوق التقليدية والتخلف إلى آمال التحديث والرقي، وهو أمر لم يحدث طوال القرنين الماضيين. فقد كان الغزاة يجترّون خطابات لم تجلب للمجتمع الأفغاني سوى الدماء والمجازر المتتابعة. والغريب في الأمر أنه كلما زادت حدة المجازر والقتل والتدمير زاد الحديث عن عظمة الشعب الأفغاني وقدراته وشجاعته. فالمشكلة لم تبدُ في الكيفية التي يتم من خلالها توحيد الأفغان والقضاء على فُرقتهم، لكنها تمثلت فيما أحدثه التدخل الأجنبي من تشظٍ حاد لهذا المجتمع الآمن، وهو ما خلق صعوبات هائلة من أجل السيطرة عليه مرة أخرى، وإعادته إلى بنيته الأولى الخاصة به. وما يضفي قدرًا كبيرًا من القتامة على علاقة الأفغان بالغزاة أن الأخيرين عاشوا بعيدًا عن هذا المجتمع ولم يختلطوا به، فقد كانت لهم معسكراتهم البعيدة التي تعلن عن مناوأتها وعدائها لهذا الشعب البسيط، كما كانت لهم لغتهم التي لا يتعامل بها الأفغان. ومن هنا فلم تخلق تلك القوى الحالة المصاحبة للموجات الاستعمارية من تحديث للمجتمعات المحتلة وتطوير لها، رغم الادعاء الدائم والمستمر بعكس ذلك.
أفغانستان بين زيارتين
ورغم هذه الصورة القاتمة التي يصف بها المؤلف تميم أنصاري أفغانستان، فإنه يرى أنها تواجه قدرًا ما من التغيير والتحديث لا تخطئه العين. فمن خلال المقارنة بين زيارتين لها عامي 2002 و2012، يكشف أنصاري عن حجم التغيير الذي حاق بها، ورغم بطء هذا التغيير فإنه يرى أن المهم هو استقبال الأفغان له وترحيبهم به؛ ففي زيارته الأولى لها عام 2002، فوجئ المؤلف بأن أفغانستان لم تتغير منذ تركها في صباه، وبشكل خاص المناطق الريفية منها والتي تمثل معقلاً للتقليد والقيم الجامدة والراكدة. فما زالت أفغانستان تواجه عالمين: عالم الرجال العام المهيمن، وعالم النساء الخاص المحمي خلف الأسوار العاتية من التقاليد والسيادة المطلقة للذكور.
ومرة أخرى زارها المؤلف عام 2012 حيث وجد بعض أمارات التغيير وعلى رأسها تجديد المنازل واستخدام المحمول، وبينما كان الناس يسوقون القردة في الريف والمدن على السواء، فإنه وجد أن البعض ما زال يسوقها في الريف بينما بدأ الناس يحملون الحواسب الشخصية في المدن. وفي عام 2002 كانت كابول العاصمة مدينة صغيرة غير منظمة يبلغ عدد سكانها 350000 ألف نسمة وبها إشارتان للمرور فقط، ولكنها في 2012 قد أصبحت مدينة ميتروبوليتانية يعيش فيها الملايين الذين تتراوح تقديراتهم بين الثلاثة وحتى العشرة ملايين نسمة، لكنها رغم ذلك ما زالت تعيش بهاتين الإشارتين من المرور. واللافت للنظر أن الناس لم يكونوا يعتدّون بتلك الإشارات منذ عشر سنوات؛ حيث يرونها من مجلوبات الثقافة الغربية، أما الآن فإنهم يرونها مسألة مهمة وحيوية مثلها مثل تعبيد الطرق الذي يرونه على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لتحركاتهم وانتقالاتهم من المناطق الريفية إلى المناطق المحيطة بها، وعلى رأسها العاصمة كابول.
يحتاج الأفغان الآن إلى الأمل والعودة إلى الحياة والعيش بعيدًا عن الدماء والسلاح والموتى، وإذا استطاع أي حاكم أفغاني أن يجمع بين مغريات الحداثة الغربية وبين الارتباط النفسي بالقيم المحلية، ويقدم لذويه بوادر أمل في حياة إنسانية كريمة، فإنه لا محالة سوف ينقل هذا البلد التعس من حالة القطع الاستعماري المتواصل إلى حالة العيش الآمن الحديث الذي يتوق له الأفغان الذين لم يعايشوا عبر قرنين من الزمان سوى رائحة البارود والموت والانخلاع من حنين القبيلة والأسرة الممتدة وطمأنينة المكان.
معلومات عن الكتاب
المؤلف: تميم أنصاري Tamim Ansary.
عنوان الكتاب باللغة الأصلية: Games without Rules: The often-interrupted history of Afghanistan
عرض: صالح سليمان عبدالعظيم.
عدد الصفحات: 416
الناشر: Public Affairs, New York
سنة النشر: 2012
____________________________
هوامش
1- Murray Brewster, The Savage War: The Untold Battles of Afghanistan.
2- Chris Alexander, The Long Way Back: Afghanistan’s Quest for Piece.