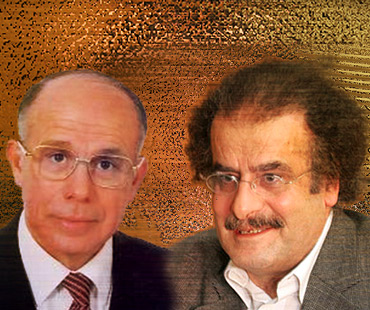 |
الاستناد لعلم تحليل الخطاب
عدم براءة اللغة
الحرب اللغوية
انجراح الوعي اللغوي
مقالة د. وليد يوسف "ستون عاما على النكبة – الصراع على المعاني : الصراع على الوجود" تندرج بوفاء تام ضمن سياقين، سياق معرفي شائع هو علم تحليل الخطاب، وسياق ثقافي دقيق ما انفك يتأهل لمنزلة بحثيّة متقدة يُطلق عليه مصطلح حرب المصطلحات. وقد صاغها مؤلفها صوغا يكتسي نسق الخطاب النضالي، وأضفى عليها سمات من الكتابة البلاغية الراقية غلبت عليها المجازات التي تسرّح المقاصد العميقة من مكنوناتها، وطفح عليها أسلوب من الدعابة الساخرة التي تؤثث الإحساس الدراميّ.
| ما إن يتفوه المتكلم بكلامه حتى يكون قد اتخذ موقعه داخل كل جزء من أجزاء كلامه، وهكذا ينكشف أن من خصائص اللغة أنها تصنع الدلالة أحيانا بما لا تقوله أكثر مما تصنعها بما تقوله، وينكشف أيضا أن الحياد المطلق متعذر على المتكلم في استخدامه اللغة |
إن التأمل المتأنيَ في خصائص الخطاب السياسي بما آل إليه في ضوء سطوة الإعلام وفي ضوء التغير الجوهري الطارئ على آليات التواصل يوقفنا على قانون بالغ الخفاء، شديد التمكن، هو ما سبق أن اصطلحنا عليه بقانون الانخراط الدلالي المشترك، ونعني به أن كل كلمة يختارها المتحدث في سلسلة كلامه تمثل التزاما بدلالتها التصريحية وبدلالتها الإيحائية، وهذا يؤدي إلى الالتزام الدلالي الواعي باختيار ما نختاره من الألفاظ، والالتزام الواعي بالإعراض عما لا نختاره. وهذا القانون يرجع إلى ما يسمّى في علم تحليل الخطاب بمبدإ التمَوْضع، ويعني أن المتكلم ما إن يتفوه بكلامه حتى يكون قد اتخذ موقعه داخل كل جزء من أجزاء كلامه، وهكذا ينكشف أن من خصائص اللغة أنها تصنع الدلالة أحيانا بما لا تقوله أكثر مما تصنعها بما تقوله، وينكشف أيضا أن الحياد المطلق متعذر على المتكلم في استخدامه اللغة.
إن اختيارنا لفظا من اللغة دون آخر يقحمنا إقحاما في مضامينه كلها، وفي متضمَّناته وتبعاته أيضا، وإن استعمالنا كلمات اللغة يحمّلنا مسؤولية مزدوجة : مسؤولية اختيارها ومسئولية عدم اختيار غيرها. ومن أوضح الشواهد الدالة على كل ذلك استخدام الناس لعبارة "العالم العربي" هذه التي صدمت أحاسيس كاتب المقال، وفجرت مشاعر المأساة في الجرح الفاصل بين اللغة والسياسة، واستدعت لذاكرته عبارات مجانسة من فصيل "الشرق الأوسط" أو "شعوب المنطقة" وكان د. وليد يوسف – على مدى مقالته – يتوسل بأسلوب السرد حاكيا قصة الصراع العربي الإسرائيلي على روايتين، هما رواية الأنا ورواية الآخر، فإذا جئنا إلى الأنا عنده ألفيناها "أناءات" عديدة بوسعنا أن نسلكها في رؤيتين ناظمتين : الرؤية الانتمائيّة والرؤية الاستلابيّة.
إن عبارة العالم العربي ترد على ألسنة الكثيرين، كأنهم يتداولونها بضرب من الفطرة القاصرة، أو ضرب من السجيّة الغافلة، هم ينطقون بها على براءة مظنونة، وبحكم ذلك نصادفها بتواتر كبير في عناوين الندوات والمؤتمرات التي تعقدها مؤسسات عتيدة أصيلة في مختلف الأقطار العربية، ونصادفها أيضا في المقالات أو الكتب التي يحبّرها أعلام بارزون، ولكننا عند التمعن والتقصي ندرك بيسر تام أن عبارة "العالم العربي" مصطلح له تاريخ، أطلقه المستشرقون، وكان بينهم الأبرياء المخلصون، وكان فيهم الذين احترفوا مجانبة الإنصاف، واستوت العبارة على دلالة إيحائية واضحة وهي أن "العالم العربي" مفهوم مخالف لمفهوم العالم الحر، والعالم المتقدم، وربما أيضا العالم الغربي، فهو شقيق في الدلالة والإيحاء لمفهوم العالم الثالث الذي ذاع في أوج القطبيّة الثنائيّة، وتم تكريسه للدلالة على العالم المتخلف قبل أن يتم استحداث مصطلح العالم النامي كبديل فيه كياسة مخاتلة. فباختزالٍ شديد بوسعنا أن نعتبر أن عبارة العالم العربي هي من المصطلحات التي من المفروض أن يطلقها الآخرون علينا، لا أن نطلقها نحن على أنفسنا، وهذا الحكم يظل صالحا ووجيها حتى ولو أزحنا كل الشبهات الماكرة، وكل التضمينات التي تجول بخاطر الآخرين.
| براءة اللغة وهمٌ كامل والحيادية المطلقة في اصطفاء الألفاظ وهمٌ كامل والموضوعية الفكرية مسألة نسبيّة كثيرا ما يتهاوى صرحها بمجرد عبورها جسرَ اللغة حتى لتقول إن التعامل السياسي مع اللغة – كالتعامل اللغوي مع السياسة – طريق محفوفة بالأفخاخ |
لإدراك قانون الانخراط الدلالي المزدوج بين الطاقة التصريحية للألفاظ وطاقتها التضمينية يكفينا – على سبيل الشاهد التمثيلي – أن نختبر البدائل الافتراضية المحتملة ؛ ولننظرْ إلى صيغة بديلة أولى وهي أن نستعمل عبارة الوطن العربي بدل العالم العربي، وهذا البديل سيجعل لكلامنا مضمونا إيحائيا – لمن يعي الفوارق الدلالية ويتبصّر بآليات تركيب الخطاب – مَفادُه أن العرب جميعا ذوو انتماء اجتماعي واحد، وأنه من المفروض أن يكونوا في وطن واحد، وأن التاريخ هو الذي حوّل دولتهم إلى دويلات، وداخلَ هذا التصور ينبغي أن نسميَ تلك الدويلات أقطارا لا أوطانا.
وقد ينبني القول على بديل آخر فنقول "الأمة العربية" فيكون اللفظ الذي نختاره موحيا بفارق دلالي آخر هو اعتبارنا أن العرب ذوو انتماء قومي واحد، توحّدهم عناصر التاريخ واللغة والعقيدة. وقد يجنح المتكلم إلى صيغة أخرى فيترك – بالوعي الجليّ أو بالحس الغامض – تلك العبارات الثلاث السالفة ويقول "العرب بين الحاضر والمستقبل" أو "العرب والعولمة" فيكون قد قطع الطريق على أي تأويل تحزبيّ إيديولوجيّ، ولكنه سيقع في إشكال جديد وهو أنه بقوله "العرب" كأنما قد خرج هو من دائرة الانتماء، ويكون قد تبنى صيغة من المفروض أن يطلقها الآخرون عنا، لا أن نطلقها نحن على أنفسنا. عندئذ قد يلجأ إلى صيغة أخرى فيقول على سبيل المثال "نحن والعولمة" وعندئذ سيصطدم بعقبة دقيقة تتمثل أولا في انغماسه الكليّ في الالتزام بالذات الجماعية، وانخراطه التام في أشراط الانتماء، وهو ما قد يحول بينه وبين صياغة خطاب موضوعي عقلاني، وتتمثل ثانيا في أنه سيقصي الآخر إقصاء آليا بحيث يتعذر عليه أن يدعوَ – للمشاركة في الحوار الفكري – أعلاما من غير العرب قد يكونون على درجة عالية من النزاهة والإنصاف.
ما يجب أن نخلص إليه مبدئيا هو أن براءة اللغة وهمٌ كامل، وأن الحيادية المطلقة في اصطفاء الألفاظ وهمٌ كامل، وأن الموضوعية الفكرية مسألة نسبيّة كثيرا ما يتهاوى صرحها بمجرد عبورها جسرَ اللغة حتى لتقول إن التعامل السياسي مع اللغة – كالتعامل اللغوي مع السياسة – طريق محفوفة بالأفخاخ، وأعظم فخ فيها هو مستنقع التسمية الذي لا مناص لنا من اجتيازه، لقد أفرزت حرب الكلمات بحكم سطوة الإعلام نوعا جديدا من الأدلجة فنشأ ما يجوز لنا أن نقول عنه إنه إيديولوجيا التسمية، والذي أسلفنا قد يبدو للناظر المتعجل بذخا فكريا، وقد يتراءى ترفا يصنعه التأويل الذهني وهو متحصن في برجه العاجي، وليس شيء من ذلك الظن بوجيه ولا رشيق، فنحن هنا على محك الواقع بكل صلابته، والدليل هو أن جهات عديدة في مختلف أرجاء العالم تتطوع بتقديم الدعم لعقد المؤتمرات الفكرية، منها ما هو تابع لمنظمات العمل الدولي، ومنها ما هو تابع للتجمعات الدولية كالاتحاد الأوربي، وبعضها من المؤسسات الاقتصادية التي إذا دعمت الأنشطة الفكرية حصلت على امتيازات ضريبية لدى حكوماتها، وكثير منها منظمات تنضوي تحت مظلة المجتمع المدني، يقال لها منظمات غير حكومية، وهي بطبيعتها غير ربحية، وفيها ما يعلن عن نفسه أنه خيريّ.
إن لكل تلك الجهات الداعمة قراءتها للأسماء قبل انخراطها في المسميات، وبناءً عليه لن تجد مؤسسة واحدة منها تدعمك إذا عرضت عليها مشروع مؤتمرك الفكري وقد بنيته على مصطلح الوطن العربي، أو الأمة العربية، أو العرب، أو نحن، وإنما تدعمك فقط إذا قلت "العالم العربي والعولمة" أو "العالم العربي بين الحاضر والمستقبل" فالمسألة ليست لا بذخا فكريا، ولا ترفا ثقافيا، ولا تفصّحا لغويا. وإنها سلاح الكلمات في المعركة اللغوية التي هي عماد الحرب النفسية تتجلى بأوضح صورها عندما يقدم الفلسطيني أو العراقي أو الشيشاني أو الأفغاني على التضحية بنفسه فيهجم على العساكر الأجنبية الذين غزوا أرضه، واغتصبوا وجوده، فينسفهم نسفا مجسما قيم الفداء، فتنطلق حرب الكلمات بما نختار له من الأسماء : أهو مقاوم، فدائي، شهيد ؟ أم هو كاميكاز، انتحاري، إرهابي ؟ هي حقائق عينية تثبت ما آلم د. وليد يوسف وأضناه، وهو أن الآخرين يَعُون ما يقولون، ويقصدون إلى المضمّن من الدلالات، ويشتغلون بثبات ومهارة وإصرار على المسكوت عنه في منظومة المعاني بينما نقف نحن عند الظاهر، ونغفل عن المدسوس في الكلمات من آليات الحقن التي تغزو نفوسنا على مَهَل واستدراج.
| الفحص المتعمّق يوقف اللغوي الحامل للهاجس السياسي والمبتغي ضبط آليات تفكيك الخطاب على سمة متناهية في الدقة، وتتمثل في مستويين اثنين الأول حين يختار المتكلم بين ألفاظ اللغة بمحض إرادته لفظًا يعبّر به عن مقصده فيكون اختياره كاشفًا لموقفه الذاتي، والثاني في مسافة ما بين الدال والمدلول عند التداول اللغوي |
إن مرتكب المجزرة طبيب كان يومها في الأربعين، شهد الإعلامُ بأنه يمارس عمله بكل مداركه العقلية، فحكمُ كلينتون عليه بالجنون يتيح له بأن يظهر بصورة المنصف دون أن يكون قد التزم بشيء، هي لعبة المراوحة بين الحقيقة والمجاز، فالفاعل ليس مجنونا على الحقيقة وإن كان التصريح يوهم بأنه مجنون على الحقيقة، والفاعل مجنون على المجاز لأن فعلته مرفوضة، ولكن ارتكابه إياها لا يُدينه لأنه انخرط في سلك المجانين ساعة إنجازها، وهكذا تترتب رسالة كلينتون ضمن استراتيجية صناعة الخطاب كما يلي : الفعلة عمل فردي، والجيش الإسرائيلي بريء، والحكومة الإسرائيلية بريئة، وهكذا تغيب فكرة الإرهاب، وفكرة العنصرية، وفكرة التطرف، ويغيب معنى الإجرام، وبناء على ذلك تحتجب ضرورة التنديد، ويضيع مبدأ المحاسبة والعقاب، أما الغائب الأكبر فهو الاعتذار لدى أهالي الضحايا ولدى من يمثلهم.
عندما حصلت أعظم مظلمة في التاريخ عام 1948 بإحلال أشتات - لا يمتلكون وطنا ولا يتوفرون على الأشراط الأولى لمفهوم الشعب - محل شعب في وطنه ثم وقع تهجيره بعد استلاب أرضه أطلق العرب على ذاك الخطب الجليل عبارة "النكبة" ولما اندلعت الحرب من جديد عام 1967 انبرى الجميع تلقائيا يتحدّثون عن النكبة من جديد، وحيث إن الاسم قد تم تكريسه لِمَا حصل عام 1948 – والناس في التداول اللغوي يحكمهم قانون الاقتصاد الأدائي فيتحاشون الاشتراك دفعا للالتباس – فقد برز على السطح لفظ الهزيمة، ثم تيقظ الحس الكليم فراح الخطاب الرسمي يدفع بالإعلام إلى استخدام لفظ النكسة بدلَ النكبة وبدل الهزيمة، وسرعان ما أصبح اللفظ عنوانا على السياسة الرسمية التي تصر على تبرئة نفسها تسويغا للبقاء، ولكن الاستعمال كرسه حتى على لسان أشرس المعترضين بمن فيهم ناظم الهوامش على دفاتر النكسة، وهنا نقرأ بمنظار مجهري دقيق ما يقوله د. وليد يوسف : "ستون عاما والماضي هو الآن ؛ وإذ يبحث الشاهد والشهيد في عمق وجدانه النازف عن كلمات تروي حزنه وغضبه وملحمته، لا يجد الآن بعد ستين عاما أصدق وأحسن من كلمات المعجم الأول، معجم السنوات الأولى العجاف، النكبة." لنصل – بعد مسافة – إلى قوله : "بعد ستين سنة من النكبة المستمرة لم تتغير حقائق الصراع..."
إن الضمير العام يشتغل بموجَب الحدس اللغوي الغامض، لذلك يتعين تفكيك دلالة الألفاظ إلى مركباتها الجنينية الأولى، إن النكبة في قاموس العرب الأوائل تعني حصول الرزية في الأمر العزيز في وقت غير متوقع حصولُها فيه على الإطلاق، وجلال النكبة أن الرزية قطعيّة باتة لا أمل معها في عودة ما نُكبنا فيه، لذلك كانت العرب تقول – في الفصاحة النقية الأثيلة – نُكِبَ الأبُ في ابنه بينما تقول فقدَ الابن أباه. وعلى نفس النسق تقوم دلالة مفردة الهزيمة، فهي تطلق عندما يخسر الإنسان الحرب بالكلية، لذلك شاعت عبارة تدفع شبح الخسارة القطعية الباتة وهي قول القائل : خسرنا معركة ولم نخسر الحرب ؛ فالنكبة والهزيمة مفردتان تتجذران في أبدية الحدث ؛ ولهذه الأسباب حصلت ردة الفعل بتأهيل مفردة النكسة، ففي دلالتها الأولى أن حالة الانتكاس حالة عرضية طارئة كما لو أنها صورة من صور الفرّ سيعقبها مشهد الكرّ.
كل المسألة هي إذن قائمة على مبدإ الانخراط في الدلالة، وبالتالي على مبدإ المسؤولية عند التداول اللغوي، سواء من لدن المتكلم الباث أو من لدن السامع المتلقي. ولكن الفحص المتعمّق يوقف اللغوي الحامل للهاجس السياسي والمبتغي ضبط آليات تفكيك الخطاب على سمة متناهية في الدقة، وتتمثل في مستويين اثنين تتوزع إليهما قضية الانخراط الدلالي، الأول حين يختار المتكلم بين ألفاظ اللغة بمحض إرادته لفظًا يعبّر به عن مقصده فيكون اختياره كاشفًا لموقفه الذاتي، ومثلُ ذلك يحصل أيضًا في سياق الخطاب السياسي، ويقع هذا المستوى الثاني في مسافة ما بين الدال والمدلول عند التداول اللغوي. أما المستوى الثاني فيقع في مسافة ما بين الاسم والمسمّى، ولا نعني بهما ثنائية الأعلام وألقابهم، وإنما نعني بهما ما يحصل عندما يعمد الخطاب السياسي إلى تسمية الأشياء والظواهر والوقائع.
بلا تردد وبلا محاذير نقول – جازمين - : إن استخدام أي دال لغوي – في مجال الخطاب السياسي – هو انخراط في صدقية مدلوله، وهذا حكم محسوم بصرف النظر عن مدى وعي المتكلم بذلك أو عدم وعيه، وينتج عن هذا القانون المتواتر أن الوعي يؤكد القصد بينما يؤكد عدم الوعي الانجرار، ومن ذلك كله يستوي قانون الاستدراج ومفاده أن الانخراط الدلالي يعني تزكية صدقية المدلول، وهذه التزكية تتناسب تناسبًا طرديًا مع عدم الوعي. فكلما كان الناس غافلين عن مسؤولياتهم في استعمال الألفاظ سهُل على المناورين استخدامُ اللغة لغزو عالمهم النفسي وابتزاز إرادتهم، ثمّ إعادة تشكيل عقولهم.
| الكلمات ذخيرة حية على مسرح الصراع واللغة ذاتها ساحة من ساحات العمليات في فضاء المعركة ولئن ساد غياب الوعي في مجالنا العربي بكل ملابسات هذه الحرب الخاصة والتي تحاك فصولها بالألفاظ وبزيوت مكر الخطاب فإن بعض أشعة النور تخترق العتمة حينًا بعد حين |
الحقيقة أن الكلمات ذخيرة حية على مسرح الصراع، بل اللغة ذاتها ساحة من ساحات العمليات في فضاء المعركة. ولئن ساد غياب الوعي – في مجالنا العربي – بكل ملابسات هذه الحرب الخاصة، التي تحاك فصولها بالألفاظ، وتنمق لوحاتها بزيوت مكر الخطاب، فإن بعض أشعة النور تخترق العتمة حينًا بعد حين: انكبت ثلة من الراصدين الباحثين – بإشراف اتحاد الصحفيين العرب – على استقراء لغة الإعلام، من خلال الإذاعة الإسرائيلية التي تبث باللغة العربية، واستمر البحث اللغوي الميداني طيلة عامي 2000 – 2001 وأثمر كتابًا تولى إعداده صلاح حافظ وحمل عنوانا كاشفًا (حرب المصطلحات)، وقدم له الكاتب الصحفي إبراهيم نافع فاشتمل على مراجعة نقدية شاملة للكلمات بما يدل على أنها عُدة حربية قائمة بنفسها، وأبان الاختلال المكشوف بين استراتيجية القبض على آليات الذهن والإدراك من خلال تداول الألفاظ من جهة وغباء الانسياق إلى استعمال الكلمات دون وعي بتضميناتها الدلالية والنفسية من جهة أخرى. وبين عشرات العبارات التي يتداولها الخطاب العربي – إعلاميًّا أو سياسيًّا – نقف على مَصْيدة اللغة وأفخاخها، وليس غريبًا أن يفاجأ القارئ العربي بأن مجرد استخدامه لعبارة (قوات الأمن الإسرائيلية) أو عبارة (التوغل) هو غباء سياسي مهين.
وطفق الوعي يتفشى، وانبرت بعض المهج الواعية تتولى تطهير الذاكرة بواسطة غسل الكلمات كالذي فعلته مجلة سطور (ع 28 سبتمبر 2003) حيث ترسم الجداول الثنائية : المصطلحات المغشوشة التي تندس بين الألسنة بترويج مضمر، والبدائل التي من الظنون أن يتوخاها الإعلام العربي، ومن بين ما يتكشف للقارئ أن عبارة (حرب الأيام الستة) ما هي إلا (تسويق إسرائيلي لتسمية حرب 1967 على أساس تشبيهها بفعل النبي يوشع عليه السلام عندما شن حرب الستة أيام على أعدائه، وظل يحاربهم إلى أن حل مساء الجمعة، فطلب من اللّه أن يؤخر غروب شمس ذلك اليوم حتى يجهز على أعدائه، قبل أن يبدأ يوم السبت. فتلك المصطلحات صناعة يهودية لتبرير الحروب التي خاضوها لسلب أرض فلسطين وإضفاء القدسية عليها بموجب المرجعية التوراتية كما تمثلوها).
إن القضية أكثر تعقدًا مما قد يتبادر، وهي بالغة التشعب والمعاضلة. ففي اللغة قواعد متواترة لا يعيها المستعملون لها إلا ببصيرة نقدية خاصة، منها أن الإنسان يستعمل ألفاظها على أساس دلالتها القائمة في زمن استعماله لها، لكن للألفاظ ذاكرة، وذاكرتها هي مخزن دلالتها الماضية، والفروق رقيقة أحيانا بحيث تحتجب عند الانتقال التدريجي. والمشكلة تتمثل في أن المستعمل للغة إذا ما أصر على استحضار تاريخ دلالات الألفاظ تعطل تواصله مع الآخرين، وقد يتعطل انسجامه الذاتي مع أداته التعبيرية، ولكن المشكلة الأعسر هي أن الكلمات التي شحنتها السياسة بإيحاءاتها الخاصة تظل تراوح حقيقتين في الذاكرة : حقيقة دلالتها الراهنة وحقيقة الظلال الدلالية الماضية. فلو اعتبرنا تاريخيّة الدلالة والمعاني الحافة التي تستصحبها الأسماء معها عبر الزمن لكان من غير الوفاء للقناعة السياسية أن ينطق العرب بلفظة (إسرائيل) أصلاً، والسبب أن في ذلك إقرارًا بالوجود ثمّ إقرارًا بمشروعية الوجود، وكان من المفروض ألا يتكلم العرب إلا عن (فلسطين المحتلة) كما كانوا يتكلمون. ولكن حيثيات التاريخ وبعض حيثيات قانون الاقتصاد اللغوي يستميل الاستعمال نحو اللفظ المباشر والمختصر. ومن هنا يبدأ فصل من فصول قصة اللغة والسياسة، كيف نجعل الأسماء لا تدل على مسمياتها إلا عبر مصفاة الانخراط الدلالي ؟
بوسع الخاطر أن يبحر في شقائق الأسماء ليجوس عبر نوافذها فيرى تواليَ المشاهد كما في شريط وثائقيّ، وكلها يحكي جدل انخراط العرب في دائرة الالتزام بمضمنات المعنى، وهكذا تتدرج الألفاظ من أرفعها التزامًا بكل الإيحاءات الملازمة لدلالتها على الأسماء إلى أقربها ارتباطًا بالشائع من الأعراف القائمة : الكيان الصهيوني – الدولة الصهيونية – الدول العبرية – الكيان الإسرائيلي – إسرائيل. وفي أشد لحظات البطش التي مارسها (شارون) على المقاومة الفلسطينية كنت تسمع أصواتا عربية تعلن احتجاجها على (الإدارة الإسرائيلية الحالية).
من العسير جدا – بحكم قوانين الدلالة اللغوية وتحركها الجدلي على محور الزمن – أن ننعت العربي الآن بالغباء أو حتى بالغفلة إذا استعمل لفظ (كنيست) ولم يستعمل (المجلس النيابي للكيان الصهيوني) أو قال (المستوطنات الإسرائيلية) ولم يقل (المستعمرات الصهيونية) على حد ما يقترح بعضهم (مجلة سطور، ع 82). لا تتصل القضية بالاستعمال اللغوي، ولكنها تتعلق بالوعي الإيحائي المندرج ضمن خانات التداول، نحن هنا حيال آليات إنتاج المعنى أكثر مما نحن حيال المعنى ذاته. فللمعنى درجتان من التجلي : من حيث هو وجود منجَز ثمّ من حيث هو صيرورة. وعلينا أن نتذكر دائمًا كيف يذيب التداول اللغوي وعي المتكلم بأصول الاشتقاق في تركيبة الألفاظ كما في تبدل معانيها عبر الحقب المتعاقبة، وبأيدينا أمثلة ناصعة تكاد تشمل مختلف الألسنة الطبيعية المتداولة.
إن الإلهاء قصة كُتبت فصولها بعلامات اللغة، وصُوّرت مشاهدها على مسرح الفضاء الطلق بين الفكر والسياسة : فالفكر يبحث عن الحقيقة ولكن الحقيقة في السياسة حقائق. والفكر يحترم الأخلاق وإن لم يأتمر بأوامر الأخلاق، ولكن السياسة تأمر الأخلاق بأوامرها. والفكر يستعين باللغة حتى يبث الأفكار، ولكن السياسة تسخر اللغة لاسترقاق الأفكار. وبين أقواس قزح على شاشة الإلهاء درجات من الطيف عددها بحسب عدد الألفاظ والعبارات والجمل والخطابات. لا لأنها تستعصي على الضبط والتبويب، ولكن لأنها تتأبى على الفرز، لأن العرب تواقون باللغة إلى الاستثناء، والعرب – ليقينهم بأنهم هم أهل الفصاحة والبيان – فاتهم أن السياسة في زمننا تطبخ في ورشات صناعة الخطاب قبل أن تبسط على موائد التهام القرارات. إنه لن يحذق السياسة من لم يتقن لعبة اللغة، ولا ننفك نردد ونكرر أنّه لن يُغنيَ العربَ مال ولا مجد ولا عدد ما لم يتمرسوا بآليات الخطاب في زمن صناعة الخطاب. 
_______________
جامعي وباحث تونسي