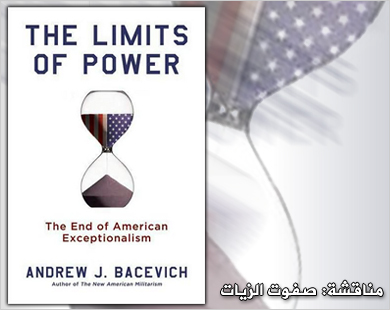 |
في كتابه هذا (حدود القوة.. نهاية الاستثنائية الأمريكية)، الذي ظهر في دور الكتب في أغسطس/ آب 2008، يتقصى آندرو باسيفتش أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة بوسطن أبعاد الأزمات الثلاث الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تواجه الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وقد قادت تلك الأزمات أمريكا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين إلى حرب كونية افتقدت فيها وضوح الرؤية وأهدرت فيها –ومازالت- مصادر الثروة والقوة معا، وكشفت عن تواضع وحدود القوة الأمريكية في إعادة تشكيل العالم وإجباره على التوافق مع نمط الحياة الأمريكية. ويرى باسيفتش في هذا الأمر دعوة للأمريكيين إلى تفحص هذا النمط والعمل على تغييره قبل أن يصل التلف فيه وبسببه إلى تخوم اللاإصلاح. والغريب أنه، وخلال أسابيع فقط من بدء نشر هذا الكتاب، تحققت نبوءة (وقت الحساب يقترب) التي جاءت في مقدمته الرائعة، عندما عصفت بالولايات المتحدة ومعها العالم أعنف أزمة مالية واقتصادية منذ الكساد العظيم. ولم تكن بعيدة عن أسبابها، إن لم تكن في القلب منها، فاتورة الاستنزاف القائم لحرب أمريكا الطويلة، التي أعلنتها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في افتتاحية مشروع إمبراطوري تبدو أطلاله الآن ماثلة على مشارف أُفق ليس ببعيد. الأمر الذي يدفعنا إلى ضرورة قراءة فاحصة لما كشف عنه وحذر منه آندرو باسيفتش.
أزمة إسراف
أزمة سياسية
أزمة عسكرية
| " التاريخ الأمريكي كما وصفه الرئيس تيودور روزفلت كان تاريخاً للتوسع وقد بدأ ذلك التوسع بالفعل مع حيازة الرئيس جيفرسون لأراضي لويزيانا عام 1803. وطوال ذلك المسعى فإن الولايات المتحدة لم تبذل ولم تجهد نفسها في تحرير الآخرين كما يحلو لبعض الأمريكيين أن يسرد تاريخهم على أنه قصة أخلاقية " |
التاريخ الأمريكي إذن، كما وصفه الرئيس تيودور روزفلت عام 1899، "كان تاريخاً للتوسع" سعياً وراء سد تلك الثغرة، وقد بدأ ذلك التوسع بالفعل مع حيازة الرئيس جيفرسون لأراضي لويزيانا عام 1803. وطوال ذلك المسعى فإن الولايات المتحدة لم تبذل ولم تجهد نفسها في تحرير الآخرين كما يحلو لبعض الأمريكيين أن يسرد تاريخهم على أنه قصة أخلاقية. تلك القصة التي يعبر عنها ساساتهم في محاولة لتطهير الماضي وإضفاء "تقليد تحرري عظيم" على هذا البلد. فالتوسع الأمريكي تم بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة في غالبه إدراكا من زعمائهم بأن التوسع يأتي بالوفرة في المواد، والوفرة بالتالي ستوفر ممارسة الشعب لحريته.
ويذكر باسيفتش أن ذروة العلاقة التبادلية بين التوسع وبين الوفرة والحرية جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما بزغت الولايات المتحدة الدولة الأقوى والأغنى والأكثر حرية -في نظر غالبيتها البيضاء- على الأقل. ثم إن العقدين التاليين لتك الحرب شهدا ترسيخاً لهذه الذروة فيما سمي آنذاك بـ"إمبراطورية الإنتاج" التي منحت الولايات المتحدة مستوى عاليا من الاكتفاء الاستراتيجي. غير أن نهم الأمريكيين في إمتاع الذات واندفاع الرئيس ليندون جونسون نحو التورط في فيتنام بإرسال قوات قتالية هناك سنة 1965 امتد نشرها هناك إلى العام 1973، رغم نهي سلفه الرئيس نيكسون عن ذلك، مثل، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية نقطة الانقلاب نحو ما سمي بـ"إمبراطورية الاستهلاك". وفي هذه الفترة برزت مؤشرات التردي كصدمة النفط الأولى التي فقدت معها الشركات الأمريكية سطوتها على سوق النفط لصالح كارتل (الأوبك)، كما اتضح للعيان انكشافية الاقتصاد الأمريكي حين شكلت سنة 1975 آخر سنوات تفوق صادراته على مجمل وارداته.
يشدد باسيفتش على أنه بحلول أواخر عقد السبعينات كان الأمريكيون في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، جاءت تعبيراً عن ثغرة مقيتة بين احتياجات مجتمع الإسراف الاستهلاكي وموارده المحدودة. وهذا الأمر طرح أمام الأمريكيين خيارين لا ثالث لهما، الأول: كبح جماح الشهوة الاستهلاكية والعيش في حدود الموارد، والثاني توظيف القوة الأمريكية المتضائلة آنذاك بفعل آثار الحرب في فيتنام والأزمة الاقتصادية لإجبار باقي العالم على التكيف مع نمط الحياة الأمريكية بتعويض النقص القائم في موارده.
يشير باسيفتش إلى خطابين رئاسيين إبان تلك الفترة روّج كل منهما لأحد الخيارين السالفين: دعا الرئيس جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 15 يوليو/ تموز 1979، ووسط أزمة اقتصادية شملت معظم فترة رئاسته وزاد منها وقوع الثورة لإسلامية في إيران في يناير/ كانون الثاني مطلع ذلك العام وما نجم عنها من "صدمة نفط ثانية"، دعا إلى الخيار الأول مذكراً بأن الأمة الأمريكية انحرفت عن الطريق القويم حيث "عديدون منا يميلون الآن إلى تقديس لاستهلاك والإشباع الذاتي"، وحيث "تقع الفكرة الخاطئة عن الحرية: حق جلب بعض المزايا لأنفسنا على حساب الآخرين". إن على الأمة –حسب كارتر- الشروع في مسار "الهدف المشترك لاستعادة القيم الأمريكية"، حيث الفكرة الصحيحة للحرية هي: "الحياة وفقاً لقيم دائمة، وتوطيد العزم في العيش على المتاح من الموارد". وطرح الرئيس في خطابه برنامجاً من ست نقاط لإنهاء الاعتماد المفرط على النفط الخارجي باعتبار أن "الطاقة ستكون الاختبار الفوري لقدرتنا على توحيد هذه الأمة". كان كارتر من وجهة نظر باسيفتش في هذا الخطاب رجل دولة ذا رؤية بعيدة، رغم أن كثيراً من الأمريكيين يرونه رئيساً غير كفؤ وسيئ الحظ. 
| " مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثماني عصراً من الرفاهية المبتذلة والإسراف المفرط بفضل تخفيضات الضرائب من جهة وزيادة الإنفاق العسكري من جهة أخرى. وهو الأمر الذي فاقم عجز الميزانية الفيدرالية " |
مثلت سنوات ريغان الرئاسية الثماني عصراً من الرفاهية المبتذلة والإسراف المفرط بفضل تخفيضات الضرائب من جهة وزيادة الإنفاق العسكري من جهة أخرى. وهو الأمر الذي فاقم عجز الميزانية الفيدرالية من متوسط 54.5 مليار دولار إبان سنوات سلفه إلى متوسط 210.6 مليار دولار خلال سنوات رئاسته، فصعد الإنفاق الفيدرالي إلى 1.14 تريليون دولار في العام 1989 بعد أن كان 590.9 مليار دولار في العام 1980، ووصل الاعتماد على نفط الخارج إلى 41% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
جاء إذن خطاب ريغان في 23 مارس/ آذار 1983 ليوضح -وإن بشكل متأخر- طبيعة الثورة التي جاء بها، حيث أعلن فيه عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي تعني بناء درع صاروخي منيع يجعل الأسلحة النووية للخصم عاجزة بل ومتقادمة. وفي هذا السياق أسس ريغان لثلاثة أعمدة ترتكز عليها السياسة الخارجية الأمريكية في القادم من الزمان، أولها: أن بقدرة الأمة استناداً إلى التقنيات الحديثة تحقيق مناعة عسكرية وهيمنة كونية طالما سعت إليه. وثانيها أن هذه القوة العسكرية، التي أطلق ريغان العنان لاستثمارات إعادة تحديثها، توفر الرد على الأزمة التي طرحها كارتر بقوة في يوليو/ تموز 1979 بالارتكاز على خيار تطويع العالم بغرض إدامة تدفق الموارد المادية المطلوبة لنمط الحياة الاستهلاكية للشعب الأمريكي دون أدنى تنازل. وثالث هذه الأعمدة أنها مهدت لتلك الحرب الكونية ضد الإرهاب التي سيطلق عنانها بوش الابن بعد عقدين قادمين.
يرى باسيفتش أن سنوات تبذير ريغان جاءت بتأثيرين قويين ومتناقضين إزاء السياسة الخارجية. أولهما: ثمة نجاح معترف به في أن الإنفاق العسكري الذي أطلقه الرجل بلا حدود جاء بانتصار حاسم في الحرب الباردة دفع في النهاية بتفكيك الإمبراطورية السوفيتية على خلفية قناعة تامة بعدم جدوى المنافسة مع الخصم الأمريكي. ثانيهما: أن الاعتماد المتصاعد على موارد الخارج، خاصة النفط، مهد الطريق إلى تورط عميق في العالم الإسلامي قاد في النهاية إلى حرب كونية مفتوحة بلا نهاية في أركان هذا العالم. وسياسات ريغان في دعم الإسلاميين في أفغانستان في مواجهة الاحتلال السوفيتي خلال عقد الثمانينات انتهت بنظام إسلامي متشدد انطلقت منه العمليات الإرهابية ضد الأراضي الأمريكية في صباح الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وانتهت كذلك بالجنود الأمريكيين أنفسهم هناك بعد عقد كامل من خروج السوفييت في موقف مشابه كقوة احتلال ضد شعب مجزئ تسكنه هواجس كراهية فطرية نحو المحتل الأجنبي. وهذه هي نفس السياسات الطائشة التي قادت الولايات المتحدة إلى جحيم الخليج وانتهت بكارثة غزو العراق في العام 2003 على يد بوش الثاني.
وقد يكون صحيحاً أن "عقيدة كارتر" في يناير/ كانون الثاني 1980 أسست لإعادة التوجه العسكري الاستراتيجي الأمريكي نحو الخليج لتأمين مصالح حيوية في هذه المنطقة، لكن ريغان الذي اتجه بجيشه الرائع الذي عمل على تحديثه ليس لاحتواء السوفيت كما روج ولكن إلى الخليج لمنع تكرار "الصدمات النفطية" وضمان تدفق دائم له يؤمن مطالب الإسراف الأمريكي في الداخل. ثم من خلال سياسات مشبوهة اتسمت بردود أفعال طائشة في دعم طرفي الحرب العراقية-الإيرانية أسس الرجل لكارثة أمريكية في الخليج سيتولاها أسلافه لا لتصحيحها ولكن لمزيد من التورط.
هكذا واجه بوش الأب دخول صدام إلى الكويت في أغسطس/ آب 1990، حيث قاد حملة عسكرية وفرت نصراً حاسماً أفرز في نهاية الأمر أوضاعاً هزلية تمثلت في التزامات جديدة ووجود عسكري على الأرض في الخليج، هدف لإبقاء الصدام داخل الصندوق، وطرح لأول مرة لدى العديد من العرب والمسلمين رؤية الولايات المتحدة كقوة احتلال قائم.
وهكذا أيضاً -كما يرى باسيفتش- جاءت سنوات كلينتون متسمة باعتماد سياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران، ومتسمة كذلك بشهية متصاعدة لاستخدام القوة الجوية وصواريخ كروز في إطار برنامج إنهاك عسكري دون التورط بقوات برية. وجاءت هذه السياسية لتعبر عن إستراتيجية غير مترابطة: حيث أبقت على النظام في العراق من جهة، وتمادت في فرض نظام عقوبات قاس يصعب الدفاع عنه أخلاقياً. وقد نتجت عن تلك العقوبات حياة بائسة لعامة الشعب العراقي وأدت إلى وفاة حوالي نصف مليون طفل كما جاء في تقرير لليونيسيف عام 1996. وقد علقت على ذلك وبصورة غير مسئولة آنذاك المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت بقولها "اعتقد أن هذا خيار صعب للغاية، ولكن الثمن.. يستحق ذلك"!، فالأمر القائم أنه لا شيء يهم طالما الأمريكيون في الوطن يتمتعون بعقد من الوفرة خلال حقبة كلينتون عندما كانت أسعار النفط منخفضة والنهم للبضائع الآسيوية الرخيصة واستهلاك النفط في تصاعد. لقد قفزت واردات النفط الأمريكية إبان تكلفة الفترة إلى نسبة 50% وزاد عدم التوازن في الميزان التجاري بمقدار أربعة أضعاف وأضيف إلى العجز الفيدرالي الكلي حوالي 1.5 تريليون دولار.
ومن ثم يرى باسيفتش أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عززت فقط قناعة الصقور من المحافظين الجدد في إدارة بوش الابن بأن هيمنة أمريكية صريحة في الخليج ما هي إلا ضرورة أمن قومي بالدرجة الأولى لإدامة نمط الحياة الأمريكية في الوطن الأم. وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في أكتوبر 2001 بقوله: "نحن أمام خيارين، إما أن نغير الطريقة التي نعيش بها أو أن نغير الطريقة التي يعيش هؤلاء الآخرون بها ونحن اخترنا الطريقة الثانية". وهكذا فإن ما لم يفعله الرئيس بوش الأب سنة 1991 فعله الابن سنة 2003 بالسير قدماً نحو بغداد لإزاحة النظام كمحطة أولى في مشروع أكثر طموحاً هو إعادة تشكيل العالم الإسلامي أو على الأقل ما أصبحت تشير إليه الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط الكبير. كل ذلك يتم وفقاً لأجندة الحرية الأمريكية التي تخفي وراءها أجندة توسع، تهدف إلى تحقيق الوفرة وعلاج أزمة الإسراف الأمريكية دون الحاجة لمواجهة الخلل الجاري في نمط الاستهلاك الشره في الداخل الأمريكي، بل ودون حتى تعبئة هذه الأمة في حرب كونية ضد الإرهاب شرعت فيها الإدارة الأمريكية. فالرئيس الابن ظل مصراً على خفض الضرائب وعلى دعوة مواطنيه للانغماس في الترف والتسوق، وعلى عدم إعادة التفكير حتى بإعادة نظام التجنيد الإجباري لعلاج الجهد الهائل الواقع على أفراد عسكريين لا يتجاوز عددهم 0.5% فقط من تعداد الشعب الأمريكي.
هكذا وجدت الولايات المتحدة نفسها بجنود يقاتلون معارك يائسة في العراق وأفغانستان، وشعب يمارس نمط حياته الإسرافية في الداخل، وإدارة عاجزة أحياناً وغير راغبة في الغالب في تحويل إمبراطورية استهلاك إلى إمبراطورية تحرير كونية كما تزعم. ومع تصاعد فاتورة الحرب المادية والبشرية في الخارج وتعاظم فاتورة العجز بثغرة متفاحشة بين الاحتياجات والموارد في الداخل تبدو حقيقة هذه القوة العظمى العاجزة عن إدراك كون علاج مشكلاتها هذه يكمن في داخل الوطن الأمريكي ذاته وليس في الخليج.
| " كشفت عنها أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عن أسباب الفشل في سياسات الأمن القومي الأمريكية، وما تلا ذلك من تورط في حرب كونية بلا نهاية في الأفق القريب وبلا حدود دنيا للتكلفة البشرية والمادية والأخلاقية " |
ولتمحيص الخلل في النظام السياسي الأمريكي وجوهر أزمة السياسة يتناول باسيفتش ثلاثة أبعاد أساسية: فكرية تتناول أيديولوجية الأمن القومي، وتنظيمية تستعرض مؤسسة الأمن القومي في الولايات المتحدة، وأخيراً شخصية تتعامل مع نوعية الرجال الحكماء المؤثرين في السياسات الخارجية لهذه القوة العظمى.
في البعد الأول الفكري الخاص بأيديولوجية الأمن القومي يرى باسيفتش أن أسباب الفشل في سياسات الأمن القومي الأمريكية، والتي كشفت عنها أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وما تلاها من تورط في حرب كونية بلا نهاية في الأفق القريب وبلا حدود دنيا للتكلفة البشرية والمادية والأخلاقية، أن أسباب الفشل هذه لا تكمن فقط في نوعية استجابة إدارة بوش لهذه الأحداث وابتكارها ردودا جديدة أكثرها شهرة وأسوأها أثراً "عقيدة الحرب الوقائية"، ولكن وبالأساس ذلك السياق الأيديولوجي لمفهوم الأمن القومي الذي التزمت به كل الإدارات الأمريكية السابقة لإدارته. وكان فضل بوش المعترف به هو صياغته وإعلانه لها بهذه الدرجة من التوهج والحماس والوضوح. وهذه الأيديولوجية المؤسسة على قناعات أربعة أبرزها الرجل في خطاب تنصيبه الثاني في 20 يناير/ كانون الثاني 2005، أولها: أن "التاريخ لديه حتمية واضحة محددة وهي الحرية"، وثانيها أن الولايات المتحدة "منذ لحظة تأسيسها هي التجسيد الدائم للحرية"، وثالثها أن الخالق استدعى الولايات المتحدة لتحقيق النصر النهائي للحرية "إنها المهمة التي من أجلها خلفت هذه الأمة". أما آخر هذه القناعات وأهمها فهو أن "المصالح الحيوية الأمريكية ومعتقداتها العميقة هي الآن مسألة واحدة". وهو ما يعني أن سعي الولايات المتحدة وممارستها التأثير خارج حدودها، أياً كانت الأدوات، يجد تبريره الأخلاقي في كونه عملاً من أجل الحرية، بدءاً من عمليات التوسع التي مارسها الرئيس جيمس بولك في منتصف القرن التاسع عشر ووصولاً إلى غزو العراق وأفغانستان في مطلع القرن الحادي والعشرين.
هكذا إذاً توظف أيديولوجية الأمن القومي في السياق الأمريكي إذ هي الضامن الشرعي لكل ممارسات السلطة التنفيذية، ومصدر الامتيازات الواسعة للرئيس الإمبراطوري ودائرته المقربة في متى وكيف يتم استخدام القوة، ثم هي الوسيلة النافذة لإضفاء المظهر الأخلاقي الجذاب لكل ممارسات تحقيق المصالح الحيوية في الخارج طالما كان الغطاء لها السعي من أجل الحرية والديمقراطية.
في البعد الثاني التنظيمي الخاص بمؤسسة الأمن القومي الأمريكية والتي حددها باسيفتش في أجهزة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ومكتب وزير الدفاع ورئاسة الأركان والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات المختلفة ومكتب المباحث الفيدرالية. يرى الرجل أن كلا من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تشاركان معاً منذ الحرب العالمية الثانية في خلق هذه المؤسسة المتضخمة التي هي في سعي دائم للتوسع التنظيمي والوظيفي. ويشير باسيفتش إلى ثلاث سمات رئيسية لهذه المؤسسة أولها: تقديس السرية في عملها ظاهرياً بدعوي العمل ضد خصوم الولايات المتحدة وفعلياً بهدف التحكم في تدفق المعلومات للداخل الأمريكي لخدمة ما تراه أو ترغب فيه، ولتوجيه الرأي العام نحو ذلك. ثانية هذه السمات: تقديم المصلحة المؤسسية على حساب المصلحة العامة للأمة. والثالثة والأخيرة: التضليل المعلوماتي لخدمة أغراض سياسية على غرار ما حدث في مسألة الزعم بحيازة العراق لأسلحة دمار شامل أو بتقليل حجم الخسائر في المدنيين في كل من العراق وأفغانستان، وإعفاء الزعماء السياسيين والقادة العسكريين الكبار من الخلل الاستراتيجي والميداني في عمليات الخارج.
ويبدو أن عثرات أزمة خليج الخنازير في العام 1961 والتي كشفت عورات كل من وكالة الاستخبارات المركزية ورئاسة الأركان معاً أمام الرئيس كيندي ودفعته إلى ثلاثة ردود أفعال قوضت بالفعل من الدور البيروقراطي التشاوري لهاتين المؤسستين والتزم بها كافة الرؤساء الأمريكيين فيما بعد. وقد تمثلت ردود أفعال كيندي في تغيير قيادات هذين الجهازين بأشخاص يتوافر فيهم الولاء والثقة لشخص الرئيس، ثم خلق بديل استشاري من خارج هذه المؤسسة يوفر للرئيس نصحاً ذا مصداقية، وأخيراً تأسيس كيانات خاصة لإدارة كل أزمة علي حدة.
هكذا ومنذ كينيدي يرى الرؤساء الأمريكيون في مؤسسة الأمن القومي كياناً معطوباً يصعب إصلاحه ويجب الالتفات حوله، لكنَّ بقاءَه في نظرهم يظل أمراً مطلوباً لأنه يوفر المنطق الدائم لترتيبات سياسية معينة هي مصدر للمكانة والتأثير وللثروة معاً.
ويبدو أن هذا ما فعلته تماماً إدارة بوش وهي في طريقها لشن حربها الكونية في استجابتها على أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول حيث عمدت إلى تهميش عناصر مؤسسة الأمن القومي المثيرة للمشكلات كما حدث على نحو خاص مع وزارة الخارجية ووزيرها كولين باول. أو تنصيب موالين لها في المناصب الكبرى دون اعتبار لمدى أهليتهم لذلك وهو ما حدث بتعيين متتال لرؤساء أركان من جنرالات متوافقين ومتوسطي القدرة من أمثال ريتشارد مايرز وبيتر باس. وكذلك الإبقاء على جورج تينيت مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية رغم ثبوت فشله في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول حيث المهم هو أن الرجل شغوف بقول ما يريد الرئيس سماعه. وأخيراً الالتفات كلما أمكن حول مؤسسة الأمن القومي بكاملها وهو ما وضح في إنشاء الوزير رامسفيلد لمكتب الخطط الخاصة OSP الذي سيتولى مهمة اصطناع أدلة حول برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية توفر مبررات شن حرب على هذا البلد.
في البعد الثالث الشخصي الخاص بنوعية الرجال الحكماء النافذين في رسم وصياغة السياسة الخارجية والذين يشكلون الدوائر الصغيرة للمشورة والنصح حول رئيس إمبراطوري يعتبرهم أفضلية مقارنة مع بيروقراطية صعبة المراس مسربة للمعلومات هي مؤسسة الأمن القومي. يرى باسيفتش أن هذه الظاهرة الحديثة في النظام السياسي الأمريكي بلغت ذروتها في إدارة فرانكلين روزفلت إبان أحداث الحرب العالمية الثانية عندما برزت في واشنطن أسماء لامعة تحلقت حول الرئيس في مقدمتها وزير الخارجية ووزير الحرب فيما بعد هنري ستمسون، واتسمت بالاستقامة والحكمة والرصانة وردود الأفعال المعتدلة، وشكلت فيما بينها وجه واشنطن آنذاك. ويشير باسيفتش إلى تحول نحو الأسوأ وقع في سبتمبر/ أيلول 1945 بتولي جورج فورستال وزارة الحرب الأمريكية خلفاً لهنري ستمسون حيث مثل بتركيبته الشخصية المعقدة مزيجاً من عدم الاستقرار وسوء التقدير في المواقف والأزمات والجموح للرد العاجل عند بروز أدنى خطر. وسيؤسس هذا الوضع لوجه واشنطن الجديدة القائم إلي الآن عبر سلالة من أتباعه وتلاميذه الذين تحكمهم عقلية عسكرية ترى في القوة أداة مثالية لحل مشكلات العالم ويشوبهم قلق عصبي من أن الوضع الأسوأ هو الاحتمال الأرجح وأن العمل العاجل السريع لإحباط كارثة قادمة أمر لا مفر منه.
يشير باسيفتش إلى بول نيتزه كوريث مباشر لفورستال الذي هيمن على سياسات الأمن القومي الأمريكية على مدى أربعة عقود تالية، وكانت أبرز مساهماته وثيقة الأمن القومي NSC 68 التي تمثل أحد أهم الوثائق المؤسسة لإدارة الدولة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تقرير سري قدم للرئيس هاري ترومان في ربيع عام 1950 لتوصيف الوضع وطرح الخيارات الإستراتيجية في مواجهة حدثين اعتبرهما الرئيس على درجة بالغة من الأهمية للأمن القومي الأمريكي، أولهما: نجاح السوفيت المفاجئ في أغسطس/ آب 1949 في تفجير جهاز نووي أنهى الاحتكار النووي للولايات المتحدة، وثانيهما: نجاح الثورة الشيوعية في الصين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من ذات العام. وقد نجح نيتزه بأستاذية، ليس فقط في تمرير توصياته في الشروع بإعادة بناء متسارعة وهائلة للقوة العسكرية الأمريكية والتي مثلت الخيار الثالث في عرضه للموقف بعد استبعاد خياري الانعزالية أو الإسراع بشن حرب وقائية، وهو ما أطلق عليه آنذاك "عقيدة نيتزه". ولكن نجاح نيتزه الحقيقي كما يراه باسيفتش أنه أسس نموذجاً يقتدي به الرجال الحكماء من نخبة الأمن القومي الأمريكي إلى الآن والذي يشمل على أركان أربعة أولها شيطنة الخصوم، وثانيهما استخدام أسلوب استعراض الخيارات المصطنعة التي تدفع نحو نتائج معدة سلفاً تجعل من المحلل صاحب القرار عملياً. وثالثهما توظيف القيم المثالية كالحرية والسلام للتمويه على المصالح الحيوية الأمريكية، وأخيراً بث الذعر بأساليب عدة لدفع عملية صنع القرار دون إبطاء.
هكذا وجدت أحداث الحادي عشر سبتمبر/ أيلول في انتظارها بول ولفيتز الوريث المباشر لبول نيتزه كما كان الأخير وريثاً مباشراً لجورج فورستال. كان ولفيتز آنذاك الرجل الثاني في وزارة الدفاع في إدارة الرئيس بوش وكان الحدث مبرراً لدى الرجل لإطلاق القوة العسكرية والدعوة بعد ساعات فقط من وقوعه لغزو العراق وإزاحة صدام حسين. لم يكن هدف ولفيتز العراق ونظامها تحديداً بقدر ما كان هدفه وضع معايير جديدة أقل تقييداً لاستخدام القوة العسكرية تعتمد الحرب الوقائية على مستوى كوني كـ"حملة واسعة ومستمرة ضد كل الدول التي تشكل ملاذات آمنة للإرهابيين أو تدعمه". وهو بذلك تجاوز رفض أستاذه نيتزه للحرب الوقائية كمسألة غير أخلاقية، ومن ثم فالتاريخ سيذكر الرجل ليس فقط كمهندس لحرب العراق بقدر ما أنه المسئول عن شرعنة الحرب الوقائية كمبدأ أساسي في السياسة الأمريكية، فضلا عن كونه الملهم لـ"عقيدة بوش الوقائية" باعتبارها أخطر مبادرات الأمن القومي الأمريكية منذ تدشين مشروع مانهاتن لبناء أول قنبلة نووية. وقد أسست هذه "العقيدة" لحرب كونية مفتوحة بلا نهاية، لا في الزمن ولا في التكلفة، بدأت في أفغانستان ومروراً بالعراق ولم تنتج حتى الآن سوى حطام سفينة أمريكية.
| " إن ثقة إدارة بوش المفرطة بفعالية القوة العسكرية الأمريكية كانت أمراً مبالغاً فيه وتقديراً استراتيجياً سيئاً أدى بالولايات المتحدة إلى دفع أثمان بشرية ومادية غالية " |
إن ثقة إدارة بوش المفرطة بفعالية القوة العسكرية الأمريكية كانت أمراً مبالغاً فيه وتقديراً استراتيجياً سيئاً أدى بالولايات المتحدة إلى دفع أثمان بشرية ومادية غالية. وثبت أنه حتى في عصر تقنية الستيلث ("stealth": تكنولوجيا لا زالت سرية وتسمح للقاذفة الطيران فوق الرادارات المعادية دون اكتشافها)، والذخائر الدقيقة، والاتصالات الفورية فإن القوة العسكرية ليست هي الدواء العام لكل الأمراض، وأنه حتى في عصر القطبية الواحدة تبقى لتلك القوة حدودها وأوجه قصورها.
يطرح باسيفتش في البدء ثلاثة أوهام كبرى دفعت لهذا التقييم الأمريكي المفرط لجدوى القوة العسكرية الأمريكية. أولها: أن الولايات المتحدة ابتكرت طريقة أمريكية جديدة للحرب تأسيساً على معطيات نجاحاتها التقنية والعملياتية في جعل قواتها أكثر دقة وتمييزاً، ومن ثم أعمق إنسانية في ممارستها للصراع المسلح. وهو ما أشار إليه الرئيس بوش بشيء من الثقة بقوله "بخليط من استراتيجيات مبتكرة وتكنولوجيات متقدمة فإننا قد أعدنا تعريف الحرب وفقاً لشروطنا.. في هذا العصر الجديد من القتال يمكننا استهداف نظام وليس أمة".
ثاني هذه الأوهام: أن هناك الآن مجموعة مبادئ يتشارك فيها الزعماء المدنيون والقادة العسكريون الأمريكيون حول استخدام القوة العسكرية الأمريكية، وهي المبادئ التي عبرت عنها بصورة رسمية "عقيدة واينبرغر/باول " التي حددت معايير أساسية حول متى وكيف يتم استخدام هذه القوة، حيث الولايات المتحدة ستقاتل فقط حال تعرض مصالحها الحيوية للخطر. وأن الأهداف ستكون محددة ويمكن تحقيقها. وأن الموارد المطلوبة ستعبأ لتحقيق نصر سريع وحاسم يتبعه خروج فوري برشاقة ودون نهايات رخوة.
ثالث هذه الأوهام: أن العسكرية الأمريكية والمجتمع الأمريكي بتوافقهما على صيغة القوة العسكرية الكل تطوعية قد عالجا مظاهر الانشقاق التي حدثت إبان حرب فيتنام، حيث يبقى للعملية العسكرية الآن احترافيتها المهنية، ويظل للمواطن الأمريكي العادي حريته الفردية في اعتبار الخدمة العسكرية مسألة خيار شخصي.
يشير باسيفتش إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وما تلاها كشفت زيف هذه الأوهام الثلاثة، فطريقة الحرب الأمريكية الجديدة أبرزت عورات هائلة في ميادين القتال، والتوافق المدني/العسكري حول مبادئ استخدام القوة العسكرية قد أجهض أحياناً لصالح رؤية الزعماء المدنيين، وأحياناً أخرى لصالح احتكار الجنرالات العسكريين، بينما بدأ انصراف الأمريكيين لنمط حياتهم العادية وسط حرب كونية تشنها بلادهم على تخوم بعيدة دليلاً على وهم مصالحة المجتمع الأمريكي مع مؤسسته العسكرية.
يقودنا باسيفتش في سبر غوره لأزمة العسكرية الأمريكية إلى استعراض الدروس الخاطئة الثلاثة التي ذهبت إليها معظم التحليلات والدراسات العسكرية لما واجهتة ومارسته العسكرية الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. بل نجده يصفها بالأوهام الجديدة التي تتساوى في خطورتها مع تلك التي عرضها آنفا.
أول هذه الدروس: أن الحروب الصغيرة على نحو ما جرى ويجري في العراق وأفغانستان من قتال للتمرد وبناء الأمم ستكون هي شكل الحروب القادمة التي على العسكرية الأمريكية التهيؤ لها على حساب الحروب التقليدية الكبيرة الحجم على غرار ما حدث في حرب "تحرير الكويت" سنة 1991 والتي ستكون الاحتمال الأقل.
ثاني هذه الدروس: هو إعادة مجال الحرب لرجال العسكرية المحترفين من الجنرالات الكبار وعدم تقييدهم بتدخلات زمرة مدنيين لا يدركون طبيعة الحرب وجوهرها كما فعلوا من قبل إبان حرب فيتنام.
ثالث هذه الدروس: إصلاح العلاقة بين المجتمع الأمريكي وعسكريته وذلك بنبذ مسألة القوة الكل تطوعية القاصرة على متطوعين محترفين وعودة نظام التجنيد الإجباري ومن ثم تقليد الجندي/المواطن مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيعالج مشكلات عملياتية مرتبطة بنقص أعداد الجنود المطلوبة، ومشكلات سياسية خاصة بغياب الاهتمام الشعبي بالحرب والرقابة الشعبية لها، فضلاً عن مشكلات أخلاقية أهمها عدالة توزيع التضحية في القضايا الوطنية للأمة.
في تفسيره لخطأ الدرس الأول يرى باسيفتش أن السمة المميزة للحروب الصغيرة ليس في مداها أو مدتها وإنما يكمن في غرضها. فهي بطبيعتها حروب امبريالية تشنها القوي الكبرى ليس دفاعاً عن نفسها وإنما لتأكيد هيمنتها على شعوب أخري. والحديث عن أن هذا النوع من الحروب يحدد المستقبل العسكري للقوة الأمريكية يتجنب الإجابة عن السؤال الأكبر حول جدوى الاستمرار في هذه الحروب على ضوء نتائج تكلفتها المريرة في العراق وأفغانستان. فلماذا إذاً لا نسعى لتغيير سياستنا لتكون أكثر واقعية وقابلية للتحمل بدلاً من الاعتماد على قوة عسكرية تأكدت محدودية فعاليتها؟!
ويذهب بنا باسيفتش في شرحه لخطأ الدرس الثاني، إلى أنه وعلى عكس المطروح من القول بأن الجنرالات العسكريين حرموا حرية التخطيط ومرونة التنفيذ في ممارستهم لقيادة جيوشهم في العراق وأفغانستان، فإن قراءة فاحصة لمذكرات الجنرال تومي فرانكس بعنوان "جندي أمريكي" تشير إلى أن الرجل كان المسئول الأول منذ البداية إلى النهاية عن حرب العراق وأفغانستان، وأن خطط غزو هذين البلدين عكست بالكامل مفهومه لشن الحملات العسكرية. ومن ثم فإن الأخطاء التي حصدتها الولايات المتحدة في هاتين الحربين -وما زالت- هي حصاد تدني نوعية القيادات العسكرية العليا لديها كسياق عام لا يقتصر فقط على أحداث ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ولكنه يمتد ليمثل ظاهرة كاملة الدلائل في حقبة ما بعد الحرب الباردة. والشاهد على ذلك عثرات كل من الجنرالين شوارتسكوف وباول إبان حرب "تحرير الكويت" سنة 1991، وويسلي كلارك في حرب كوسفو في البلقان سنة 1999، وفيما بينهما الأخطاء الفادحة للجنرالين توماس مونتغمري وويليام جاريسون في مقديشو سنة 1993 والتي أدت إلى انهيار سياسة إدارة الرئيس كلينتون في الصومال بكاملها.
في تفسيره لخطأ الدرس الثالث والخاص بضرورة عودة نظام التجنيد الإجباري، يرى باسيفتش أن كلا من التكلفة المادية الباهظة المطلوبة لمضاعفة حجم قوة الجيش الأمريكي وانعكاساتها على ميزانية الدفاع السنوية التي قد تصل آنذاك إلى مستوى تريليون دولار سنوياً هو أمر يصعب تحمله. كذلك فإن الجنرالات والأدميرالات الكبار في العسكرية الأمريكية يرون في هذه النوعية من الجنود إشكالية أكثر من عائد قيمة عملياتية قد يحصدونها منهم، ويبدو أن توجه البنتاغون نحو شركات الأمن الخاصة أو ما أصبح يعرف بجيوش المتعاقدين الأمينين هو مؤشر على استبعاد تكرار مسألة التجنيد الإجباري مرة أخرى.
في النهاية يقودنا تحليل باسيفتش الخصب عن أزمة العسكرية الأمريكية إلى حقائق أربع يرى فيها أنها الدروس الصحيحة في كل ما جرى من أحداث وجاء من نتائج في استخدام هذه القوة العسكرية بهذه الصورة التي شهدها العالم في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أول هذه الحقائق أن للحرب طبيعتها الدائمة والثابتة والتي يصعب السيطرة عليها أو محاولة كبحها، فالحرب خليط من عدم اليقين الكامل والخطر وهي عالم الفرصة كما ذكرها المنظر العسكري الروسي الأشهر فون كلاوز فيتز منذ قرنين من الزمان. والحديث عن كون تطورات تقنية أفرزت الحاسبات والإنترنت وذخائر التوجيه الدقيق قد أحدثت تغييراً في طبيعة الحرب هو محض افتراء ودليل خطأ تعثرت فيه رؤى ساسة وتصورات ضباط الكبار. ويكفي في هذا المجال الإشارة فقط إلى ما فرضته استخدامات العبوات المتفجرة البدائية الصنع من خسائر وقيود علي القوات الأمريكية ومعها الحليفة في ميادين قتال الشرق الأوسط لتؤكد على أن الحرب تظل اليوم، كما كانت دائماً، مراوغة وغير مروضة، مكلفة، صعبة السيطرة، مليئة بالمفاجآت وتطرح نتائج غير متوقعة، بينما يبقي المعتوهون فقط هم من يتصورون غير ذلك.
ثاني هذه الحقائق: الجدوى المحدودة للقوة العسكرية، فسواء أهدفت الولايات المتحدة من وراء استخدامها هذه القوة تحقيق أجندة الحرية في العالم الإسلامي، أو إحكام سيطرتها عليه وإخضاعه، فإن الثابت أن هذه القوة لم تحرر شعوب الشرق الأوسط الكبير ولا وضعت قبضة الولايات المتحدة على طريق الهيمنة عليه. ويبقى الأمر المنتظر تورطاً مستمراً لسنوات وعقود قادمة هناك دون نتائج حاسمة فقط بتكاليف دائمة وانشقاقات متتالية في جهة التحالف الغربي.
ثالث هذه الحقائق هي حماقة الحرب الوقائية أو ما يعرف بـ"عقيدة بوش"، فعلى مدى زمن طويل ابتعدت الولايات المتحدة عن فكرة الحرب الوقائية لمواجهة تهديد وشيك لاعتبارات أخلاقية وإستراتيجية معاً. وحتى عندما أنهى السوفييت في العام 1949 الاحتكار الأمريكي للسلاح النووي وطرحت جهات في الداخل الأمريكي أفكارا عن خيار تنفيذ ضربة أولى وقائية لإزالة ذلك الخطر النووي مرة واحدة وللأبد اعتماداً على تفوق استراتيجي حازم آنذاك فإن النظرة الحذرة وقتها لتبعات هذا العمل جنبت الولايات المتحدة والعالم معاً حريقاً نووياً هائلاً، لكن تلك النظرة الحذرة غابت عن هؤلاء الحمقى الذين هيمنوا على الإدارة الأمريكية فيما بين العامين 2002 و 2003 ليقودوا الولايات المتحدة إلى حرب كونية بلا نهاية وبتكاليف فاقت بكثير توقعات أي من هؤلاء الحمقى.
آخر هذه الحقائق هو أن المستويات العليا في الحكومة والعسكرية الأمريكية يفتقدان فن الإستراتيجية صياغة وتنفيذاً؛ الأمر الذي يشكل معضلة جوهرية فشلت الولايات المتحدة في مكافحتها منذ أن حرمها انهيار الاتحاد السوفيتي من خصم مستقر، وفاقم الأمر فيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول. ويرجع باسيفتش الأمر إلى قصور في كلتا النخبتين السياسية والعسكرية معاً، فالنخبة السياسية التي عليها تقع المسئولية الرئيسية في صياغة الإستراتيجية الكبرى استغرقت في خلط الأوهام الأيديولوجية حول تحقيق هيمنة كونية وتشكيل العالم على صورة أمريكية بخطوط الإستراتيجية الكبرى. بينما قصرت النخبة العسكرية دورها على المسائل العملياتية المرتبطة بالحملات والمعارك وجعلت من مجال الحرب بكامله منطقة استثنائية قاصرة عليها فقط وتناست أن القتال بالطبع هو جزء من الحرب ولكنه ليس كل الحرب التي تبقى في الأساس عملاً سياسياً بالدرجة الأولى حيث يبقى تبرير شنها وجدوى عوائدها مسألة خاصة بالسياسيين الذين تنازلوا عن ذلك في واشنطن. 
_______________
باحث عسكري وضابط سابق في الجيش المصري