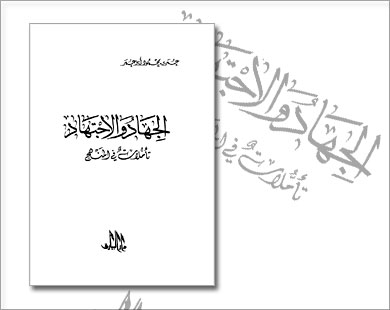تتأكد أهمية دراسة هذا الكتاب من ذلك الاهتمام المتزايد بدراسة ظاهرة الحركات الجهادية السلفية عقب أحداث 11 سبتمبر، ولكون الكتاب يحوي المضامين الأساسية لفكر عمر بن محمود المعروف بأبو قتادة الفلسطيني، أحد أبرز الرموز الفكرية لجماعات الجهاد السلفية، إلا أن الإضافة النوعية لهذا الكتاب تتأتى من المهارات التنظيرية للكاتب، وقدرته على بلورة تأصيل شرعي للفكر الجهادي والعمل العسكري، وهذا ما يجعله على درجة كبيرة من الإقناع والتأثير. ومن ناحية ثانية، تبرز خطورة هذا الكتاب في توجيهه للقوى القتالية السلفية بالتركيز على الحكم بردة الأنظمة والحكومات الإسلامية والشروع المباشر بقتالها خلافا لأفكار الشيخ عبد الله عزام وأنصار جهاد "العدو البعيد".
قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، يتعلق القسم الأول منها بدراسة أبرز القضايا والمفاصل الفكرية التي عالجها الكتاب، بطريقة وصفية حيادية لا نقد فيها ولا تفنيد، وأما القسم الثاني فقد جاء نقديا يناقش القضايا التي يختلف فيها الباحث مع الكاتب.
القسم الأول : الدراسة الوصفية للكتاب
القسم الثاني: الدراسة النقدية لكتاب (الجهاد والاجتهاد)
القسم الأول
الدراسة الوصفية للكتاب
تبدأ مقدمة الكتاب بتوضيح علاقة الجهاد بالاجتهاد، وأن "الله قد جعل المؤمنين قسمين: مجاهد ومجتهد، ولا خير فيمن سواهم، والمجاهد مجتهد والمجتهد مجاهد، وغاية كل من المجاهد والمجتهد هي تعبيد الناس لله وحده وإزالة الطواغيت كلها من الأرض".(1)
الجهاد في مجتمعات معاصرة
الإضافة النوعية لهذا الكتاب تتأتى من المهارات التنظيرية للكاتب، وقدرته على بلورة تأصيل شرعي للفكر الجهادي والعمل العسكري، وهذا ما يجعله على درجة كبيرة من الإقناع والتأثير |
ونظراً لوصفه بلاد المسلمين بأنها "بلاد ردة"،(3) وبلاد الغرب بأنها "بلاد كفر"، فإنه يرفض أي حوار أو ندوات أو مؤتمرات تتحدث عن "علاقة الإسلام بالغرب"، ويرى فيها "ترويضاً للإسلام"، وإزالة لموانع "الغزو الحضاري الغربي الكافر، ودعوة إلى الحرية والإباحية والديمقراطية".!
جذور الصراع وأدواته
والنظرة الصراعية للكاتب تتجاوز الإنسان وتعود به إلى الصراع بين إرادة الله وبين إرادة الشيطان،(4) فهي من سنن الله التي فطر الخلق عليها، والله قد شرع للمسلمين الجهاد حتى يزيلوا الباطل ويجتثوه من جذوره حتى لا تقوى أصوله.
والعلاقة بين الحق والباطل هي علاقة صراع، فهما لا يجتمعان ولا يلتقيان، وإن عدم جهاد الباطل ناتج عن جهل طبيعة الباطل، وهذا عنده هو حال كثير من الجماعات الإسلامية التي تنكر الجهاد أو تدعو إلى تأجيله. (5)
ويرى الكاتب أن مسألة التمكين هي مهمة الإسلام العظمى، وينتقد كل من لا يجعلها كذلك، أمثال ربيع المدخلي في كتابه "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله"، لأنه يقرر أن الإمامة ليست من قواعد أهل السنة والجماعة.(6)
والجماعة المهتدية هي جماعة القتال، وهي جماعة يجتبيها الله، وهي التي تحقق التمكين، خلافاً لجماعات التزوير (كما يصفها الكاتب) وهي التي تهتم بالعمل السياسي أو بتحقيق التراث أو بالتربية.
وأما الفصل الثاني من الباب الأول فيتعرض لقضية الجماعة والإمامة، ويبدأ بالحديث عن معضلة "الجماعة وشرعيتها"، (7)وهي إشكالية دخل فيها أهل السنة، بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وأصبحت عائقاً أمام بلوغ أهدافهم.
ويرى أن مشكلة أهل السنة، في أحد أهم جوانبها، تكمن في اعتبار دخولهم تحت مسمى الجماعة بمجرد وجودهم تحت راية إمام مُتمكِّن، وهذا الفهم يراه المؤلف بعيداً عن الفهم الصحيح لمفهوم الجماعة عند السلف.
ثم يتعرض المؤلف لتأكيد " شرعية التنظيم " وينتقد الشعارات التي تنتقد الحزبية في الإسلام، ويعتبرها مشكلة "مألوفة لدى المسلم السنّي المتخلف".(8)
وفي سعيه للتعرف على معنى الجماعة عند العلماء، يشير إلى مفهومين اثنين، الأول: هم المسلمون المنضوون تحت راية إمام متمكّن، والثاني: هم أهل الحق، والمفهوم الثاني هو أضيق من الأول، وأهل الحق هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعيدون بناء الأمة إذا سقطت.(9)
التغيير الجذري للواقع
الغاية التي يبحث عنها المؤلف، هي " التغيير الجذري والانقلاب الشامل" (10). ويشير إلى المنطلق العقدي والديني وراء هذه النظرة الثورية للواقع فيقول "إن القضية التي لا يمكن تنازل المرء عنها، وهي التي تحمل المرء على الرفض الكلي للخصم، هي ارتباط الخصومة بما يسمى بالعقيدة والدين".(11)
فالصراعات العقائدية لا تنازل فيها ولا مساومة، ويرى أن الخصومة تبلغ أعلى درجاتها عندما يقتنع المرء بالضلال الكلي لخصمه.
ويسعى الكاتب إلى إظهار (حركة الجهاد) كحركة شمولية حضارية منبثقة من مفهوم التوحيد وتحمل بعداً تاريخياً في فهمها بكبوات الأمة الفكرية والنفسية وتملك رؤية مستقبلية.
يعرف الكاتب الحركة الجهادية الأنموذجية (الأصل) بأنها "حركة سلفية، التصور والرؤى، سلفية المنهج والطريق، بريئة كل البراءة من الإرث المنحرف في فكر الأشاعرة والماتريدية، سليمة كل السلامة، من آثار المنهج الصوفي الضال" .
ويشير الكاتب أن حركات "الإقدام" نحو الجهاد تأتي في أغلب الأحيان من خارج هذه الحركات الإسلامية، وممن هم غير قريبين من المركز، كما يتوقع المؤلف أن حركات التصادم مع (الطواغيت) سيقع فيها ما وقع في الحركات الإسلامية السابقة، من حيث دور اللاحقين،(12) والذي هو البحث عن الأدلة في تبرير قول المتقدمين.
ويوصي الكاتب الحركات الجهادية بأن تنظر إلى شمولية المكان واتساعه، لأنه يتوقع أن تفتح أماكن جديدة للجهاد، وأن تجعل لها أماكن للإعداد فقط، وأخرى للقتال والمواجهة(13).
تحتاج الحركة الجهادية السلفية إلى مجموعة من العوامل الذاتية، للوصول إلى النتائج والأهداف، ومن هذه العوامل أن لا تصبغ الشرعية على الواقع ولا تستعطف الكفر (كما هو الحال مع غيرها من الجماعات)، بل تتمرد عليه وتسعى إلى هدمه، وخلافاً للجماعات التي تنطلق من (فقه الاستضعاف)،(14) وعدم القدرة على الإعداد والصبر وكف الأيدي، فإن الحركات الجهادية تنطلق من الجهاد وتجعل الاستضعاف حالة استثناء.
وفي حديثه عن جذور الحركات الجهادية في العالم الإسلامي، يرى بأنها متشعبة ومتعددة ولا تعود إلى جهة واحدة، وأنها ظهرت في معظم البلاد التي حكمها الإسلام، لكنه يشير إلى مشكلة عدم التواصل بين هذه الحركات، مما يؤدي إلى عدم استفادة بعضها من بعض.
وأما الأسس الشرعية التي تدفع الحركات الجهادية للنشوء، فهي:
أولاً: انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر وردة.
ثانياً: وجوب جهاد طوائف الكفر والردة.
ويؤكد على أن قتال طوائف الردة حتى تزول أو تعود إلى الإسلام هو فرض عين على القادر، وإن عدمت القدرة وجب الإعداد للقتال وإن لم يستطع الإعداد وجبت الهجرة.(15)
وفي تسويغه للقتال واستعمال القوة، يذهب إلى أن كلمات الله التشريعية، والعاطفة الجبلية، موانع للمعصية، ولكنها غير كافية، فجاء التشريع الأخير فيه الحق المطلق بردع العاصي،(16) ويقول بالحرف الواحد "لأن المسلمين هم قوم يتقربون إلى الله بذبح أعداء الله، فالذبح سجيتهم، وبه يكون العالم سالماً من المعاصي والذنوب". (17)
جهاد الطلب
ينتقد الكاتب قصر الجهاد على جهاد الدفع، ويشير في هذا الخصوص إلى كتاب محمد رمضان سعيد البوطي، ويرى أن هذا الرأي يؤدي إلى إنكار حد الردة، ويرجع سبب الاختلاف في هذه القضية إلى الخلاف في المنهج، فهو يرى أن أتباع هذه المدرسة اضطروا حتى ينسجموا مع منهجهم أن يقولوا: "بترك عداوة أعداء الملة والدين".(18) فالعداء مع غير المسلم عند الكاتب متحقق لكونه كافرا، وهذا الكفر يوجب حربه وقتاله، ولا يفرق بين المحارب منهم وغير المحارب، عداوتهم هي من أسس التوحيد،(19) وليست مسألة خاضعة للنقاش.(20)
قيادة الحركات الإسلامية
يشير الكاتب إلى أن أشد القضايا صعوبة لدى الحركات الإسلامية هي عدم وجود القائد المناسب، وأن الطرق التي اتبعتها الحركات الإسلامية لإفراز القيادات هي طرق فاسدة وخاطئة.(21)
وفي العلاقة بين القيادة والقاعدة يتحدث عن مشكلة "الجماعة المسلحة" في إيجاد الاحترام بين أفرادها على العموم، وبين قواعدها والقيادة على وجه الخصوص، وكيف توفق في ذات الوقت في إيجاد المدى الأقصى من القدرة على احترام "العقل الذاتي" والإرادة المستقلة؟.(22)
المعركة مع المرتدين
تشكل قضية الردة العمود الفقري للمنظومة الفكرية للكاتب، حيث يبني عليها جل مقولاته، ويذهب إلى أن المعركة مع المرتدين قد أنجزت على مستوى أصولها الشرعية، وأن الدور الآن لأهل الخبرة والمعرفة العسكرية والقتال والحرب.(23)
مفهوم التربية الجهادية
يرى الكاتب أن عملية التربية هي عملية مزدوجة، فهي من ناحية ترفع مستوى نفسية الإنسان، وهذا لا بد أن يسبقه أو يكون معه رفع المستوى العلمي، سواء بتصحيح الأفكار والمعتقدات أو بتنشيطها وتذكيرها.(24)
والتربية الجهادية هي التي تدخل الشخص إلى الجهاد، وليس التوريط، على حد وصف الكاتب، الذي ضرب أمثلة بقوله "كما حدث عندما ورط الشيخ مروان حديد جماعة الإخوان المسلمين في الجهاد مع سوريا، ومن بعده عدنان عقلة". وعن دور العوام في الجهاد، ينطلق من مسلمة مفادها أن "العوام بفطرتهم الصحيحة هم مادة الجهاد على الدوام".(25)
ويفرق الكاتب بين "القواعد البعيدة" عن القيادة في الإخوان المسلمين، وبين القيادة في موقفها من الجهاد، فتلك القواعد ما تزال تردد شعار "والموت في سبيل الله أسمى أمانينا".(26)
وعن طريقة تجنيد المجاهدين فإنه لا بد أن يكون من خلال الإقناع "عن طريق المجادلة بالحسنى وعرض الأدلة وتكرار ذلك مع اعتماد عامل الزمن حتى يحصل قبول للفكرة والدعوة، ولا بد من وجود الدافع لتحقيق هذه القناعات ...".(27)
ويرفض الكاتب قضية استخدام قواعد التنظيمات البدعية في الجهاد إذا استمرت علاقتهم مع تنظيماتهم، فالمشكلة تكمن في التركيبة العقلية والعلمية للفرد والاقتناع بجهاد المرتدين.(28)
الجهاد والحركات الثورية
وفي حديثه عن الفارق بين الثائر والمجاهد، يقدم قراءته للحركات الثورية، مثل حركة ماوتسي تونغ، والثورة البلشفية، وثورة فيدل كاسترو (29) ويقول عن هذه الحركات "لم يكن لها قواعد وأسس أخلاقية تحكم هذه الحركات،... وهي عندي شبيهة بكتب فن الطبخ ".(30)
وينفي الكاتب وجود ثنائية متعارضة بين الفقيه والحركي، ويرى بأن هذه الثنائية لا تنشأ في عقل المسلم الذي درس وفهم "أكبر حركة انقلابية في التاريخ الإنساني " ولذلك لا حاجة للمسلم إلى استيراد ما هو حرام (الأفكار الثورية) فالسيرة النبوية تغني المسلم عن الدخول في " سبيل المجرمين".(31)
وأن خصوصية الأهداف التي يسعى المسلمون إلى تحقيقها تكمن في تعلقها بعالم الغيب (أي برضى الله تعالى) ومن هنا فإن تقديرات الصراع والمواجهة تختلف مع تقديرات وأهداف الحركات الثورية في العالم.
إقامة الدولة الإسلامية
إقامة الدولة الإسلامية هي لخدمة التوحيد ومن أجله، وما دام الأمر كذلك فإن أي تأجيل أو مساومة لإقامة هذه الدولة غير مقبول خلافا للمتبعين لكتب (سبل المجرمين).(32)
والطريقة المثلى لإقامة دولة الإسلام هي عين الطريقة المثلى لإقامة أي دولة من الدول، فالطريقة الشرعية هي عينها الطريقة الكونية، وهو يعارض من يخالفون السنن الكونية والقدرية بحجة وجود قواعد خاصة بالمسلمين،(33) والسيرة النبوية هي الطريقة الكونية والشرعية الوحيدة لإقامة دولة الإسلام.
ويتطلب إقامة الدولة الإسلامية إعمار الباطن بمثال سابق (قدوة).(34) ويشير هنا إلى صنفين من الناس من حيث موقفهم من سنة إقامة الدولة، الصنف الأول: هم الغنوصيون (الصوفية)، ويرى أنهم ينكرون وجوب الدلائل والمقدمات للوصول إلى النتائج، وهم جبريون، ولا قيمة للسنن عندهم، ولا علاقة لهم بعالم الشهادة، والصنف الثاني: هم الانتقائيون التجزيئيون، ويعيب على هؤلاء استقاء معارفهم الأساسية من الأغيار.
وفي الباب الثاني من الكتاب تناول المؤلف موضوع الاجتهاد في مجتمعات معاصرة وبدأ فصله الأول بمناقشة بعض المفاهيم والمصطلحات، وأول هذه المفاهيم مفهوم السلفية، والتي يرى أنها تتمثل بأمرين، منهج علمي في التعامل مع الأصلين (الكتاب والسنة) ونبذ ما سواهما، وحركة حياة وسلوك في تطبيق هذا المنهج. والسلف هم رجال تعاملوا مع ذلك المنهج العلمي بأسمى حالات الكمال حتى صاروا هم المنهج.(35)
ومن أبرز الإشكالات التي يتعرض لها الكاتب في قضية السلفية "السلفية المزيفة" التي اتخذت السلفية شعاراً، مثل جعلهم السلفية مقرونة بشخص لا تؤمن عليه الفتنة أو جعلها تنظيماً وحزباً وتجمعاً، ومن جعلها علاقة بين أفراد، أو مذهباً فقهياً(36).
وفي مقابل المنهج السلفي يضع الكاتب "منهج السحرة " وهو منهج يقوم على تزييف الحقائق وتمويهها على الناس (37)، ويدخل تحت هذا المنهج الأئمة المضلين سواء كانوا أمراء أم علماء، وضلال الصنف الأول "الأمراء" هو بتركهم دين الله، وبعدم إقامته في الناس، وفساد العلماء هو بالفتوى الجاهلة، والهدي الباطل، والقول الفاسد (38)، وأما علماء الضلال، فهم برأيه الصوفية والآرائيون، أما الصوفية، فيعرفهم بأنهم "فرقة ضالة منحرفة، تلبست بمسوح الإسلام" (39)، ويرى أن أخطر الفرق الصوفية المعاصرة هم الأحباش (أتباع عبد الله الحبشي) لأنهم إلى جانب انحرافهم العقدي، ينفذون سياسة سوريا.(40)
ويرى أن الصوفية تلتقي مع السلفية المزعومة في نقاط منهجية، وهي:
- كلاهما يحرم السياسة على أتباعه ويجعلها رجساً من عمل الشيطان.
- كلاهما لا يتحدث في شؤون الدنيا؛ فالصوفي يهتم بشؤون الغيب والسلفي المزعوم شعاره ودينه محاربة الأموات من أصحاب القبور والبدع.
- كلاهما يترك نقد السلطان.(41)
وأما القسم الثاني من علماء الضلال، فهم أهل الرأي "الآرائيون" وهؤلاء هم "من آثر عقله على نص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاستحسن قولاً أو مذهباً والنص بين يديه على خلافه".(42)
الاجتهاد والتقليد
يذهب الكاتب في قضية الاجتهاد والتقليد إلى أن اختلاف العقول في تفسير شيء عرض عن طريق البيان ليس كتفسيره حين يتمثل أمامهم بصورة عملية واقعية، وهو يعني أن السنة النبوية تمنع الاختلاف في التفسير خلافاً للفكرة النظرية، ويرى أن الإسلام يشدد على العودة دوماً إلى الحقيقة البيانية مع حقيقة التطبيق الأولى (السلف)، ويعتبر أن أي نزول في المثال هو انحراف عن جادة الصواب، فالأحاديث التي تتحدث عن خيرية القرون الأولى هي توجيه للمسلم بمن يجب الاقتداء به.(43)
وعن علاقة السلفية بالتقليد، فإنه يذهب إلى أن الدعوة السلفية في أصلها إحياء للقواعد التي أحيت في الأمة روح البحث، وفجرت في نفوس الأمة عوامل البناء والنظر المبدع، وهي تحطم أغلال الإرادة المعوقة لاستقلال الإنسان في البحث والنظر.(44)
تطوير الخطاب الديني
| تبرز خطورة هذا الكتاب في توجيهه للقوى القتالية السلفية بالتركيز على الحكم بردة الأنظمة والحكومات الإسلامية والشروع المباشر بقتالها خلافا لأفكار الشيخ عبد الله عزام وأنصار جهاد "العدو البعيد" |
فتجديد الخطاب عند الكاتب يستهدف المضمون، ويطلق على أنصار هذا الاتجاه تسمية (العلمانية المائعة)، وقريب منهم "الآرائيون"، ويرى أن هؤلاء جميعاً يخالف خطابهم الفطرة، والطريقة القرآنية، وأن خطابهم لا ينزل إلى مستوى الشعوب،(46) وأنه سيفشل كما فشل خطاب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية.(47)
ويرفض الكاتب أثر البيئة من زمان ومكان في النتائج التي وصل إليها سيد قطب، واعتبارها "وليدة معاناة شخصية أسقطها على كتاب الله" ويرى بأن القصد من هذا القول هو جعل التفسير الصحيح غير ملزم لأحد.(48)
وأما قاعدة "كل مجتهد مصيب" فيرى أن استعمالها جاء رضوخاً لضغط العلمانيين، وأن أصولها تعود إلى التأويلات السابقة لأصول الدين وفروعه، وهي تؤدي إلى القول بجواز تطور الشريعة لتوافق الظروف الجديدة.(49)
مقاصد القتال ووسائله
وعن مقاصد القتال يرى الكاتب أن مقاصد القتال مربوط بالراية التي يقاتل تحتها المقاتل، فالراية تحدد المقصد،(50) والجهاد قد يكون لمقصد واحد من مقاصد الشريعة، وقد يكون مطلقاً لنشر الإسلام وتحكيم الشريعة، أو الدفاع عن العرض، أو المال، أو النفس، والقتال تحت راية كافرة أو بدعية بدعة مكفرة،(51) وهذا هو حال من كان من المسلمين وبقي مع قريش وقتل تحت رايتهم يوم بدر.(52) وهكذا "من يقاتل تحت راية الديمقراطية، فإنه كافر مشرك، لأنه يقاتل من أجل حكم الشعب لا من أجل حكم الله"، وأما عن مقاتلة الاحتلال فإن الكاتب يرى أن "من قاتل الأجنبي، ليحكم الوطني الكافر، فهو يقاتل من أجل راية الوطنية لا من أجل حكم الله."(53)
وفي توضيحه لسبيل أهل السنة والجماعة يرى أن الامتحان والابتلاء هو الذي يعرف الناس حقائق أنفسهم وعقائدهم،(54) وينبه على ضرورة رفض أهل البدع والأهواء، ثم يشيد بما فعله خالد بن عبد الله العسري من قتله للجعد بن درهم بسبب آرائه العقدية ويذكر ثناء بعض العلماء على هذا الفعل.(55)
الجهاد والاجتهاد
ويربط الكاتب بين الجهاد والاجتهاد من حيث كون الجهاد عمل يقوم على الاجتهاد، وغلبة الظن، فيقول: "والاجتهاد كما هو معروف في كتب الأصول لا يفيد إلا الظن ".(56)
ينتقد الكاتب بعض العاملين في الحركات الجهادية الذين أعادوا النظر في موقفهم من حركات الجهاد، ويرى أنهم منافقون لأنهم لا يرون الخير إلا في أنفسهم، ولا يثقون إلا بذواتهم، ولأنهم يتمنون ألا يقع الخير الذي يتمناه غيرهم.(57)
وفي تقييمه العام للجهاد الذي قام به الناس في أفغانستان والبوسنة، يؤكد أن أمره كان مبنياً على الظن والاجتهاد، وأن كل ما وقع كان أمراً لا يؤسف عليه فهذه "هي الحياة التي ينبغي أن يعيشها أهل الإسلام".(58)
دعوى استعجال النصر
وتحت عنوان دعوى استعجال النصر في مواجهة الطواغيت، يرفض هذه الدعوى، ويرى أنها غير مبنية على أسس صحيحة، فسبب انتكاسة الحركات الإسلامية برأيه ليست المواجهة مع "المرتدين" كما أنه يجزم بأن "الطاغوت" لم يستدرج هذه الحركات إلى أي مواجهة.(59)
ويعالج الكاتب الحركات الإسلامية التي اصطدمت مع الدولة ضمن سياقين: السياق السياسي: وهي الحركات التي لم تتبنى الجهاد كحل شرعي وحيد لهدم الطاغوت، كالإخوان المسلمين، وحزب التحرير، وجماعة التبليغ، والدعاة السلفيين المزعومين.
والسياق الثاني: وهي الحركات القتالية التي ذهبت إلى أن القتال هو الحل الوحيد مع "الطاغوت".
نظرية العمالة والتحليل السياسي
يتصدى الكاتب لما يسميه عائقاً جديداً استقر في أذهان الآرائيين منعهم من الفهم عن الله ورسوله، وهذا العائق هو نظرية العمالة والمؤامرة، ويبدأ حديثه بدور "الشيطان" في الانحرافات التي وقعت على مر التاريخ الإسلامي، ويذكر بعض البدع الصوفية، ثم يتحدث الكاتب عن التحليل السياسي والذي من خلاله يتهم المجاهدون بأن أعمالهم تدخل ضمن اللعبة الدولية.(60)
ويضرب الكاتب مثالاً لهذا التحليل السياسي "الإبليسي" بالجهاد الأفغاني الذي جعل الجهاد هناك خدمة لأميركا في صراعها مع الاتحاد السوفياتي، ويرى في هذا التحليل اتهاماً مباشراً للشيخ عبد الله عزام بأنه عميل لأميركا، والعميل كافر، وبالتالي يصبح عبد الله عزام كافراً! بهذه الطريقة يقدم الكاتب نقده للتحليل، فالتحليل السياسي عنده هو تفسير لأي حركة ربانية في هذه الدنيا ضمن مساقات دولية معينة لا دور للإسلام فيها.(61)
أسباب الهزيمة وعوامل النصر
وأما أسباب الهزيمة وعوامل النصر فإن الكاتب يذهب إلى أن الهزائم لا تقع إلا بسبب أعمال يصيبها المسلم فتبعد عنه النصر وتقرب الهزيمة، ... والمعاصي التي لها ارتباط سنني مع الهزيمة هي تلك المعاصي التي ترتبط بالحرب والقتال مثل ترك التدريب، والإعراض عن الجماعة، وعصيان الأمير ... (62).
وعن علاقة التحالفات مع غير المسلمين بالهزيمة، يرى أن من أسباب الهزيمة التحالفات على أسس الوطنية، فالجماعات المسلمة عندما تتحد مع جماعات كافرة على أساس الوطنية فإن النصر لن يتحقق.(63) ومن العناصر الإيجابية التي تساعد في تحقيق النصر العمق الجغرافي، إلا أن هذه النعمة تحولت من سبب للنصر إلى سبب للهزيمة.
القسم الثاني
الدراسة النقدية لكتاب (الجهاد والاجتهاد)
من الواضح أن الكتاب لم يؤلف دفعة واحدة، وإنما هو في الأصل مجموعة من المقالات والردود التي كتبت في فترات مختلفة، فالكتاب في بعض أجزائه أقرب إلى رسائل يكتبها لأناس مخصوصين، وأحياناً تبدو كردود على نقاشات سبق وأن وقعت بين المؤلف وفئة من الناس.(64)
وأحياناً تظهر لغة المنشورات التحريضية التي تشحن الهمم كما في قوله: "نعم يا أهل التوحيد والجهاد، لقد رماكم الناس عن قوس واحدة، وتكالبت عليكم قوى الشرق والغرب، وتبرأ منكم أهل البدعة والفرقة والشقاق، لكنها إرهاصات النصر إن شاء الله".(65)
| تظهر الجوانب النفسية والانفعالية للكاتب واضحة المعالم، كالإحساس بالحزن والغم، والغُربة الفكرية والشعورية، وهذا يزيد من إمكانية تفاعل القارئ الذي يقاسم الكاتب هذه الانفعالات والأحاسيس، ويزيد من فرصة اقتناعه بما يقول الكاتب |
لا يخلو الكاتب من جرأة في طرح القضايا، وهذه الجرأة لم تكن دوماً التماساً للفهم الموضوعي بقدر ما كانت انفعالاً عنيفاً يعكس مؤشرات الضعف والهزيمة التي انتابت المجتمعات الإسلامية منذ أن ظهرت عليها أعراض القابلية للاستعمار.
المصادر الفكرية للكاتب
يشكل ابن تيمية المصدر الأول لفكر المؤلف، وهو يستدل به في كافة مفاصل الكتاب، وهو يعي تماماً أن المخاطبين في جملتهم هم ممن ينطلقون من مرجعية ابن تيمية، ولذلك فإنه يؤكد أن كثيراً من الناس لن يقبلوا كلامه حتى يملأه ويحشوه بكلام ابن تيمية.(66)
ومن المصادر الفكرية الأساسية التي ينطلق منها الكاتب كتاب الرسالة للشافعي،(67) فمعالم هذا الكتاب تبدو بارزة في بعض المصطلحات والعبارات التي يستعملها الكاتب. كما تمثل أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيد قطب مرجعية أساسية في الخطاب الشرعي الصحيح بالنسبة للكاتب.(68) كما يشير في أكثر من موضع إلى الشيخ عبد الله عزام والشيخ عمر عبد الرحمن.(69)
الجهاد
الجهاد هو المنهج الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية وإزالة الكفر بكل أشكاله، وفي تسويغه لمشروعية القتال والقوة يستعمل الكاتب منطق المعاملة بالمثل، فيقول: "لماذا يحق للغرب أن ينشر عقيدته عن طريق القوة والسلاح كما تصنع أميركا وأوروبا ولا يحق لخصومه ذلك؟ ".
إن عقيدة القوة عند المؤلف هي رد على عقيدة قوة أخرى جاءت من الغرب؛ فالقوة والعنف الذي استعمله الغرب ونجح من خلاله بالوصول إلى أهدافه ليس مجرد وسيلة مضمونة النجاح، بل (قانون طبيعي) يجب العمل به "لا يمكن لدولة من الدول أن ترسخ أركانها وتثبت وجودها إلا بعد دماء وأشلاء ".(70) لقد أصبح منطق النكاية والمناكفة منهج حياة وعقيدة دينية، فالذي يغيظ الأعداء هو الحق والصواب .. وهو الذي ينبغي تشريعه وتصويبه.
الانحدار التاريخي
كما هو الحال عند جل أتباع الفكر السلفي فإنهم يرون التاريخ قد بدأ من أنموذج كامل قديم، ثم يبدأ الخلل والنقص يزداد شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن تلك القمة المتفردة، وعلى هذا المنوال نرى المؤلف يتحدث عن "الخط البياني النازل على مدار التاريخ"،(71) ويعتبره سنة كونية، وهذه الأفكار تنطوي على نظرة تشاؤمية وبعيدة عن واقع التاريخ الإنساني، فالعالم قد مر بمراحل من الانحدار ثم تلاها مراحل من الصعود والذي يغلب على واقعنا المعاصر (كبشر) هو الصعود لا النزول .
إن الجهاد قد شرع دفاعاً عن الأنفس والأوطان والأموال وحماية للمستضعفين والمظلومين، ونشراً للعدالة وتوفير الحرية الدينية ليختار الناس الدين بمحض إرادتهم، فالجهاد يحد من سفك الدماء ويمنع انتشار الفساد وهلاك النسل وخراب العمران، قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [الحج: 39].
الجهاد والسياسة الشرعية
يذهب الكاتب إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم- كان "يحاول جاهداً أن يحيد قريشا في صراعه مع الشرك في الجزيرة العربية، ويستدل برواية البخاري "أن قريشاً أنهكتهم الحرب وأخذت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويُخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا في ما دخل فيه الناس فعلوا ... " (72).
ويلاحظ أن الحديث حجة على من يجعل الجهاد غاية بذاته، ومبدأ وعقيدة تتجاوز التوازنات السياسية والعسكرية، فلو كانت علَّة القتال هي الكفر، كما يقول الكاتب "هذا هو دين الله تعالى، فعلّة القتال فيه عدم إيمان المشركين بالله".(73) لما كان لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يقبل بصلح الحديبية مع قريش وهو قادر على تحقيق النصر عليهم بالجهاد.
فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يستغل ضعف قريش، بل اتخذ أسلوباً آخر في الصراع، فخرج معتمراً إلى مكة ولم يأتهم مقاتلاً، ويفسر الكاتب ذلك بقوله: "وسبب هذا الأمر هو أن النبي – صلى الله عليه وسلم - أراد أن يحرج قريشاً أمام العرب، حتى يفقدها شرعيتها في حماية البيت الحرام".(74) وهذا الكلام يناقض ما ذهب إليه الكاتب من اعتبار الجهاد كمبدأ وعقيدة لا مجال فيها للمساومة أو المهادنة، فهذه اللغة "إحراج العدو" ومراعاة موقف العرب ليست منسجمة مع المنهج العقدي للمؤلف، وهذا يظهر تبايناً منهجياً في البنية الفكرية للمؤلف.
الفقيه والسياسي
| يرفض الكاتب التفريق بين السياسي والفقيه، ويرى أن هذه الثنائية لا مكان لها في الإسلام، وهذا كلام غير دقيق، فقد كان من الفقهاء من اختص بفقه السياسية الشرعية أكثر من غيره من أبواب الفقه |
جهاد الاحتلال
مما يلاحظه القارئ لهذا الكتاب، أن الكاتب رغم حديثه المستمر عن الجهاد، إلا أنه لم يتحدث عن الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين، ولم يذكر تجربة حركة حماس أو الجهاد الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يترك أمام القارئ فراغات واستفسارات تنتظر الإجابة عنها.
إشكالية تكفير المسلم
يخالف الكاتب في تكفيره لبعض طوائف المسلمين جل مواقف علماء المسلمين، ومن تلك المواقف ما قاله الإمام الأشعري قبيل وفاته: "أشهِد عليَّ أني لا أُكفِّر أحداً من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.(75)
ويقول الذهبي بعد ذكره مقولة الأشعري السابقة: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أُكفِّر أحداً من الأمة (76).
يوسع الكاتب دائرة التكفير لتشمل من لم يتبعه في تكفير الحكام، ومن كان ظاهر عمله يشير إلى ولاية الكفار، كما أن كلام ابن الوزير الذي نقله الكاتب يناقض التكفير بالفعل المخالف للشرع دون الاعتقاد "وعلى هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفراً إلا مع اعتقاد".(77)
يقرن الكاتب التكفير بالقتال، فمن يحكم عليه بالكفر يصبح هدفاً للقتال وهذا الاقتران ليس صحيحا؛ً فالفرق كبير بين (الكافر الحربي) والكافر غير الحربي، فالقرآن يحث المؤمنين على برّ غير المقاتل من الكفار والقسط معه، ويعتبر ذلك من الإحسان: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [الممتحنة، آية 8].
مفهوم الصراع
يؤكد الكاتب على أن كل مبدأ وشخص خارج دائرة الإسلام محارب لهذا الدين، وأنه منذ مبعث النبي – صلى الله عليه وسلم – والقضاء على هذا الدين هاجس الشيطان وجنده(78).
وهذه النزعة الصراعية الجذرية التي يشير إليها الكاتب هي أقرب إلى الديانة المثنوية منها إلى الديانة التوحيدية، فالشيطان ليس ندا للإله، وليست له قدرة الإله، ولا يخرج عن مشيئة الله سبحانه، والإنسان ليس شريرا بطبعه، وليس خصما مطلقا لله ، وإنما الأصل فيه الخير والإيمان وليس الكفر والعصيان.
الصراع العقدي
يذهب الكاتب إلى أن الصراع يجب أن يكون عقدياً حتى يؤتي أكله، فلا الاحتلال ولا العدوان هو الدافع للصراع والجهاد وإنما العقيدة.
واعتقاد كفر وشرك العدو هو سنة من سنن النصر، وهو الذي يعطي القوة والصمود للمقاتل، والقارئ لكتاب الله يرى أن القتال ليس بالضرورة للكفر، بل نجد القرآن يأمر المسلمين بالإصلاح بين المتقاتلين المؤمنين، وإن بغت إحداهما على الأخرى، فلا بد من إيقافها: "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ " [ الحجرات، آية 9].
نقد التصوف
يرى الكاتب أن الصوفية فرقة ضالة منحرفة مشركة تلبست بمسوح الإسلام، ويرفض تقسيم الصوفية، ويزعم أن الصوفية أنفسهم يرفضون هذا التقسيم.(79)
ويذهب إلى أن أول أشكال فساد التصور العقدي يتمثل في انتشار "جرثومة الصوفية " على حد تعبيره، فالصوفية شغلت الناس في الوصول إلى حالة العرفان، وجعلته يسعى لخيالات جنونية، وعطلت المسلم عن البحث والنظر والسعي لاكتشاف سنن الكون والحياة، فأفسدت بذلك النظر إلى الكون والحياة.
وبالرغم من محاولة الكاتب المستمرة للتأكيد على انسجام رؤيته الفكرية مع موقف ابن تيمية، إلا أن موقف شيخ الإسلام من التصوف وأصله يخالف ما يذهب إليه الكاتب، ففي الفتاوى يقول ابن تيمية : "تنازع الناس في الصوفية، فطائفة ذمتهم وقالت عنهم مبتدعة، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله".
وأما تقسيم الصوفية الذي ينفيه الكاتب ويزعم أن سببه "عدم دراستهم المتعمقة للصوفية" فإن ابن تيمية يذهب إلى تقسيم الصوفية إلى ثلاثة أصناف "صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم" (80).
والمؤسف في الأمر أن الكاتب يتجاوز أبسط حقائق التاريخ، فهو لا يذكر ولا بكلمة واحدة المجاهدين الكبار من أهل التصوف الذين قارعوا الاحتلال ولم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء، أمثال عمر المختار، والمهدي الكبير، وعبد القادر الجزائري، وهذا التغييب لحركات الجهاد الصوفية ينم عن غياب الموضوعية وتغليب النظرة الإيديولوجية المسبقة.
نقد علم الكلام
| مما يلاحظه القارئ لهذا الكتاب، أن الكاتب رغم حديثه المستمر عن الجهاد، إلا أنه لم يتحدث عن الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في فلسطين، ولم يذكر تجربة حركة حماس أو الجهاد الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يترك أمام القارئ فراغات واستفسارات تنتظر الإجابة عنها |
نقد الشيعة
يرفض الكاتب أي حديث عن التقريب بين السنة والشيعة، باسم الإبقاء على الثوابت ويرى في هذا الطرح تجريداً للإسلام عن حقائقه (83).
ولا يخفي الكاتب عداءه المطلق للشيعة وللثورة الإيرانية، وهو يعود إلى نفس الصيغ الإقصائية والتكفيرية للشيعة الإثني عشرية،(84) ولا يخفي الدور الكبير الذي لعبته بعض الدول في دعم هذه النظرة التكفيرية للشيعة الإثني عشرية عقب اندلاع الثورة الإيرانية خشية امتداد تأثير هذه الثورة إليها، مما يجعل مسؤولية هذا الفكر التكفيري تقع في جزء منها على تلك الدول.
مشكلة النقد الذاتي
يرفض الكاتب أي حديث عن إيقاف الجهاد والقتال بسبب الأخطاء التي وقعت، "إننا نقول لهؤلاء القوم الذين يعطلون عظائم الأمور ويوقفونها لمجرد بعض الأمور الصغيرة ".(85) فهل يعتبر الكاتب مقتل أكثر من مائة ألف جزائري في الحرب الأهلية التي قطعت فيها الرؤوس وتناثرت الأشلاء بين السلفية الجهادية والسلطة الجزائرية "أمورا صغيرة " لا تستدعي إعادة النظر في شيء؟.
خاتمة
يلحظ القارئ لكتاب "الجهاد والاجتهاد" وجود كثير من الثغرات الناتجة عن التداخلات الفقهية والفكرية والسياسية الكبيرة التي تحيط بموضوع الجهاد وأحكامه في الإسلام، وعلاقة الجهاد بموضوع الكفر والردة، وتطور فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة، والصراع المذهبي بين طوائف المسلمين، والبناء الحرفي الظاهري للعقل النصي، وعدم التفريق بين النص وقراءة النص.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الفكر ما كان له أن يظهر وينتشر لولا ما تعانيه البلدان العربية والإسلامية من غياب للديمقراطية وقمع للحريات وضعف للمؤسسات الدينية الرسمية، فضلا عن الشعور الهائل بالقهر والاضطهاد الناتجين عن استمرار العدوان على الأمة الإسلامية وتواصل مسلسل الإجرام الصهيوني، والانحياز الغربي المطلق لإسرائيل.
_______________
عامر الحافي، أستاذ الأديان المقارنة في جامعة آل البيت في الأردن، وهو مهتم بدراسة الحركات والفرق الدينية، وقضايا الحوار الحضاري، وله عدة أبحاث ودراسات منشورة أهمها: أثر ابن رشد في اللاهوت المسيحي، أثر التلمود في المجتمع الإسرائيلي، العرب في مناهج التعليم الإسرائيلية. 
المصادر والهوامش
- عمر بن محمود، الجهاد والاجتهاد، تأملات في المنهج، دار البيارق، عمان ، ط1 ،1999 ،ص5
ص11 - ص11
- ص 131
- الجهاد والاجتهاد، ص 15
- الجهاد والاجتهاد، ص27
- الجهاد والاجتهاد، ص 31
- الجهاد والاجتهاد، ص 32
- الجهاد والاجتهاد، ص 35
- الجهاد والاجتهاد، ص60
- الجهاد والاجتهاد، ص62
- في الكتاب " فسيصبح دور هؤلاء القدماء هو البحث عن الأدلة في تمرير قول المتقدمين" وهذا القول لا يستقيم فهمه، فلعل الأصوب أن يقول اللاحقين.
- الجهاد والاجتهاد، ص 79
- الجهاد والاجتهاد، ص 71
- الجهاد والاجتهاد، ص 75
- ص 133
- ص 133
- ص 143
- ص 143
- ص 144
- ص 154
- ص 155
- ص 178
- ص 187
- ص 188
- ص 188
- ص 190
- ص 191
- ص 192
- ص 193
- ص 194
- ص 197
- ص 198
- ص 200
- ص 213
- ص 214
- ص 214
- ص215، 216
- ص 216
- ص 217
- ص 221
- ص 225
- ص 247
- ص 253
- ص 256
- ص 258
- ص 259
- ص 264
- ص 271
- ص 289
- ص 290
- ص 291
- ص 292
- ص293
- ص294
- ص 307
- ص 307، 308
- ص 309
- ص 320
- ص 322
- ص 323
- ص 332
- ص 334
- انظر قوله: "أما إسقاط الكلام السابق على أحد من إخوتنا ...الخ " ص201.
- ص 301.
- ص 199
- ص 215
- ص 234، 235
- ص 185
- ص 87
- ص 247
- ص 177
- ص 180
- ص 177
- ابن عساكر، تبين كذب المفتري، ص148، 149
- الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج15، ص88
- الجهاد والاجتهاد، ص 52
- ص 183، 184
- ص 217
- ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج11، ص 18
- ص 203
- يكفي هنا أن نعود إلى دراسة أ. د. عبد الفتاح غنيمة والمعنونة بـ " العلم والترجمة في عهد الخليفة المأمون "
- ص 296
- ص 300