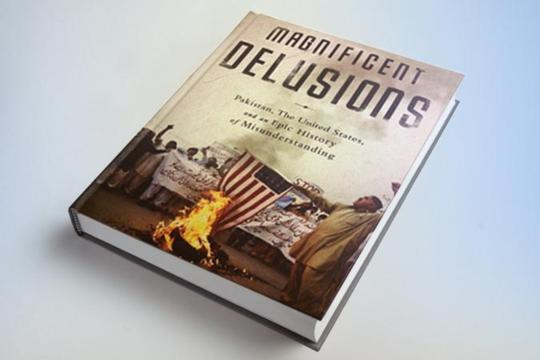
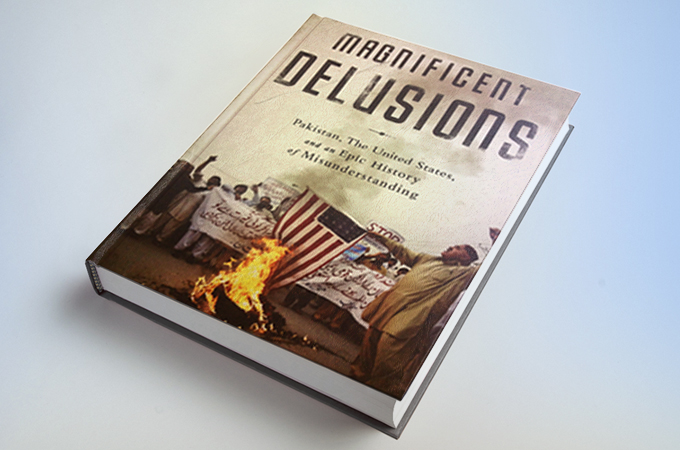 |
| (الجزيرة) |
قلما احتفت الصحافة العالمية ومراكز الدراسات بكتاب لكاتب باكستاني بمثل ما استقبلت به كتاب "الأوهام المهيبة" من تأليف الدبلوماسي والأكاديمي الباكستاني حسين حقاني؛ ولذلك قصة مهمة سردها تفيد قارئ الكتاب الواقع في حوالي 400 صفحة.
أصر الرئيس آصف علي زرداري عام 2008 على تعيين حسين حقاني كسفير له في أميركا وهو الذي عمل مع زوجته ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، وكان من المقربين لها، واعترضت المخابرات العسكرية الباكستانية "ISI" النافذة في البلاد على التعيين دون جدوى حيث مضى زرداري في قراره، لكن السفير حقاني الذي وُصف بالسفير المتمرد ظل تحت مراقبة مخابرات بلاده المعترضة على تعيينه.
وحانت لحظة الانتقام المخابراتي منه عندما نشرت الصحف الأميركية مذكرة كتبها بأمر من الرئيس زرداري إلى البنتاغون الأميركي يطلب فيها دعمًا أميركيًا لوقف انقلاب عسكري باكستاني ضد الحكومة المدنية عام 2011 في أعقاب عملية الكوماندوز الأميركية التي أدت لقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أبيت أباد القريبة من إسلام أباد. وكلفه ذلك استدعاء للمركز وبقاءه تحت الإقامة الجبرية بمبنى الرئاسة ورئاسة الوزراء لأسابيع قبل أن يُسمح له بالمغادرة بعد أن قدم استقالته من منصبه، ونعتته المحكمة بالخائن.
ويبدو أن المخابرات العسكرية رصدت مبكرًا تمرد حقاني على قواعد سياسية غير مكتوبة لكنها تحكم المشهد السياسي الباكتساني حين كتب كتابه عام 2005 "باكستان بين العسكر والمسجد" ورصد فيه استخدام العسكر للإسلاميين والجهاديين من أجل ترقية أجنداتهم الخاصة بهم.
تأتي أهمية الكتاب والكاتب من أنه مزج في أسلوبه بين الأكاديمي الجاد الرصين لخلفيته الأكاديمية حيث يُدرس في جامعة بوسطن الأميركية وبين الأسلوب السياسي نظرًا لخبرته السياسية، وأن الكاتب تقلب بين أهم ثلاثة أحزاب باكستانية على مدى حياته السياسية، بدأها ناشطًا في صفوف الجماعة الإسلامية حين كان طالبًا في جامعة كراتشي، لينتقل بعدها إلى حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف ويعمل معه كمساعد شخصي في رئاسة الوزراء، لينتهي به المطاف في حزب الشعب الباكستاني بزعامة بي نظير بوتو التي عينته كسفير لها في سري لانكا. وبالتالي فهو يقدم في كتابه خبرة سياسية عملية مشفوعة بخبرة أكاديمية عزز ذلك ربما أرشيف السفارة الباكستانية في واشنطن الذي كان خير معين له على رصد هذه العلاقة الشائكة بين دولتين يُنظر إليهما على أنهما حليفتان ولكنهما أعداء في الحقيقة والواقع.
ورغم أن قانون الخدمة العامة الباكستاني يحظر على أي مسؤول كتابة كتاب أو مذكراته قبل مرور سنتين على تخليه عن منصبه إلا أن حقاني لم يلتزم بذلك، وتهمس الأوساط الرسمية في الخارجية بأنه خرق تقليدًا دبلوماسيًا، وخاض في أمور تهم الأمن القومي الباكستاني ما كان له أن يخوض فيها.
يقول الكاتب: إن ما ميّز علاقات باكستان مع أميركا على مدى هذه العقود هو الاعتماد والخديعة والتحدي وأن أكثر من أربعين مليار دولار تلقتها باكستان مساعدات وذهبت فيما يوصف بالثقب الأسود بحسب تعبير ساسة أميركيين، وقوبل هذا الدعم بعدم إيفاء باكستان بوعود قطعتها على نفسها مقابل هذه المساعدات؛ فنقاط الافتراق أكثر من الاتفاق في العلاقات الثنائية، وهنا يسرد لقاءه مع السفير الأميركي إلى باكستان جيمس لانجلي الذي أبلغه أنها أضغاث أحلام أن نعتقد أن القوة العسكرية التي تبنيها باكستان ستكون لمكافحة الشيوعية أو "الإرهاب"؛ فكثير من الأميركيين يعتقدون أن باكستان التي احتضنت أسامة بن لادن لتسع سنوات تعد عدوًا وليست حليفًا.
بالتأكيد فإن قارئ الكتاب سيخرج بانطباع واضح وجلي أن الكاتب ليس صديقًا لبلده فهو يتهم سياسييها بالكذب والنفاق والازدواجية بالتعامل مع أميركا ويُحملهم المسؤولية أكثر مما يحمّل أميركا عن كل إخفاقات ماضي وحاضر العلاقات، ساعيًا إلى تبرير مقاربته هذه بالقول: "لقد سعيت إلى تخطي مرارة الماضي من أجل وضع أساس شراكة استراتيجية بعيدة المدى غير أن مراكز القوى في بلدي قاومت بكل قوة رؤيتي لعلاقات ثنائية تبادلية أوسع وأعمق".
الكتاب يقع في مقدمة وسبعة فصول غطت سبعة وستين عامًا من العلاقات الشائكة بين الطرفين. حرص حقاني على تصدير الكتاب بمقولة للحكيم اليوناني يثوب فابليس: "الصديق الشكاك أسوأ من العدو المتيقن، دع الشخص يكون الشيء أو نقيضه، حينها فقط نعرف كيف نتعامل معه".
في المقدمة يقرر الكاتب أن واشنطن اتخذت إسلام أباد حليفًا في ثلاث مراحل: الأولى: في مرحلة الحرب الباردة، والثانية: في الحرب الساخنة، والثالثة: في الحرب على" الإرهاب". وفي المراحل الثلاث كانت واشنطن تنظر إليها كحليف لأسبابها التي تتباين مع الأسباب التي قبلت بها باكستان هذا الدور؛ حيث كانت تعمل على توظيف هذا التحالف من أجل مواجهة الهند التي تنظر إليها كعدو تقليدي ومهدد استراتيجي لها. غير أن حقاني يؤكد أن على باكستان أن تتفادى التنافس مع الهند، ويعزو تقدم الأخيرة وتراجع بلاده إلى أن الهند عملت على تعزيز الديمقراطية والتعددية بخلاف باكستان، مع حرصها على تبني سياسة خارجية غير منحازة وضع أسسها نهرو بالتزام الحيادية في الصراعات الدولية بخلاف باكستان.
من قواعد للتجسس على الشيوعية إلى قواعد لضرب "الإرهاب"
بعد استقلال باكستان عام 1947 وتسلم الأميركيين ملف المنطقة من البريطانيين عملوا بنقيض النصيحة البريطانية حين دعموا باكستان ولم يلزموا الحياد في التعامل مع المتنافسين متعللين بأن الهند رفضت الدخول معهم في أحلاف ضد الشيوعية بخلاف باكستان.
سعى القادة الباكستانيون الجدد إلى تسويق أنفسهم لدى أميركا من خلال أهمية موقعهم الجيوستراتيجي، القريب من الغريمين السوفيتي والصيني بالإضافة إلى قرب باكستان من الخليج العربي وإمدادات الطاقة ولعبها كدولة مصد في مواجهة الشيوعية الطامحة للوصول إلى المياه الدافئة، ومستشهدين دائمًا بعبارة مؤسس باكستان "محمد علي جناح" من أن أميركا بحاجة إلى باكستان أكثر من حاجة الأخيرة لها".
أما واشنطن فكانت تنظر إلى الأهمية الباكستانية على كونها قاعدة متقدمة من أجل القاذفات الأميركية في أي حرب محتملة مع الاتحاد السوفيتي، ويستذكر الكاتب أن مهمات سفراء باكستان إلى واشنطن من السفير الأول أصفهاني ومرورًا بالسفير الثاني محمد علي بوكر وغيرهم كانت تتركز على الترويج لأهمية بلادهم في مكافحة الشيوعية وهو ما تطور في الستينيات إلى أن تكون قاعدة سرية لطائرات التجسس الأميركية في بدابيرا قرب بيشاور من خلال نشر طائرات يو تو التي سبّبت أزمة دبلوماسية بين أميركا وروسيا حيث أسقطت الأخيرة الطائرة وهي في عملية تجسس عليها.
لقد رأى الباكستانيون في جرّ أميركا إلى بلادهم وربط مصالحها بهم نجاحًا لهم بإبعادها عن العدو الهند وتحقيق مكاسب مادية وعسكرية، وأن ذلك سيوفر لهم مظلة دفاع أمنية وعسكرية، لكن الغاية والهدف الأميركي كان أولاً وأخيرًا ضد السوفيت غير أن ذلك لم يمنع القادة الباكستانيين من تخصيص بعض هذه المساعدات لحربهم مع الهند.
فباكستان الوليدة مسكونة بعقدة الأمن منذ ظهورها ولذا حرص قادتها منذ لياقت علي خان عام 1950 إلى كسب ضمانات أمنية أميركية بسبب الخطر السوفيتي والهندي على غرار المظلات الأمنية الأميركية لإسرائيل وتايوان وكوريا الجنوبية ومصر.
ويعقد الكاتب مقارنته بين عرض مبكر لواشنطن من أجل استئجار أو منحهم قواعد عسكرية للتجسس على الاتحاد السوفيتي وهو ما حصل بمنحهم قاعدة بدابيرا البيشاورية في الستينيات وبين منحهم قواعد جوية للحرب على "الإرهاب" في عام 2000 أيام حكم الرئيس الجنرال برفيز مشرف واستمر حتى في ظل الحكومات المدنية.
وهنا تظهر حالة الشيزوفرينيا السياسية الباكستانية؛ فبينما الواقع يتحدث عن سماحها للأميركيين باستخدام أراضيها وبموافقتها لطائرات بلا طيار التي تقصف بشكل يومي في مناطق القبائل ويقدم الأميركيون أدلتهم على ذلك نرى الساسة في باكستان يدينون ويشجبون الغارات.
ويعيدنا الكاتب إلى فهم هذه العلاقة من خلال مخاطبة الرئيس الباكستاني وأول قائد انقلاب عسكري، أيوب خان، لواشنطن ولقائه مع المسؤولين الأميركيين وقوله لهم: "بحق المسيح لم آت إلى هنا لأشاهد مناظر الثكنات العسكرية، جيشنا يمكن أن يكون جيشكم، لكن دعونا نصنع القرار"، وربما هذا ما شجّع وزير خارجية أميركا لاحقًا للقول: إننا بحاجة إلى قوة مشاة قتالية على غرار "الكركا" التي قاتلت إلى جانب البريطانيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، لكن يصحح له حقاني بأن الكركا كانوا من الهندوس ولم يكونوا من المسلمين.
يلحظ المؤلف بأن العلاقة بين باكستان وأميركا كانت علاقة ببعد واحد تقريبًا وهو البعد العسكري ومحصورة بين البنتاغون وراولبندي العاصمة العسكرية بعيدًا عن السياسة والشعب.
باكستان الدولة والوظيفة
نسج القادة الباكستانيون في البداية علاقات شخصية مع القادة الأميركيين حتى إن السفير الأميركي في كراتشي هيلدريث زوّج ابنته إلى همايون إسكندر ميرزا نجل الرئيس الباكستاني إسكندر ميرزا، وكذلك نسج أيوب خان علاقات مميزة مع جون كيندي ومن بعده. وفي زيارة إلى باكستان قام بها الرئيس ريتشارد نيكسون مع مستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر يستذكر الكاتب وصفه للهنود بأنهم أولاد شوارع ونعت كيسنجر لرئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي بابنة كلب ردًا على تدخلاتها في باكستان الشرقية "بنغلاديش" بالطريقة التي لم تكن واشنطن ترتضيها كما تردد؛ حيث ينقل الكاتب شهادات عدة كيف أن واشنطن منعت كلاً من روسيا والهند من التقدم أبعد من بنغلاديش للحفاظ على باكستان الحالية.
لم يكن أمام أميركا إلا الانحياز إلى يحيى خان في الصراع ببنغلاديش؛ برر ذلك كيسنجر بأن عكس ذلك يعني إغلاق نافذتنا الوحيدة إلى الصين من خلاله وهو ما اتفق معه نيكسون.
ولما كانت باكستان تقوم بوظيفة مقاومة الشيوعية من خلال الدخول في أحلاف منطقية، فقد لعبت الدور الأهم أيضًا في انفتاح الصين على أميركا وانفتاح الأخيرة على الصين، وشكّلت زيارة كيسنجر إلى الصين عبر بوابة باكستان وعلى متن طائرة باكستانية باكورة الانفتاح بين البلدين.
استفادت واشنطن من خبرة باكستان في فهم الصين؛ إذ امتدح القادة الأميركيون نظراءهم الباكستانيين وتحديدًا يحيى خان الذي جرى في زمنه التقارب الأميركي-الصيني؛ فكتب هاليداي رئيس موظفي البيت الأبيض أيام نيكسون يصف يحيى خان: "إنه شخص ذكي وقائد حقيقي يدرك بواطن العلاقات الروسية-الصينية، ويمكن أن يكون نافذة مهمة للعلاقة مع الصين".
ظل الخارج يخدم الداخل في باكستان، وبشكل عام فإن السياسة الخارجية هي من تحدد السياسة الداخلية في باكستان، فمع الانقلاب الشيوعي في عام 1978 بأفغانستان تجددت أهمية باكستان بالنسبة لواشنطن، وتعززت مخاوف الأميركيين والغرب بشكل عام من تنامي وتمدد الشيوعية إلى المنطقة عبر إثارة البشتون والبلوش في باكستان والوصول إلى المياه الدافئة ترافقًا مع طرح بريجنيف فكرة الاتحاد الآسيوي وهو ما يستلزم القدرة على التحكم في إمدادات النفط شريان حياة أميركا والغرب، وهو ما ثبت لاحقًا بالغزو السوفيتي لأفغانستان، لتعود أهمية باكستان مجددًا بالمنظور الغربي بعد رحيل السوفيت وصعود خطر القاعدة وطالبان.
القنبلة النووية الباكستانية
في مقابلته مع الغارديان عام 1965 دشّن وزير خارجية باكستان ذو الفقار علي بوتو إطلاق مشروع القنبلة النووية الباكستانية بقوله: "سنأكل العشب من أجل صنع القنبلة النووية إن أقدمت الهند على اختبارها". حينها لم يصدقه أحد كونها تصريحات يدرجها البعض في عالمنا ضمن الاستهلاك المحلي والخطابات العاطفية، ولكن ما إن فجرت الهند قنبلتها عام 1974 حتى كان أول مؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي ينعقد في لاهور، وسعى بوتو إلى حشد الدعم الخليجي تحديدًا لصالحه سيما وأن الطفرة النفطية كانت في ذروتها فكسب الدعم السعودي والليبي من أجل إقامة مشروع نووي باكستاني. سبق ذلك كتابة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان المهندس في مشروع نووي هولندي إلى بوتو يستعد فيها لتأسيس المشروع النووي الباكستاني، لم يتردد بوتو ويحيى خان في قبول العرض وهُرِع عبدالقدير خان إلى باكستان مع مخطط المشروع النووي الهولندي الذي تمكن من تهريبه معه. وبدأت قصة القنبلة النووية الباكستانية، والتي كانت إحدى قواعد الأمن القومي الباكستاني، وجاء الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979 نعمة على باكستان؛ فكانت الشراكة في دعم المجاهدين الأفغان، وبينما كان الهدف الأميركي وقف التقدم الشيوعي، كان الهدف الباكستاني متعددًا بوقف الشيوعيين عن الوصول إلى بلوشستان ومناطق البشتون، والحصول على مظلة أمنية أميركية في مواجهة الهند وروسيا، ودعم أميركي مالي يمكن استخدامه للمشروع النووي الباكستاني بالإضافة إلى صمت وغض طرف أميركي عن المشروع مما يعني بناءه بعيدًا عن الضغوط الأميركية والدولية والصخب.
كان على الرئيس الأميركي أن يشهد سنويًا أمام الكونغرس بأن باكستان لا تقوم بتطوير مشروع نووي عسكري، غير أن المسؤولين في واشنطن وبداخلهم يدركون تخطي باكستان للخطوط الحمر ولكن ليس أمامهم من خيار وإلا فسيفقدون حليفًا مهمًا في حرب مع العدو الشيوعي الذي يهدد مصالحهم على مستوى العالم.
إذن تشاطر الأميركيون والباكستانيون هدف إطالة أمد الحرب الأفغانية فواشنطن تريدها من أجل إدماء السوفيت انتقامًا لفيتنام وباكستان تريدها من أجل ابتزاز أفغاني لواشنطن ليكتمل مشروعها النووي، ولذلك كانت نصيحة ضياء الحق الثمينة لمدير مخابراته العسكرية الجنرال أختر عبد الرحمن: "دع الماء يغلي تدريجيًا في أفغانستان لكن ليس إلى درجة عالية جدًا".
وأدرك بعض المسؤولين في واشنطن النوايا الباكستانية كمثل وزير الخارجية جورج شولتز؛ حيث نُقل عنه أن ضياء الحق لو خُيّر بين علاقاتنا وبين القنبلة النووية سيختار الثانية.
وحين التقى السفير الأميركي في إسلام أباد آرثر هيومل ضياء الحق عارضًا عليه صور الأقمار الاصطناعية عن تطور مفاعل كاهوتا قرب إسلام أباد نفاها ضياء، وقال له: إن معلوماتكم مغلوطة، وعرض عليه مع خبراء أميركيين زيارة أي مكان في باكستان، لكن بعد اللقاء وحين طلب رسميًا الزيارة رفض طلبه بحجة أن الهند لا تسمح بزيارة منشآتها النووية.
وبمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو/تموز 1982 أرسل ريغان أهم مساعديه، وهو نائب مدير السي آي إيه الجنرال فيرنون والترز الذي يتقن سبع لغات وكان مترجمًا للرئيس فورد، ليلتقي ضياء الحق ودوّن بعد اللقاء: "إما أن ضياء الحق لا يعرف شيئًا أو أنه وطني كذاب بامتياز لم أقابل مثله قط". وشرح والترز لضياء أن لديهم معلومات لا يمكن دحضها عن خرق باكستان لتعهداتها بعدم الحصول على القنبلة النووية والمعدات الصينية لهذا الغرض. سعى ضياء الحق إلى نفي ذلك والتأكيد على أنه كمسلم وباكستاني وجنرال يؤكد له أن ذلك غير دقيق وأنه يريد المصادر التي استقت أميركا منها هذه المعلومات، لكن ضياء أراد في الحقيقة معرفة مصادر معلومات واشنطن وطرق استنتاجها لهذه المعلومات حتى يتم تفاديها في المستقبل، وحين التقى والترز بعد عامين ضياء الحق فوجئ بأن القطة خرجت من الكيس كما يقولون وأن الباكستانيين امتلكوا القنبلة، ليتم تفجيرها لاحقًا في عام 1998 على يد رئيس الوزراء نواز شريف الذي اختير منذ البداية من قبل ضياء الحق كوزير لمالية حكومة البنجاب أيام حكمه ليصعد نجمه لاحقًا منعوتًا من قبل خصومه بأنه بقايا ضياء.
السي آي إيه الأميركية والـ آي إس آي الباكستانية
يبدأ المؤلف قصة العلاقة بين السي آي إيه والمخابرات العسكرية الباكستانية آي إس آي برسالة أميركية تحذيرية لرئيس الوزراء نواز شريف في عام 1994 حين كان المؤلف مساعدًا خاصًا لشريف، تقول الرسالة: إن لدى الأميركيين معلومات مؤكدة عن دعم المخابرات العسكرية الباكستانية لجماعات "إرهابية" كشميرية وبالتالي فإن الأميركيين قد يضعون باكستان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبحسب حقاني فإن شريف لم يأخذ الرسالة بجدية، فقام بشرح أبعادها مع وكيل الخارجية الباكستانية ولكن ظلت المخابرات العسكرية تقلل من أهمية الرسالة حيث يُنقل عن مديرها آنذاك الجنرال جاويد ناصر بأننا تعاملنا مع السي آي إيه خلال الجهاد الأفغاني وهم بحاجة لنا ونحن نعرف كيف نتعامل معهم، نقطّر المعلومات شيئًا فشيئًا لنبقيهم مسرورين. وهنا يقاطع شريف الجالسين بالقول: عليكم أن تتكلموا معهم بشكل جميل واعملوا ما تشاؤون بعدها، وبعقلية رجل الأعمال يطرح شريف تخصيص ميزانية من مليونين دولار من أجل الوصول إلى الإعلام والكونغرس الأميركيين لتبديد مخاوفهم.
يغوص المؤلف في العلاقات التاريخية بين الجهازين وهي من أهم المفاتيح لفهم العلاقات بين البلدين وتساعد أكثر على فهم أعمق لشؤون المنطقة وربما العالم كون الجهازان تعاملا مع بعضهما بأخطر قضيتين مسّتا العالم خلال العقود الماضية: الغزو السوفيتي لأفغانستان والحرب على القاعدة وطالبان.
ويستعرض استراتيجية الجيش الباكستاني أيام ضياء الحق ثم خلفه أسلم بيغ ومدير مخابراته العسكرية حميد غول برغبتهم التمدد إلى أفغانستان ضمن استراتيجية ما عُرفت بـ"العمق الاستراتيجي" ثم إلى وسط آسيا، ويعتقد المؤلف أن حميد غول نجح في خديعة الأميركيين كونه مخلصًا وذا شخصية قوية تمكنت من توحيد فصائل أفغانية يصعب توحيدها، وأنه وسيط قوي ليكتشف الأميركيون لاحقًا أنه لا يحقق مصالحهم وأن نظرتهم له كانت خاطئة؛ وهو ما اعترف به نائب وزير الخارجية الأميركية ريتشارد أرميتاج عام 1991 بأن الإدارة الأميركية ارتكبت خطأ بتقديم الدعم الكبير للمخابرات العسكرية حيث ذهبت بعيدًا في دعمها وفشلت في فهمها بشكل صحيح حيث إنها تلعب دورا استقلاليا كبيرا.
ومع انتخابات 1990 الباكستانية كان التدخل العسكري أكثر وضوحًا في السياسة حيث اعترف لاحقًا أسلم بيغ ومدير مخابراته الجنرال أسلم دوراني أمام المحكمة العليا بأنهما دعما التحالف الجمهوري الإسلامي ضد بي نظير بوتو بسرقة انتصارها الانتخابي خدمة للمصلحة القومية الباكستانية.
لكن رغم كل الدور الذي لعبه الجهاز في هزيمة الاتحاد السوفيتي بدعم الأفغان ومساعدة الأميركيين ينقل المؤلف ملاحظة ذكية من نائب وزير الخارجي الأميركية ستروب تالبوت بأن الهند كانت أكثر تأقلمًا مع انهيار الشيوعية من باكستان حين تخلت عن الاشتراكية وفتحت أسواقها لتكون أكثر مواءمة مع المتغيرات الجديدة.
وبعد تدهور العلاقة بين الجهازين بسبب اتهامات أميركية لباكستان بدعمها للجماعات المسلحة الكشميرية سعت رئيسة الوزراء آنذاك بي نظير بوتو عام 1993 إلى تسليم رمزي يوسف المتهم بمحاولة تفجير برج التجارة العالمي بغية إصلاح العلاقة مع واشنطن وهو ما أكسبها ثناء ومدحًا أميركيين.
عادت العلاقة مجددًا بين الجهازين بعد ظهور حركة طالبان، وتقوّت أكثر بعد اختيار باكستان الفسطاط الأميركي على الطالباني القاعدي متخلية عن حليفها الذي طالما وصفته بالعمق الاستراتيجي بوجه الهند، ولكن مع هذا فالأميركيون مقتنعون أنهم والباكستانيين في عالمين متوازيين ومختلفين.
يشيد الكاتب بالمبعوث الأميركي إلى أفغانستان وباكستان الراحل ريتشارد هولبروك الذي فشل في تطبيق حل لأفغانستان؛ فقد كان لديه -كما يرى المؤلف الذي التقاه غير مرة- رؤية لحل منطقوي شامل ويستشهد الكاتب بأحاديثه التي تكررت معه من أن مشروعه أُحبط من قبل المخابرات العسكرية ولكن كثيرًا من الباحثين الأميركيين يرى أن مشروعه أُحبط من دوائر عسكرية ومخابراتية أميركية؛ حيث حُرم حتى من لقاء واحد منفصل مع الرئيس أوباما. ويقول حقاني: إن هولبروك كانت لديه رؤية شاملة تنموية للمنطقة وتحديدًا باكستان وأفغانستان، وأن العلاقة مع باكستان ينبغي أن تكون متعددة وشاملة وليست عسكرية فقط، وهو ما أغضب الجيش والعسكر في باكستان حين علموا أن الدعم الأميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة البالغ 7.5 بليون دولار سيذهب في معظمه لأغراض غير عسكرية.
معلومات الكتاب
العنوان: الأوهام المهيبة - The Magnificent Delusions
pakistan the united states and ethic history misunderstanding
المؤلف: حسين حقاني
عرض: د. أحمد موفق زيدان - مدير مكتب الجزيرة في باكستان، باحث متخصص في الشؤون الباكستانية
الناشر: Public affairs - New York
تاريخ النشر: 2013
عدد الصفحات: 413
_______________________________________________
د. أحمد موفق زيدان - مدير مكتب الجزيرة في باكستان، باحث متخصص في الشؤون الباكستانية